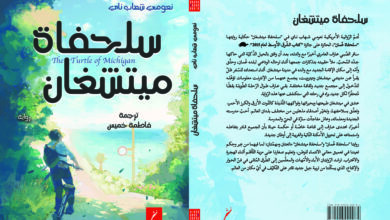تحقيق مخطوطة «بغية الفلاحين في الأشجار المثمرة والرياحين»

حاتم الطحاوي
حفل التراث العربي الإسلامي بالعديد من المخطوطات التي تناولت ما أنتجه المسلمون على المستوى النظري في علوم الفلاحة والزراعة. بعضها تم تحقيقه والبعض الآخر ما زال على قائمة الانتظار. وهي المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق هذا المخطوط المهم للملك الأفضل العباسي علي داود الرسولي (ت 778هـ / 1377م)، بعدما اضطلع بهذه المهمة الشاقة الزميل خالد الوهيبي من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان. والحاصل أن المحقق قام بجهد علمي كبير حتى خرج المخطوط على هيئة سفر ضخم يتكون من جزءين (أكثر من 1000صفحة) مملوءة بالتعليقات والحواشي التي تفوق المتن ذاته.
يذكرنا الوهيبي منذ البداية في مستهل دراسته بأن حجر الأساس للمعرفة العلمية الإسلامية بالزراعة وأصولها هو الإرث الحضاري الذي وجد في الأمصار الزراعية المفتوحة، فضلاً عن النشاط العلمي الذي تم عبر ترجمات عدة لكتب النبات والفلاحة اليونانية التي تم نقلها إلى اللغات السريانية والبهلوية قبل ظهور الإسلام. وخلال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي تمت ترجمة العديد من تلك الكتب إلى اللغة العربية. وفي القرن التالي، ظهر كتاب ابن وحشية «الفلاحة النبطية» الذي حوى خبرات عن الزراعة الرومية في بلاد الشام وكذا التجربة الزراعية للمجتمع النهري لبلاد الرافدين.
ويذكر المحقق أن تلك المصادر المترجمة كانت بمثابة حجر الأساس للمعرفة الإسلامية النظرية حول الزراعة لقرون عديدة. كما أن انتقال المعرفة الزراعية الى الأندلس منحها أبعاداً جديدة، بخاصة عند وجود علماء في قامة ابن بصال (ق5هـ/11م) الذي مزج بين المعرفة النظرية والتجربة العملية والجمع بين علمي الفلاحة والنبات.
وتلقف سلاطين بني رسول في اليمن الإنتاج الزراعي النظري الذي ظهر في بلاد الأندلس وانتقل إلى الشرق الإسلامي ق8هـ / 14م، بخاصة بعد تشجيعهم لعمليات الزراعة، وقبل ذلك اقتناء الكتب الخاصة بها، فضلاً عن إنشاء الحدائق والبساتين الملكية مع تشجيع السكان على الزراعة بعد تخفيض الضرائب عليها. وكذا جلب بذوراً جديدة من البلدان الإسلامية في آسيا وأفريقيا.
ويوجز الوهيبي رأيه بالقول إن «الثقافة الواسعة والاهتمام بالمعرفة لدى ملوك بني رسول، والبيئة العلمية الغنية باليمن في عصرهم خلقت فرصاً مناسبة ساعدت على تأليفهم العديد من الكتب في مختلف جوانب المعرفة التي كان من بينها التأليف في علم الزراعة». وعلى حين يرصد المحقق المؤلفات العربية حول علم الفلاحة والزراعة، فإنه يلاحظ ندرة المشاركة الرسمية من خلال السلاطين والخلفاء في هذا الاتجاه، الأمر الذي جعله يحتفي بمؤلفات ملكية نادرة في الفلاحة من قبل ثلاثة من ملوك الأسرة الرسولية باليمن. أولهم الملك الأشرف ممهد الدين عمر بن علي بن رسول (ت 694هـ /1296م) ومؤلفه «ملح الملاحة في معرفة الملاحة». والثاني هو الملك المجاهد علي بن داود بن يوسف بن عمر (ت 764هـ / 1362م) وكتابه «الإشارة في العمارة». والثالث هو ابنه ومؤلف هذا المخطوط الملك الأفضل العباس(ت 778 هـ/1376 م).
لم يفت الوهيبي أن يشير في أمانة علمية إلى الدراسات السابقة حول هذا المخطوط ومؤلفه. منها دراسات ماكس ميرهوف، وروبرت سيرجنت، ودانيال فارسكو، ويحي العنسي وعبد الواحد الخامري، مبيناً مجهود كل منهم في إظهار التراث الفلاحي المكتوب للملك الأفضل.
غير أنه عاد ليؤكد أنه لا أحد من السابقين عكف على تحقيق المخطوط في شكل كامل، وأنه استطاع توفير نسخ المخطوط من مكتبات القاهرة وإسطنبول و لندن من أجل إنجاز عمله. ثم عاد ليؤكد بأن هذا المخطوط هو أكبر وأضخم عمل تمت كتابته حول موضوع الزراعة في شبه الجزيرة العربية في العصر الإسلامي الوسيط، بعدما استطاع مؤلفه الجمع بين معارف كتب الزراعة السابق ترجمتها، والتي غلب عليها الطابع النظري، مع ما أنتجه ابن بصال من خبرات علمية، إضافة إلى التراث العلمي الذي خلفه سابقوه من الملوك الرسوليين.
ويذكر المحقق أن مشروعه العلمي هذا استغرق منه سنوات سبع من أجل سبر أغوار التراث الفلاحي الإسلامي، وكذا الإنتاج الفكري في اليمن، فضلاً عن صعوبة فهم العديد من كلمات المخطوط ومصطلحاته ذات الخصوصية اليمنية. كما شرع بعد ذلك في تقسيم مشروع دراسة وتحقيق مخطوط «بغية الفلاحين» إلى أربعة أقسام، تعلق الأول منها بحياة المؤلف وحكمه وانتاجه العلمي والثقافي. وخصص القسم الثاني لدراسة ومقارنة ونقد النسخ الموجودة من المخطوط، بينما تناول القسم الثالث محتويات فصول الكتاب وموضوعات مادته العلمية والمصادر التي اعتمد عليها. بينما حوى القسم الرابع والأخير النص المحقق ذاته.
وعلى أي حال، فقد تألف كتاب «بغية الفلاحين في الأشجار المثمرة و الرياحين» من ستة عشر باباً تتعلق جميعها بأمور الزراعة وأحوالها. فقد خصص الملك الأفضل الرسولي الباب الأول في الكتاب للحديث عن الأراضي الزراعية ومدى جودتها وخصوبتها، فتحدث عن الأرض الغليظة والمالحة والجبلية والرملية والسوداء. وحمل الباب الثاني عنوان «في ما يدمن به الأرضون»، وعني بتبيان أنواع الأسمدة التي يجب استخدامها لأجل تخصيب الأرض الزراعية، ومنها زبل الخيول والبغال والأغنام وكذا مخلفات الإنسان. واختص الباب الثالث بالإشارة إلى المياه وكيفية معرفة أماكن وجودها. وعني الفصل الرابع بالحديث عن كيفية اختيار الأرض وإصلاحها والصفات المطلوبة في الفلاحين و الرعاة . وتناول الباب الخامس أوقات الفلاحة والاختلافات في أوقات الزراعة في اليمن ومصر والشام، بينما عالج الفصل السادس أنواع المحاصيل والزراعات كالبر والشعير والذرة والأرز.
وخص المؤلف الباب السابع بالحديث عن القطاني، كالحمص والعدس واللوبيا وغيرهما. وجاء الباب الثامن عن البقول والخضروات كالبطيخ بأنواعه والقثاء والقرع والباذنجان والجزر واللفت. بينما تحدث في الفصل التاسع عن البذور المتخذة لإصلاح الأطعمة مثل الكزبرة والكمون وغيرهما. وتناول الباب العاشر الحديث عن الرياحين وما شاكلها والبنفسج والفل والنيلوفر والنرجس والياسمين. واختص الباب الحادي عشر، وهو أكبر أبواب الكتاب، بالحديث عن الأشجار المثمرة كالنخيل والأعناب والتين والرمان والتفاح وغيرها. ثم عالج المؤلف في الفصل الثاني عشر من كتابه عملية تشمير الأشجار وإصلاحها بعد هرمها معتمداً على ما كتبه ابن بصال سابقاً. وتناول الفصل الثالث عشر مسألة تركيب الأشجار بعضها في بعض، وما يتركب منها مع الأخبار عن الأقاليم السبعة. وجاء عنوان الباب الرابع عشر في الخواص ويتناول أعراض النباتات وصفاتها وكيفية معالجتها. وتناول الباب الخامس عشر كيفية دفع الآفات عن النباتات والمزروعات، منها على سبيل المثال كيفية مواجهة خطر هجمات الجراد. وفي النهاية احتوى الفصل السادس عشر والأخير على خاتمة تحمل الكثير من النصائح في أمور الفلاحة والزراعة.
وختم الوهيبي كتابه المحقق بمجموعة كبيرة من الملاحق التي كان لابد منها للقارئ العربي حتى يخرج بأقصى استفادة من قراءة تحقيق مخطوط «بغية الفلاحين في الأشجار المثمرة والرياحين»، فصنع بنفسه ملحقاً عن المنازل والبروج، وآخر عن أسماء الشهور: السريانية والحميرية والأندلسية والفارسية فضلاً عن ثبت بأسماء ملوك الأسرة الرسولية في اليمن (626هـ – 1249م/ 858هـ – 1454م).
(الحياة)