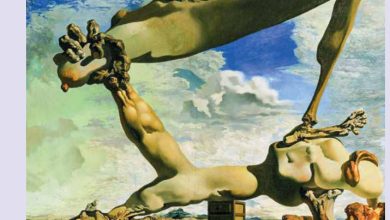محمد حيّاوي.. في روايتة “خان الشّابندر” ليس بالسرد وحده يتجسد النص الروائي
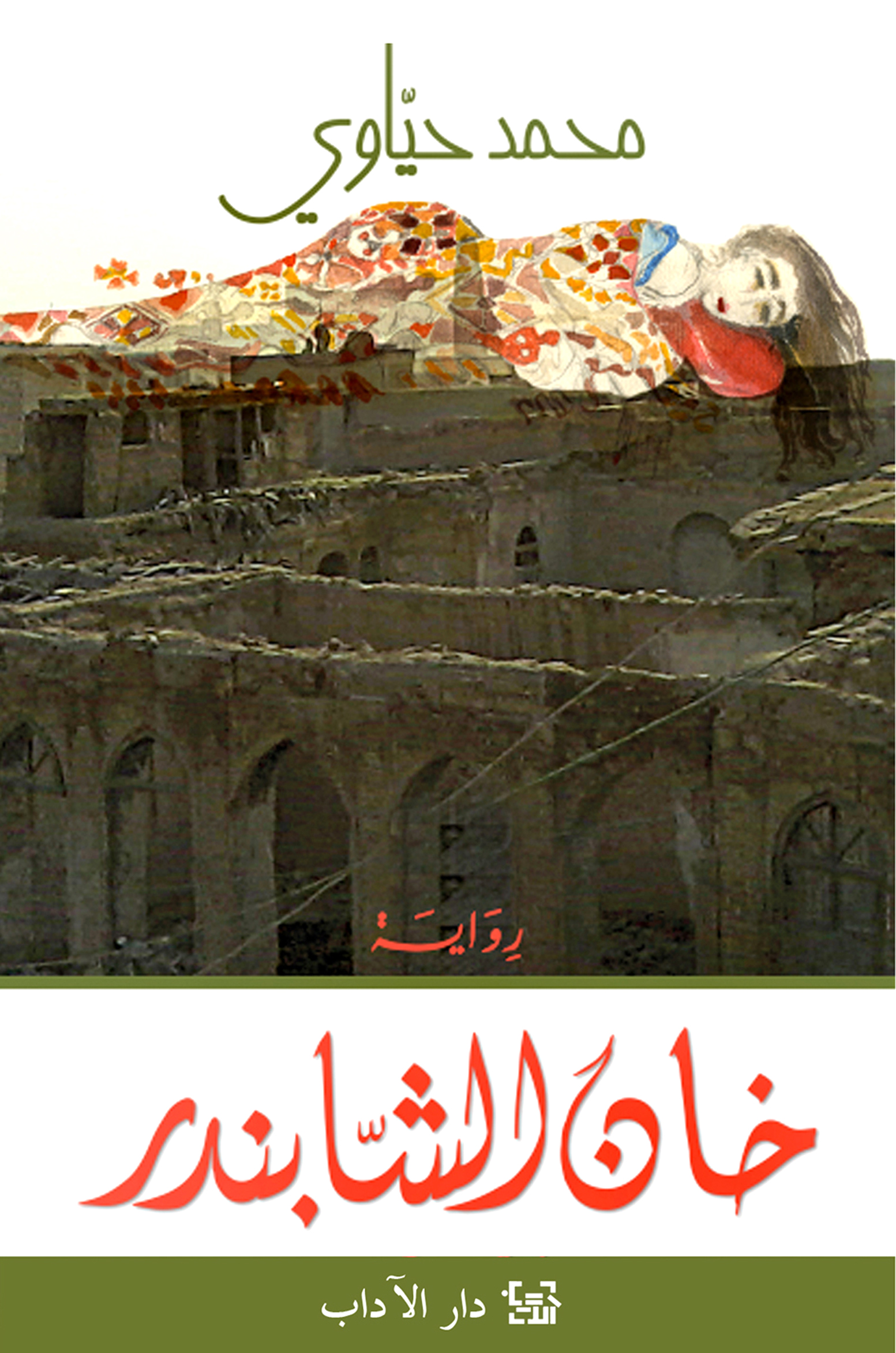
خاص- الجسرة
العنف العراقي من سرديات الدولة، التي تنتج، بواسطة مؤسساتها الأخطبوطية، التمويه باختلاف تنويعاته المجتمعية والاقتصادية والفكرية وتعيد تدويره. وهي التي نمّتْ هذا المصل التربوي في طفولتنا وجعلته يترعرع معنا ليتشكل ظاهرة مختلّة سوف تستغلها الدولة ضدنا لاحقًا في حروبها وتشوهاتها الإعلامية، ليعم التلوث بجميع انواعه السامّة.
مقداد مسعود *
(وأنا أحاول تجميع خيوط القِصّة المتشابكة/ 89) ألتقط هذه الوحدة السردية الصغرى من فم علي موحان، السارد المشارك في صياغة الحدث الروائي، أقلّب ما بين القوسين مثل عالم آثار عَثرَ على حجر كريم نادر، ثم استعمله مصباحًا يدويًّا، وأقصدُ ما تراكم من تيه/ تمويه في خان الشّابندر شوقًا إلى الفضة في رواية محمد حيّاوي.
مكوّن الساردَين …نكاية بكل تنويعاته، ونكاية بترسيمه (رسمت بعض الطيور أقواسها في سماء المدينة المُبقعّة بنقاط التفتيش ومدرّعات الهمر الهجينة المتدثرة بالأتربة ../ ص 91) هذا المكوّن: أباده مكون السارد الأكبر الجهم الغليظ بنوعيه المفخخ الإرهابي والملعلع بالرصاص الوطني!! وكلاهما: المتاهة/ التمويه.. والخاسر الأوحد هو: الخائبة ونسلها من البنات والبنين.. والعنف العراقي بعيدا عن تنظيرات: بيار بورديو ـ أنتويني فاوسنيو ـ أرفنج زايتلن ـ أيان كريب ـ خليل أحمد خليل ـ بوعلي ياسين.. وغيرهم. ومع تقديري الشخصي والمعرفي لجميع هذه الاطروحات الجادّة، أقول أنّ العنف العراقي من سرديات الدولة، فالدولة هي المنتج والمخرج والسيناريست، وكل ما يجري في العراق سببه الدولة، منذ تأسيسها المدبلج ببساطيلها إلى ما بعد الآن: استبداد الدولة ورخاوتها وتواطؤها وتعاملها مع مفهوم المواطنة ـ إعلاموجيا ـ واستغلال الخلايا الميّتة في التاريخ وتنشيط الأمراض الاجتماعية والخنوع لدول الجوار. الدولة بمؤسساتها الأخطبوطية هي التي تنتج التمويه باختلاف تنويعاته المجتمعية والاقتصادية والفكرية وتعيد تدويره، فهي التي نمّتْ هذا المصل التربوي في طفولتنا وجعلته يترعرع معنا ليتشكل ظاهرة مختلّة سوف تستغلها الدولة ضدنا لاحقًا في حروبها وتشوهاتها الإعلامية بواسطة الفضائيات، ليعم التلوث بكل تنويعاته السامّة.
تشتغل رواية “خان الشّابندر” بمهارة على تعدّد الساردين: السارد المشارك في صياغة الحدث الرئيس ـ الصحفي علي موحان، وهو الرابط التفاعلي مع بقية الأصوات السردية: صوت ضويَّة ـ صوت هند ـ صوت إخلاص ـ صوت نيفين ـ صوت مجر عمارة ـ صوت زينب، وهناك سرد غرفة ضويَّة وغرفة هند وسرد الصور العائدة لهند وسرد الطيور المحلّقة في بغداد وسرد المتاهات المتعدّدة المؤدية إلى بيت أم صبيح.
الحكاية الرئيسة يديرها المؤلف الضمني وبواسطته/ بواسطتها، تنبث للقارئ الحكايات الفرعية:
حكاية الجندي سالم محمد حسين، المعدوم/ الحيّ المتخفي حتَّى بعد سقوط الطاغية، ثم حكاية نيفين التي فضلّت البقاء في بغداد على السفر إلى أستراليا، وحكاية الصّبيَّة زينب التي تبيع الكعك في الشوارع لتطعم اخوتها، وحكاية حسنين المصري الذي أرتبط مصيره عراقيًا، وأخيرًا حكاية أمّ غايب التي تعيل وتربي اليتامى واللقطاء، كما لدينا حكي ملجوم عنونه السرد وأكتفت زينب بالإشارة إليه. ومنه حكاية مقتل والد زينب أثناء انتفاضة 1991، والمحذوف هنا: الفساد الإداري الذي صادر حقوق عائلة الشهيد بعد سقوط الطاغية. وحكاية كنو أبو الطيور، ثم حكاية بدور، وحكاية البيت المسكون.
ليس بالسرد وحده يتجسد النص الروائي. ثمة ما يتجاور مع السرد، وسأجترح له مفهومًا من قراءتي وأعلن براءة اختراعي لهذا المفهوم وهو (خلاصة السرد).. (استعدت أحداث اليوم الغريبة، وتراءت لي زينب وهي تضحك ضحكتها الطفولية.. تذكّرت أبو حسنين وحكايته الغريبة، وتلك المرأة العجوز صاحبة المدفأة النفطية، والتعرف إلى مجر عمارة بشخصيته العجيبة. كانت تلك الأحداث تمرُّ أمامي مثل شريط سينمائي ظل يكّرر نفسه طول الليل../ ص 85) هذا الوجيز السردي استلمته قراءتي بالتفصيل قبل ص85 .
سرد المستقبل، يومض بين السرود وهذا السرد يأتي ملتبسًا مثل الغبش كما هو في السردية الصغرى المنبجسة من الذاكرة التذكرية/ التذكارية لهند وهي تحدّث علي موحان عن العجوز مجر عمارة.. (إنه عتيق جدًّا، عمره أكثر من مائة عام، منذ وطأت قدماي منزل أمّ صبيح وهو يجوب الأرجاء ويعرف مفاتيح الأمور.. أسمع عنه الكثير من الحكايا الغريبة، لكنّه طيّب القلب، وفي أغلب الأحيان يبدو مثل ملاك حارس../ ص 129) كل هذا النظام المعلوماتي لا يستفز أفق انتظار قراءتي.. وهذه المسردة، تنضد كفعلٍ ماض.. لكن الكلام التالي هو الذي يستفز القارئ العادي.. (حتّى إنّه حمى الرؤوس من القطط والطيور الجارحة مدّة طويلة قبل أن ترفعها أم غايب.. / ص 129) من هذه المسردة التي اقتطعتها من التي قبلها، ينبجس سؤالي التالي: هل لَبَدَ المؤلف الضمني في صوت هند ورشقنا بهذا الفعل الاستباقي؟ فالذي بينه وما سوف يجري مسافة بسعة (42) صفحة من الرواية التي تنتهي مع نهاية الصفحة 172..؟
اللامرئي والغرائبي يندس في المرئي والمألوف، لنبدأ بالطائر (خبط طائر ما كبير الحجم على ما يبدو بأجنحته فوق رؤوسنا، فتطلع الرجل إلى الأعلى وهو يبتسم.. ثم عاد للتطلّع إلي مبتسمًا بحقّ هذه المرة لدرجة شاهدت معها أسنانه الصفر/ ص 82)، هذه الوحدة السردية من ملفوظات علي موحان حين يقوده العجوز مجر إلى بيت أم صبيح التي تسكن فيه هند.. وحين يوصله إليها يقول مجر لعلي موحان: (هذا هو البيت.. تفضل بالدخول. إن احتجتني تجدني فوق/82 ص) هنا شفرة ملغّزة!! كيف يكون فوق؟! هل هو ذلك الطائر ضمن منطق التناسخ؟! وحين يومىء لذلك مجر (وأشار بيده إلى الأعلى) سيقول القارئ قولة علي موحان (لم أفهم ما يقصده)..هنا عليّ أن أزيل الحجب التي تغشى إنسانيتي وأرفع المصدات الداخلية/ الخارجية في نفسي وهكذا يغمرني إيمانٌ شفيف (إن أي شيء يظهر أمامنا ليس سوى وجه آخر لنا، واحتمالاً مختلفًا لوجودنا../ ص 98- معجزات زن).. ويصادفنا الطائر ثانية بعد الانفجار في المقبرة وعلي موحان مع زينب وأخوتها.. (سمعتُ خفق أجنحة كبيرة لطائر ما حلّق فجأة في فضاء المقبرة، كان كبيرا جدًّا، عرفت ذلك من قوّة الخفق الآفل في سماء المدينة المحترقة../ ص 162).. في الأسطر لا نرى الطائر، بل حمامة بصيغة تشبيه خاص.. (قلبي يخفق بشّدة مثل حمامة محبوسة وسط أضلاعي المضطربة/ ص 172).. لا تريد قراءتي في الحقيقة تفكيك هذه الشفرات اللذيذة.. بل تدعو القارئ الفطن للبحث في أفق انتظاره عن مفلاته الخاصة ومفاتيحه.

* الصوت: الصوت يسمعه علي موحان ولكن لا يرى المتكلم.. وهو يهم بمغادرة غرفة سالم محمد حسين، ذلك الجندي المتواري يسمع صوتًا: (ثمّة ماء في الخزان.. اغتسل وامض.. لا تتأخر/ ص 49) وحين يلتفت علي لا يرى أحدًا (لم أتبيّن من أين أتى الصوت.. تلفّتُ في أرجاء الباحة لكنّني لم أر أحدًا.. كان صوتًا رجاليًا واثقًا).
* وفجأة سمعت امرأة تضحك خلفنا فالتفت ْ لكنّني لم أجد أحدًا/ ص 81
* “علي..علي..” انبثق الصوت فجأة بأذني آتيًا من مكان ما في المقبرة، وخطف طيف امرأة متلفعة بالعباءة من بين القبور، تبعت المرأة بخطى مُتعثّرة.. “- علي..علي..” جاء الصوت من الجهة المقابلة هذه المرة، أو هكذا خيّل إلّي../ ص 161.. “علي.. علي..” عاد الصوت المُنادي من جديد، لكنّه أبعد هذه المرّة! كان نظري غائمًا والتراب تحت جفوني يحرقني بشدة، وعبثًا حاولت تمييز قامة المرأة التي انبثقت فجأة أمامي. تراجعتْ ببطء، كما لو أنّها فوجئت بي، حتى اختفت خلف قبر صغير مبنيّ من الطابوق الرخيص وثمة ورود ذابلة وأغصان آس متيبّسة تُغطي الصورة الصغيرة خلف المشبّك الحديديّ الصدئ. مددت يدي الراجفة ببطء وأزحت أغصان الآس والورود الذابلة، وهالني منظر الشعر المُجعد والنقرتان الصغيرتان على جانبي الفم الصغير المبتسم../ ص 162).
وهناك سرد جغرافيا الخراب/ المتاهة.. بغداد الهامش المهمل المحذوف المهدد بالإبادة النسوية
وسردها بنسق ثلاثي على لسان المؤلف الضمني. يبدأ في ص9 (اجتزنا أوّل الأمر أزقّة ضيقة تملأها الأزبال وأنقاض البيوت المُهدمة.. ثم سرعان ما صرنا نخترق خرائب آيلة للسقوط وبقايا بيوت بغدادية هدّها الزمان فاتكأت على بعضها بعضا في مشهد مرعب.. وسرعان ما حجبت عنّا تلك الهياكل نور الشمس. وبين الفينة والأخرى، يُطالعنا رجل ما أو امرأة تحمل قِدرًا.. يخرجون فجأة من الزوايا المظلمة ويدخلون في فتحات أو أبواب غير مرئية، كما لو كانوا أشباحًا! انتابني الشك أوّل الأمر، وتزايدت مخاوفي من تلك الأمكنة..) هذه الصورة السردية المشعرنة تجعلنا في مدينة لا مرئية من مدن إيتالو كالفينو.. لكن هذه مدينة عراقية منتبذة في أقاصي المدينة ـ العاصمة العراقية بغداد وسكّان هذه المدينة كلّهم من ضحايا المجتمع وهم الآن في حكم التهديد المسلّح الجماعي.. (المنطقة عرضة لمداهمة الميلشيات المُتشددة في أيّة لحظة بحثًا عن بيوت الدعارة لإقامة الحد على ساكنيها ومرتاديها على حدّ سواء../ ص 77).
في المدخل الثاني سيكون السارد المشارك وحده، وسيدور في متاهة ويتلبسه اليأس ويخشى مساءلة من يصادفهم في المكان وهنا سينقذه العجوز مجر عمارة (مررنا بأزقةٍ لم أشاهدها من قبل، وممرّات مظلمة تنحشر بين البيوت المهجورة التي تندلق نوافذها عن ظلمة مخيفة.. وكنت أتحاشى النظر إلى أجواف تلك البيوت../ ص 82).. وحين يوصله مجر إلى “بيت أم صبيح” الذي هو ليس بيتا بالمعنى المتعارف عليه، بل هو محض مأوى أقرب ما يكون إلى خربة، وهو مكان بشرط التهديد بالقتل.. ولا أحد يجيبه حين ينادي على أم صبيح وبشهادته (وبدا البيت كئيبًا تملأه الأزبال وغرفه مقفلة، وأدوات المطبخ التي كانت في الزاوية مبعثرة وقد جفّت عليها بقايا الطعام../ ص 83) وبسبب تزايد مخاوفه من الوحشة، سيغادر مسرعًا وما يلي ذلك أشبه بما يجري في مسرح البانتومايم.. (فخرجت مسرعًا إلى الزقاق وهالني منظر مجموعة من النسوة يتلفعّن العباءات السود ويمضين سريعًا، فتبعتهن.. علهن يرشدنني إلى الطريق! لكنهن يسرنّ بسرعة غريبة وسرعان ما بدأنّ يتناقصنّ. بعد أن أخذنّ يدخلنّ في الفتحات الجانبية المظلمة، الواحدة تلو الأخرى..). إن كانت هذه الشفرة مغلقة فهي شفيفة في الوقت نفسه، ولها وظيفة فعل استباقي لما سوف يواجهه.
أما المدخل الثالث فيتجسد بإخلاص التي يصادفها في شارع المتنبي، وحين يصلان سيقدم السارد منظورا آخر لمدخله (مررنا في زقاق ضيق جدًّا/ 94).
أنهيت قراءة الرواية بجلسة واحدة، فهي تمتلك كل أسباب التشويق وفيها الكثير من رشاقة الأسلوب. والإيحاءات العميقة حين تُسقط الذكورة المنحرفة المرأة العراقية أخلاقيًا.. ثم تسقطها اجتماعيًا في جريمة ليست عشوائية على الإطلاق بشهادة العم مجر: (الانهيار الكبير؟.. إنّه يحدث يوميّا/ ص 172) أما قتل النسوة العراقيات، فهو مستمر (حدث ذلك منذ زمن.. لا أدري.. عشر سنين ربّما؟ ..ما الفرق؟) فهي الهدف الاستراتيجي الدائم.
حكاية الرواية تتقاطع مع عنوانها الذكوري (خان الشّابندر).. فالمتن الروائي منشغل بقضية نسوية محض ويحاول صحفي عائد بعد غيبة ربع قرن أنّ يتناول قضية النساء المسقطات وهو محق، فقد اجتاح العراق وباء فاتك بالمترجمات والسافرات والمسلمات وغير المسلمات.
العنف كالعملة له وجه وقفا: الوجه يتأطر بتسمية ظاهرة اجتماعية، وقفا العملة يؤكد أن العنف مكتسب ثقافي (إذ انه لا يظهر إلا لدى الإنسان ابتداء من اللحظة التي تتخطى الطبيعة ذاتها إلى ثقافته، فالثقافة التي يعيش في كنفها الأفراد تحمل الكثير من صفات العنف../ 112- أسماء جميل) وهذا الكلام ينطبق على مجتمعنا العراقي الذي كرسته الحكومات المتعاقبة للحروب وقمع الانتفاضات، كما كرسته الأحزاب: اصطراعًا/ احترابًا فيما بينها والعنف الذي يجريه الحزب الحاكم على كوادره بواسطة اغتيال من يختلف في اطروحاته مع الطاغية وفي مجزرة قاعة الخلد 1979.
الإنسان العراقي في متناول القتل والتجهيل الجماعي، حين كانت السيادة الميليشياوية للمدعو “ملا جليل” كانت أمّ صبيح تدفع له (ضريبة الفرج).. ومع تصفية هذه المليشيا من قبل ميليشيا مضادة، سيتم تصفية بيت أمّ صبيح كطابور خامس تابع للملا جليل!
المناصة في الصفحتين السابعة والثامنة: هي الخلية الموقوتة في رواية “خان الشّابندر” ذات التمكن السردي والتحكم المهيمن، والكلام مبثوث من هند إلى الصحفي علي موحان، يشمل القارئ النوعي المعوّل عليه، وبدونه (فإن النص الأدبي لن يعمل عمله/ 189- تيري أيغلتون).. والنص الروائي سينقذ هذا القارئ من الغرق والتحطم في الحياة الفاسدة: بشهادة هند وهي تخاطب علي موحان، وستكون شخصيات الرواية وبتوقيت الفوانيس التي يوقدها حسنين المصري، هي الملائكة التي تحرس القارئ وبغداد وأرواح شهيدات وشهداء العراق في (الليالي الحالكة) بشهادة هند، وبعد الانتهاء من قراءة الرواية سيكون القارئ متماهيًا مع علي موحان وما تقوله هند له تقوله أيضًا للقارئ (لن تعود إلى طبيعتك السابقة على الإطلاق، تهيأ لاحتراق روحك في كانون محبّتنا الموجعة.. فبعد تلك الساعة، لن تعود كما كنت ولن تعود الحياة كما عرفت../ ص 8) وبشهادة العجوز الحكيم مجر عمارة: (خُلقت أرواحهم من بعضها بعضًا، كما توقد الشموع واحدة من الأخرى../ ص 128).. وكذلك الحال مع فوانيس حسنين المصري التي يضيئها (الواحد من الآخر حتى يفيض النور في الأزقة كلّها../ ص 66)، والاشتعال استعارة واستدلال على التماسك الاجتماعي العراقي بين أولاد وبنات الخائبة تحديدًا، وهنا لا نختلف مع (لويس كوزر) وهو ينقّب عن الجوانب الإيجابية للعنف وما يمكن أن يؤديه من (وظائف للجماعة كالتضامن الداخلي للأعضاء والتكيف للتطورات الخارجية وأتلاف الجماعات المتأثرة بالصراع…/ ص 79 – أسماء جميل – العنف الاجتماعي).
* ناقد عراقي
(1) محمّد حيّاوي / خان الشّابندر/ دار الآداب / بيروت/ ط1/ 2015
(2) مقداد مسعود/ هدوء الفضة/ دار ضفاف/ بغداد – دولة الأمارات العربية المتحدة / 2014
(3) مقداد مسعود/ بساطيل عراقية / دار ضفاف / 2016
(4) د. بريندا شوشانا/ معجزات زن/ ترجمة سلام خير بك/ دار الحوار/ سورية – اللاذقية/ ط1/ 2012
(5) أسماء جميل/ العنف الاجتماعي/ دار الشؤون الثقافية العامة/ بغداد/ ط1/ 2007
(6) تيري أيغلتون/ كيف نقرأ الأدب/ ترجمة د. محمد درويش/ الدار العربية للعلوم ناشرون/ ط1/ 2013