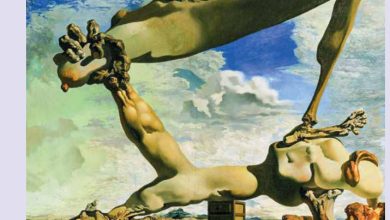مفهوم الحضارة في الثقافة العربية – أنس ناصيف

الجسرة – خاص
ينطوي مفهوم “الحضارة” على بُعدٍ اشكاليّ لا يمكن اغفاله، يتمثل من جهة أولى في تعالقه مع مجموعة مفاهيم أخرى غير مستقرة دلالياً، مثل مفاهيم التاريخ، الإنسان، التقدم، الرّقي، الثقافة، التمدن، المدنيّة، الهمجية، التخلف، الاستقرار والترف، والتي تحوز بدورها على صفة الإشكال. ومن جهةٍ ثانية إن المضامين التي تقوم عليها حضارة معينة تدخل في آلية تكوين وتوليد الخلفية الدلالية للمصطلح، وذلك من خلال تضمين التعريف للعوامل التي شكلّت تاريخياً هذه الحضارة أو تلك، أو بعبارة أخرى جعلت منها حضارة.
ولمّا كان من الضروري لأي تعريف ل “الحضارة” أن ينطوي بشكلٍ مباشر أو غير مباشر على مجموعة المفاهيم أعلاه أو على بعضٍ منها، وكانت هذه المفاهيم ذات طبيعة قلقة ومتغيرة، كان من الصعب أن نجد تعريفاً واحداً لمفهوم الحضارة من شأنه أن يؤطر هذا المفهوم ويرسم له حدوداً واضحة.
فهذا جميل صليبا في محاولة تعريفه الحضارة يقول بأنها تحوز على معنيين: “أحدهما موضوعي مشخص والآخر ذاتي مجرد. أما المعنى الموضوعي فهو إطلاق لفظ الحضارة على جملة من مظاهر التقدم الأدبي، والفني، والعلمي، والتقني التي تنتقل من جيل إلى جيل في مجتمع واحد أو في عدة مجتمعات متشابهة… وأما الحضارة بالمعنى الذاتي المجرد فتطلق على مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني المقابلة لمرحلة الهمجيّة والتوحش”( ). ونلاحظ هنا أن صليبا جعل من مفهوم “التقدم” العصب الرئيس لتعريفه، باعثاً شحنة حداثية في مظاهر هذا التقدم، تتمثل في جعله ممثلاً لروح العصر الحديث، في مقابل مرحلة لم تتبلور فيها مظاهر هذا التقدم فسادت فيها الهمجية والتوحش. ويقدم صليبا في معرض حديثه تعريفاً آخر للحضارة يقوم على إعطاء الأولوية للبعد القيميّ، فيقول بأن لفظة الحضارة تطلق أيضاً: “على الصورة الغائيّة التي نستند إليها في الحكم على صفات كل فرد أو جماعة، فإذا كان الفرد متصفاً بالخلال الحميدة المطابقة لتلك الصورة الغائية قلنا إنه متحضر، وكذلك الجماعات، فإن تحضّرها متفاوت بحسب قربها من هذه الصورة الغائية أو بُعدها عنها”.( ) ويرى صليبا بأنه على الرّغم من أن تلك الصورة الغائية نسبيّة تختلف باختلاف الزمان والمكان، إلا أنها تشترك في عناصر واحدة من شأنها تحديد معيار التحضر بوصفها العناصر المشكلة للحضارة، وهي في زمننا: التقدم العلمي والتقني، انتشار أسباب الرفاه المادي، عقلانية التنظيم الاجتماعي، بالإضافة إلى الميل إلى القيم الروحية والأخلاقية ( ).
ويرى معن زيادة بدوره أن الحضارة ليست سوى الإنجازات الإنسانية في كافة الميادين وانتقالها من جيل إلى جيل، وأن حصيلة التفاعل بين الأجيال الناتج عن تناقل هذه الإنجازات هو ما يشكّل أسّ الحضارة ( ). وفي تعريف زيادة هذا نجد الارتباط الضمني ما بين مفهومي الحضارة والتراث، وكأنه يقول بأن تراكم المتوارث هو ما يشكل الشخصية الحضارية لمجتمع أو لأمة ما.
والمقابل في اللغة الإنكليزية لكلمة حضارة هو كلمة Civilization وفي الفرنسية Civilisation، وتعود نشأتها إلى القرن السادس عشر، وهي مأخوذة من الكلمة الفرنسية Civillise والتي تعني متحضر أو متمدن وهي في الإنكليزية Civilized، وجذرها في اللغة اللاتينية Civilis وتعني مدني ويقابلها في الإنكليزية Citizen، وهي آتية من الكلمة اللاتينية Civitas والتي تعني مدينة ويقابلها في الإنكليزية city ( ). ويقول معن زيادة أن كلمة Civilization لم تظهر في القواميس والمعاجم في أوروبا حتى القرن الثامن عشر، حيث كان شائعاً قبل ذلك استخدام لفظة Civility والتي تعني “عمران” وتعود لابن خلدون، كما أنها تختلف عن كلمة Urbanity والتي كان يفضل استخدامها جرجي زيدان 1861-1914( ).
أمّا جذر كلمة حضارة في اللغة العربية فإنه يرجع إلى الفعل الثلاثي: حضر، وجاء في لسان العرب أن المصدر حضَر: خلاف البدو، والحاضر خلاف البادي، والحِضارة تعني الإقامة في الحضر، ورجلٌ حَضِرٌ: لا يصلح للسفر، والحضَر والحضرة والحَاضرة: خلاف البادية وهي المدن والقرى والريف ( ). ويمكننا أن نلاحظ أن الدلالة اللغوية المعجمية لكلمة الحضارة في اللغة العربية شبه متطابقة مع دلالتها في اللغتين الإنكليزية والفرنسية. وأنها تنطوي على معنى الإقامة الذي يرتبط بشكلٍ أساسي بمفهوم الاستقرار، والذي يعد بدوره المدخل الرئيس لفهم معنى الحضارة عند ابن خلدون 1332- 1406.
يرى طه حسين 1889-1973 أنه من الممكن تسمية الناظم الرئيس الذي يضعه عبد الرحمن بن خلدون لنظريته الاجتماعية ب (قانون الأطوار الثلاثة) *، وهي المراحل التي يمر بها المجتمع بطريقة متوالية. إذ في الطور الأول يعيش المجتمع عيشة البدو، حيث لا يعرف قوانين ولا تحكمه سوى حاجاته وعاداته، أما في الطور الثاني يصل المجتمع إلى تأسيس دولة عن طريق الفتح وقهر المجتمعات الأخرى، وفي الطور الثالث يتحول المجتمع إلى حالة الحضر وينغمس في الترف والرفاهية، ويهتم بدراسة العلوم والفنون حتى يصل مرحلة الاضمحلال والانهيار ( ).
إذاً يضع ابن خلدون الحضارة في مقابل البداوة تماماً، ويربطها بالإقامة في المدن والحواضر بعد تأسيس الدولة، ولا تسبق إقامة المدينة في نظر ابن خلدون تأسيس الدولة، بل تكون نتيجةً لقيامها وبقرار من حاكمها، وعليه يكون الاستقرار هو الشرط الأولي لقيام الحضارة التي هي نمط من أنماط الحياة المستقرة والذي ترسّخ برسوخ الدولة. ويبدو لنا أن ابن خلدون كان أول من وضع تعريفاً للحضارة يعطيها معنىً قريباً من الذي تأخذه في العصر الحديث، حيث يقول عنها في مقدمته أنها: “أحوالٌ عاديّة زائدة على الضروري من أحوال العُمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرِفْهِ وتفاوت الأمم في القلة والكثرة تفاوتاً غير منحصر. وتقع فيها عند كثرة التفنن في أنواعها وأصنافها، فتكون بمنزلة الصنائع…، وأكثر ما يقع ذلك في الأمصار لاستبحار العمران وكثرة الرّفه في أهلها، وذلك كله يجيء من قِبَل الدولة لأن الجولة تجمع أموال الرعية وتنفقها في بطانتها ورجالها ….، فتعظم لذلك ثروتهم ويكثر غناهم وتتزيد عوائد الترف ومذاهبه وتستحكم لديهم الصنائع في سائر فنونه، وهذه هي الحضارة”( ). ومن هذا التعريف نجد كيف أن الحضارة بعد أن تقوم بسبب قيام الدولة واستتباب عوامل الاستقرار، تتمظهر في تنوّع الحرف والصناعات وبذلك تتواشج مع فكرة التقدم التقني، وكذلك لا تنفصل عن حالة الازدهار الاقتصادي والذي يُعبر عنه من خلال انتشار مظاهر الترف والرخاء. وهكذا نتبين أن الحضارة في نظر ابن خلدون هي أولاً مرحلة تمر بها المجتمعات وتعقب حالة البداوة والتي يكون التمدن غايةً فيها، وهي ثانياً آليّة تتكشف من خلالها وضمنها مظاهر التقدم.
وثمة ثلاثة عوامل عند ابن خلدون لاستقرار وبقاء وتقدم أي حضارة، هي مزايا الأرض المتمثلة في توافر المواد الأولية، ومزايا الحكومة والتي تتحكم في آلية انتاج وتوزيع ما يتم استثماره من المواد الأولية، وثالثاً كثرة السكان وهي المعبّر عن القدرة على حماية هذه الحضارة، ويرى ابن خلدون أنه تزداد الحضارة رسوخاً كلما طال الزمن الذي يبقى فيه الحاكم حاكماً، وعمر الحضارة مرهون بعمر الدولة، فعندما تسقط الدولة تنتهي الحضارة ( ). والحقيقة أن ابن خلدون يعتقد بوجود آثار سلبية للحضارة على الناس على المستويات الجسمية والذهنية والأخلاقية، إذ هي “تؤدي إلى الترف وتبعث الفتور إلى سكان المدن وتجعلهم عاجزين عن الاحتفاظ بمزاياهم الحربية”( ). وعليه فإن القوة العسكرية هي من المقومات الرئيسة لاستمرار الحضارة في نظر ابن خلدون، الذي يبدو وكأنه يريد القول بأن الحضارة تحمل في بنيتها أسباب فنائها.
بالانتقال إلى القرن التاسع عشر نجد أن رفاعة رافع الطهطاوي 1801- 1873 يستخدم لفظة “التمدن” والتي تعني لديه الأخذ بأسباب التقدم و “التحضّر” في البلاد الأوروبية*، وذلك بما ينسجم مع التراث الإسلامي، وتندرج معالجته لإشكالية “التمدن” تحت ما نسميه اليوم بسؤال النهضة. وفي كتابه “المرشد الأمين للبنات والبنين” يُعرّف الطهطاوي التمدن فيقول: “تمدن الوطن عبارة عن تحصيل ما يلزم لأهل العمران من الأدوات اللازمة لتحسين أحوالهم حساً ومعنى، وهو فَوقانهم {تفوقهم} في تحسين الأخلاق والعوائد وكمال التربية”( ). وبذلك تكون “المدنيّة” عند الطهطاوي هي المرادف الأول لمفهوم “الحضارة”، ويكون التمدن هو الجواب المباشر لسؤال التقدم. ويحصل بتبني ما جعل الحضارة الغربية متقدمة، أي بتبني قيم الحرية والعدل والمساواة. ويؤكد الطهطاوي على العلاقة الوثيقة ما بين التمدن وتأسيس الدولة، وتقوم الدولة في نظره على حماية الحقوق الطبيعية للإنسان من خلال الأحكام والقوانين المدنية ( ).
وهنا نجد أن السؤال قد تحول مع أفكار الطهطاوي حول التمدن: من متى وكيف تكون الحضارة حضارة؟، والذي حاول ابن خلدون الإجابة عنه في مناقشته لطبيعة وخصائص المجتمع والدولة في مرحلة الحضارة، إلى سؤال كيف تكون الحضارة حديثة؟ ونجد أن تحول السؤال كان نتيجة لإدراك الطهطاوي للتفاوت في مستوى التقدم بين مصر وأوروبا، والذي تحول فيما بعد إلى مفهوم قائم بذاته هو “التفاوت الحضاري”. ويعتقد الطهطاوي أن آلية التمدن، أو آلية جعل الحضارة حديثة، من الصعب أن تكون من دون التواصل مع الحضارات المتقدمة، فيقول في كتابه (مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية) عن هذه المسألة: “لو لم يكن للمرحوم محمد على من المحاسن إلا تجديد المخالطات المصرية مع الدول الأجنبية، بعد أن ضعفت الأمة المصرية بانقطاعها المدد المديدة والسنين العديدة، لكفاه ذلك، فلقد أذهب عنها داء الوحشة والإنفراد، وآنسها بوصال أبناء الممالك الأخرى والبلاد، لنشر المنافع العمومية، واكتساب السبق في ميدان التقدمية”( ). وبذلك يكون “التواصل الحضاري” عند الطهطاوي هو آلية للتقدم ومقدمةً له، ويكون الانعزال مصدراً للتخلف وابتعاداً عمّا يجعل الحضارة متطورة وذي شأن بين نظيراتها. وبذلك يبقى التقدم مع الطهطاوي المفهوم الرئيسي المرتبط بالمدنيّة (الحضارة)، مع انفتاحها على مفاهيم جديدة في الخطاب الطهطاوي وإن كانت مضمرة وما تزال في إطار التشكل. ونعتقد بأن الرؤية التي حكمت نظرة الطهطاوي لمفهوم الحضارة مرتبطة بإشكالية النهضة، ولا يمكن فصل عراها عن تجربته الخاصة المستمدة من تواصله مع حضارة أجنبية مختلفة.
وفي القرن العشرين اتسعت دائرة استعمال هذا المفهوم في الثقافة العربية، وذلك لعدة أسباب كما نعتقد، منها ازدياد وتيرة ووسائل التواصل بين الثقافات والشعوب، وكذلك استمرار طرح سؤال النهضة في أفق العلاقة الإشكالية بين الثقافتين العربية والغربية، بالإضافة إلى اطلاع المفكرين العرب على النظريات التي نشأت في سياق الفكر الغربي والتي اندرجت ضمن ما بات يُعرف ب “فلسفة الحضارة والتاريخ”، مثل فلسفة هيغل وماركس ونظريات أرنولد توبني وأوزفيلد شبنجلر وألبرت شفيتسر وغيرهم. فكان لأفكارهم الأثر الكبير في بلورة رؤية المفكرين العرب لمفهوم الحضارة. ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: المفكر الجزائري مالك بن نبي 1905-1973الذي تمحور جهده البحثي حول إشكالية التخلف الحضاري “للأمة الإسلامية” في مرحلة ما بعد الاستعمار. وكذلك نجد الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي 1917- 2002 والذي تأثر بشدة برؤية المؤرخ الألماني أوزفيلد شبنجلر لمفهوم الحضارة، فعلى سبيل المثال يقول بدوي في كتابه الموت والعبقرية: “إن ما يصدق على روح الأفراد يصدق بالضرورة على روح الحضارات، وهذه الفكرة قد فصّل بها اشبنجلر وأوضحها تمام التوضيح”( ). ونلاحظ هنا نشوء مفهوم مرتبط بالحضارة هو “روح الحضارة”، والذي يدلل على امتلاك حضارة ما شخصية لها خصوصيتها تميزها عن غيرها.
ونعتقد أن عبد الرحمن بدوي يختزل المضامين التي يكتنفها مفهوم الحضارة في البعد الفكري فقط، وذلك حينما يتطرق للعلاقة بين الحضارتين العربية واليونانية في مقدمة ترجمته عن الألمانية لبحث قد نُشر في المجلة الألمانية “الحضارة القديمة”، يحمل عنوان “الشرق والتراث اليوناني”، وقد اختار بدوي نشره مترجماً إلى العربية في كتاب أعطاه عنوان “روح الحضارة العربية”، وقد برّر ذلك لأنه يعتقد كما يقول أنّ “البحث في أثر التراث اليوناني في الحضارة العربية ليس مجرد بحث في تأثير من التأثيرات الأجنبية في حضارة أخرى ولَجها، بل هو بحثٌ في صميم تلك الحضارة، هو بحث في “روح الحضارة العربية” نفسها بكل مقوماتها وعناصرها”( ). وبرأينا أن نظرة بدوي لمفهوم الحضارة ولطبيعة العلاقة بين الحضارات حكمتها رؤية اختزالية، كان من شأنها جعل الحضارة أن تمثل المظهر الفكري لأمة من الأمم فحسب، هذا إذا سلمنا بصحة مقولته، بيد إننا نعتقد أنه لم يختزل الحضارة في الفكر فحسب، بل اختزل كذلك الفكر بالفلسفة.
وهكذا نرى أن عملية تشكل مفهوم الحضارة وتنوع المنظورات إليه في الثقافة العربية، لم يكن منفصلاً عن عميلة تشكل الحضارة العربية نفسها وعلاقتها بغيرها من الحضارات، وإن الدلالات التي حملها كانت مرتبطة بشكلٍ وثيق بفهم آلية تشكل الحضارة بوصفها تمظهرات لمجموعة من الحالات والعمليات، والتي يعبر عنها بمفاهيم ذات طبيعة إشكالية كمفاهيم التقدم والترف والتمدن…الخ. ولا يسعنا سوى القول بأن ما قدمناه في هذا البحث المصغّر ليس سوى مجموعة نماذج تاريخية لآليات وطرائق تناول المصطلح، لا تشمل بالتأكيد جميع سياقات فهمه ومستويات استعمالاته في الثقافة العربية.