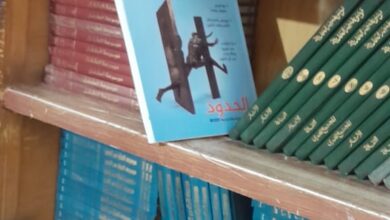أحمد رفيق عوض: حكايات العجائز عن قرى يافا.. جعلتني كاتبًا

كنا نحيا في القصص، فلا شيء يموت أبدًا فيها، لقد أورثوني ذاكرتهم، مثلًا أستطيع أن أحكي لك عن قرية “السنديانة”، التي هُجِّر منها أبي
لم يستوقفه الموت في صغره؛ لأنه كان يلعب مع الرفاق في ساحة بين المقابر، لكن يبدو أنه كان على موعد مع فاجعة ضخمة
كيف يشعر بتقدُّمه في العمر وقد صار الآن في الثالثة والستين؟ يجيب: “كل شيء تغير، الناس والمكان، المزاج والطعام والكلام والنساء والدول”
حينما جئت إلى رام الله لم يكن معي المال، اضطررتُ أن أعمل في كل المهن، صحفيًّا، ومترجمًا ومدرِّسًا، عملت أيضًا في الإذاعة والتلفزيون
التقى رفيق بمحمود درويش مرتين أو ثلاثًا. يقول: “كان الحوار بيننا لا يجري مجرى جيدًا للأسف، ولذلك لم أزره إطلاقًا رغم أنه شاعر كبير جدًّا”
استضفنا سميح القاسم في رام الله، وقابلته أكثر من مرة. إنه عن قربٍ رجلٌ جميل، رغم أنه يتعامل كالطاووس، كان مرتاحًا ماديًّا

———————- حوار: حسن عبد الموجود
حينما أصدر الكاتب الفلسطيني أحمد رفيق عوض روايته “العذراء والقرية”، عام 1992، قامت الدنيا ولم تقعد في قريته “يَعْبَد”، فإحدى العائلات قرأتْها، ورأتْ أنه يقصدها، ويقصد نساءها. تعالت الأصوات بأنه يجب القصاص لـ”شرف العائلة”، ثم انتهى كل شيء بخروج رفيق إلى “رام الله”، حتى هدأت العاصفة. أدرك أنه مرَّ بسلامٍ من المشكلة، فانكبَّ على الكتابة من جديد، وأصدر عددًا من الروايات المتتابعة، “قدرون”، ثم “مقامات العشاق والتجار”، و”آخر القرن”، و”القرمطي”، و”عكا والملوك”، وبعدها صدرت آخر رواياته عام 2006 بعنوان “بلاد البحر”. بدا كأن رفيق انقطع عنه الوحي، لكنه في الحقيقة كان يبحث عن أكل العيش، عمل في كثير من المهن، ثم قرر إكمال دراسته العليا بالجامعة حتى صار أستاذًا بها، قبل أن تجذبه السياسة وتلتهمه التهامًا.
يتذكَّر رفيق تفاصيل ما جرى منذ واحد وثلاثين عامًا في “يَعْبَد”: “كانت هناك عائلة ذات نفوذ اتهمني كبارها بأنني أكتب عنهم، أو بشكل أدق عن “شرفهم”. هددوني وطاردوني وهاجموا بيتي. تدخلت القوى الوطنية والمسلحون، ثم صارت القصة خطيرة جدًّا إذ هُددتْ حياتي وبيتي وأهلي، وبعد نقاش ومفاوضات طويلة اتفق الجميع على أن أغادر يَعْبَد درءًا للشر، فغادرتُ، ومن يومها مكثتُ في رام الله، ولم أفكر في العودة، ليس لأنني غير قادر على ذلك، لكن لأنني لا أفضِّل العودة إلى قرية طردتني ولم تفهمني، اخترت البقاء في رام الله، وصنعت معها علاقة رائعة، مع العلم أن بيتي لا يزال في يَعْبَد، وأذهب لزيارة أهلها بانتظام”.
يحكي موقفًا لا يُنسى في يَعْبَد. هناك عدد من مقامات المتصوفة يتعامل معها الأهالي باعتبارها أماكن مقدسة، يعيدون طلاءها من فترة إلى أخرى، وإذا عبر أحدهم بها يضع عليها الحنَّاء أو أباريق الماء، أو السجاجيد. رفيق اعتبر أن هناك سرًّا داخل تلك المقامات وأراد أن يكشفه. اختار أحدها، وقرر اقتحامه ليرى بنفسه هل يمكن أن يحدث له شيء مما تردده الأساطير الشعبية؟ استجمع شجاعته، ودخل بمفرده مقامًا مبنيًّا تحت شجرة بلوط ضخمة وتاريخية، وفوجئ، يا للدهشة، بأن المكان عادي جدًّا، مجرد قبر، لا أكثر ولا أقل، وهناك على جانبه إبريق ماء غير نظيف. بعد سنين طويلة للغاية كتب روايته “الصوفي والقصر” عن السيد البدوي. يعلِّق: “كتبت ما يُعبِّر عن وجهة نظري، أن زيارة القبور بالمعنى الديني فيها مشكلة، وحالة يجب الانتباه لها والسيطرة عليها، وعدم الانسياق خلفها. بعد أن انتهيت من كتابة روايتي أدركت كم كنت متأثرًا بموقف زيارة الضريح في صباي دون أن أدري”.
والدته كانت أُميَّة ولكنَّ غناءها وبكاءها وعطفها على الطير، لا على الناس فقط علَّمه الكثير، أما والده فكان (يفكُّ) الحرف ولكنه نقل إليه كثيرًا من خبراته، عن رعاية الأشجار وحراثة الأرض وانتظار الزرع. يقول: “كان أبي يحكي لي كثيرًا من القصص المدهشة، ليس هو فقط، كنت محاطًا طوال الوقت بحكائين عظماء رغم أنهم أشخاص عاديون بمنطق الحياة، هناك شخص اسمه “فتحي”، ولا أتذكر اسمه الثاني، كان يجمعنا، نحن أطفال العائلة، ويحكي لنا قصصًا مذهلة. كان عندنا أيضًا شخص اسمه “المصرد”، ولا تسألني عن سبب التسمية. (في المعجم الوسيط: رَجُلٌ مِصْرَادٌ: رَجُلٌ سَرِيعُ الثَّأَثُّرِ بِالبَرْدِ). كان يحكي قصصًا عجائبية، كل عجائزنا من بلادنا في الساحل، حيفا ويافا، ممن هُجِّروا يحكون قصصًا عن الأماكن التي تركوها، عن الموتى والأحياء، المآتم والأعراس، العاديين والأبطال. أُحطتُ دائمًا بأشخاص يمتلكون ذاكرة حية، لا ينضب معينها من الحكايات المدهشة، والجميل أنهم يشبهونني، فأنا أنتمي مثلهم لأبناء المهاجرين الفلسطينيين عام 1948. كنا نحيا في القصص، فلا شيء يموت أبدًا فيها، لقد أورثوني ذاكرتهم، مثلًا أستطيع أن أحكي لك عن قرية “السنديانة”، التي هُجِّر منها أبي، رغم أنها لم تعد موجودة على الخريطة الآن، عن شجعانها وعائلاتها وبساتينها ومعتقداتها. أنا ابن ذاكرة حيَّة باقية أبدًا ولن تموت بإذن الله”.
في السبعينيات لم تكن هناك كتب إلا مجلدات التراث القديمة، لحسن الحظ من بينها طبعة بولاق لـ”ألف ليلة وليلة”، كانت الوحيدة المتاحة، أجهز عليها صفحة بعد صفحة، قرأ أيضًا سيرة سيف بن ذي يزن، ورواية “سجين زندا” للكاتب البريطاني أنتوني هوب، لكنه بخلاف ذلك لم يجد سوى كتب السحر: “المجرم المحتل شجَّع على إصدار كتب الشعوذة. لم تكن هناك مكتبة عامة، الناس لم يعتبروا أن الكتب مهمة، في مثل تلك البيئة الفقيرة يُعتبرُ الكِتاب ترفًا. ذهبت إلى “مدرسة جنين”. كنت أسرق الكتب من مكتبتها، لأنى لم أملك المال الكافي لشرائها، لكن لحسن الحظ أنَّبني ضميري فذهبت إلى الأستاذ صالح جرَّار وأخبرته بذنبي، فحكى أمام الطلاب بحماس وبلغة فصيحة كعادته عن طالب مجتهد ومليح كان يسرق الكتب ثم جاء ليعيدها”.
أكثر صفة التصقت به في صباه أنه “شاطر”، و”خياله واسع”، وبسبب اللقب الثاني تحديدًا أطلق الرفاق والأقارب عليه اسم “شرْعب”، تيمنًا باسم رجل يحب اختراع القصص، وكان “رفيق” مثله، يخترع القصص حول أي شيء. يقول: “شرعب كان رجلًا طويلًا وجميلًا ومذهلًا، يرتدي الحطَّة والعقال، ويمسك بعصا دائمًا. يكذب أو دعني أقول يخترع القصص، حكى مثلًا أنه أراد ذات يوم إشعال سيجارة، ولما لم تكن معه ولاعة، ذهب إلى طائرة في مدرج الطائرات و”طخَّ” خزان الوقود، خرَّ البنزين، فعبَّأ الولاعة، وأشعل السيجارة، و”طخَّ” الخزان مرة أخرى حتى يلحم فتحته، لقد رأى الناس وجه شبهٍ كبيرًا بيننا، ويبدو أن خيالي كان متَّقدًا لدرجة أنني فقتُ شرعب عليه رحمة الله. إنني أتذكره كأنه ماثل أمامي الآن، إنه مثل أي شخص جميل يصبح عصيًّا على النسيان”.
لم يستوقفه الموت في صغره، لأنه كان يلعب مع الرفاق في ساحة بين المقابر، لكن يبدو أنه كان على موعد مع فاجعة ضخمة، فقد ماتت أخته “نجاح” في الخامسة من عمرها: “كانت تبني مثل معظم البنات بيوتًا، تجلس لتحكي لأصدقاء خياليين أنها تزوجت من زياد، وأنها أنجبت لميس وأنيس وخميس، وكنا نشاركها لعبها غالبًا، نسألها أين زوجك؟! أين أولادك؟! وكانت تلك الفتاة المذهلة الجميلة تشير إلى بيتها الصغير وتقول: هنا. عدتُ من المدرسة ذات يوم وفوجئت بأبي يمسكني من يدي وينتحي بي جانبًا بعيدًا عن الأعين. شعرت بقلق هائل ثم أخبرني: أختك ماتت. ظلت تفاصيل اليوم عالقة بوجداني. كان نهارًا باردًا ومعتمًا وهناك غيم في السماء وأظن أنها أمطرت قليلًا. شعرت بالفاجعة رويدًا رويدًا. الفقد طعمه قاس ومخيف، إنه موجود أسفل الأنف، من شدة القرب لا يُرى، ولا يُنتبَه إليه”. أراد أن يُضحِك أباه وأمه فكتب القصص وقرأها عليهما، كان يراقب الجيران وشجاراتهم، ثم يدوِّن ما شاهده في الأوراق، وكان الاثنان يتجاوبان معه بالضحك. نشر أول قصة في صحيفة يومية تصدر في القدس، وهو في عمر الخامسة عشرة بعنوان “أريد نقودًا”، يعلِّق: “فوجئت بأخي يطلب أن يقرأ القصة هذه المرة، وقرأها فعلًا ثم بكى وبكوا، ولا أعرف حقيقة سر تأثرهم الشديد، لكن منظرهم هزَّني”.
كيف يشعر بتقدُّمه في العمر وقد صار الآن في الثالثة والستين؟ يجيب: “كل شيء تغير، الناس والمكان، المزاج والطعام والكلام والنساء والدول، الزمن يغير الأشياء ومعناها ووظائفها. ضاع أصدقاء الطفولة، وأخذتهم تصاريف الدنيا، لم نشترك في أعمالنا أو خياراتنا أو حتى أماكن عيشنا، ربما كنت أكثر منهم تنقلًا وحركة، الآن بالكاد أتذكر الأسماء أو حتى الوجوه ولا حول ولا قوة إلا بالله”.
يعتبر رفيق نفسه حكَّاءً، النثر أقرب إلى عقله وقلبه، النثر فيه، كما يذهب، جدل وآراء واختلاف، فيه اعتراف بالآخرين، وفيه حكمة أكثر، أما النقد الأكاديمي فيجعله أكثر قدرة على صياغة أفكاره. يقول: “الرواية عالم عجيب، تسمح لي بالتحليق والقول والتغريد، الرواية هي ما لم يقله المؤرخ ولا الفيلسوف ولا الباحث، الرواية بالنسبة لي كل ذلك مضافًا إليه لمسة الجمال وقوة الوجدان. أما البحث الأكاديمي فصادم وحاد، ولم أحبه، ولولا المكانة الأكاديمية والمتطلبات المجتمعية ما كان ذلك يهمني على الإطلاق”.
عمل في الأكاديميا رغم كرهه لها. يفسر: “حينما جئت إلى رام الله لم يكن معي المال، اضطررتُ أن أعمل في كل المهن، صحفيًّا، ومترجمًا ومدرِّسًا، عملت أيضًا في الإذاعة والتلفزيون معدًّا ومقدم برامج ومدرِّبًا ومؤلفًا، وفي لحظة ما قررت الاتجاه إلى الجامعة. اللقب العلمي أضاف لي طبعًا، لو قلتُ شيئًا آخر أكون غير أمين، كنت قادرًا على إنتاج الأفكار أكثر من تأصيلها؛ ولذلك ساعدتني الأكاديميا على إثبات ما أقول، حتى إنني أصدرت عدة كتب بدون مراجع، وتحديتُ الجميع أن يثبتوا أنني سطوت على مجهود أحدهم، قلت لهم: ها هي الكتب بين أيديكم، من يستطع منكم أن يُخرِج برهانه فليقدِّمني إلى المحاكمة. وبرغم كل هذا أنا، بصدقٍ، لا أحب الأكاديميا، ففيها الكثير من النفاق والكذب والادعاء، لكنها أيضًا أكل عيشي فماذا أفعل؟”.
نشر رفيق قصته “رجل تحت الاحتلال” في مجلة “الفجر الأدبي” عام 1984 تحت اسم “فكري خليفة”، فقوبلتْ بكثير من الترحيب، يقول: “كتبت تحت هذا الاسم لأنني موظف في مؤسسة، تسيطر عليها قوات الاحتلال، فكان عليَّ أن أتخفَّى حتى لا أُطرد من وظيفتي”.
الفلسطينيون غالبًا يعيشون باسم وهمي يخفون أسفله اسمهم الحقيقي. يقول: “الأشخاص الذين يعيشون باسمين هم من اختاروا العمل الوطني والحزبي، أنا شخصيًّا لم أكن كذلك، إذ أنتمي إلى أسرة بسيطة. اهتممتُ بوالديَّ، حيث كان عليَّ أن أعيلهما طيلة الوقت”.
كانت التيمة الأساسية التي يعمل عليها، وما يزال، فيما يكتب، هي قضية الهزيمة والنصر، العلاقة مع الآخر، الاحتلال كفكرة ساقطة ومخزية، وقد كُتب عنه الكثير من المقالات والدراسات ورسائل الماجستير والدكتوراه، يعلق: “هذا لا يعني عدم وجود من يتربص بي، بالعكس كان هناك من يتستَّر بشعار الرأي الآخر، ثم يقذفني بالرصاص”.
أسأله هل السياسة فرض عليك؟ فيقول: “نعم، إنها صلب عملي، وحياتي. دوري كمثقف يهتمُّ بشعبه ووطنه يفرض عليَّ أن أمارسها”.
كتب رفيق أربع مسرحيات، تُرجمتْ اثنتان منها إلى الإيطالية. ذهب إلى روما ووقَّعهما أمام جمهور غفير، شعر بالدهشة حينما رأى كل هؤلاء البشر يهتمون بالمسرح، يقول: “رأيت أن المسرح متقشف جدًّا، وهو ليس مثل الرواية فيها زخرفة وإضافات وتشعُّبات وحشو. المسرح أقرب لي، لأنه يجعلني قادرًا على قول ما أريد بسرعة، لكن للأسف لم تجرؤ أي جهة على عرض ما أكتبه. كانت هناك محاولات من البعض لكنها فشلت، ربما لأن مسرحياتي ثقيلة أو صعبة أو جريئة، لا أعرف”.
أبناؤه كبروا دون أن ينتبه، بحسب تعبيره، تحولوا إلى معارف وأصدقاء وشركاء، لا يقول لهم الكثير، بل هم من ينصحونه ويُضحِكونه، يقول: “عندهم قدرة هائلة على اكتشاف المفارقة الساخرة على عكسي تمامًا”.
الصداقة تلعب دورًا مهمًّا بالنسبة له. من أصدقائه الروائي جمال الغيطاني. كتب مقالًا عن روايته الأولى “العذراء والقرية”، في جريدة “أخبار الأدب” فخفف عنه الضغط الاجتماعي والنفسي، وعندما زاره في مكتبه بالجريدة، في وقت لاحق، سحره بلطفه وموسوعيته وقدراته المتنوعة. يطرح مزيدًا من الأسماء: “هناك أيضًا التقيت بالروائي وصاحب النص الذكي ومتعدد المستويات عزت القمحاوي، ثم صادقت الناقد يسري العزب -رحمه الله- كان رجلًا لا يُنسى، يصلي العشاء وهو يرتدي شورتًا قصيرًا. نظم لي ندوة في “جمعية الأدباء”، وكتب عني وعرَّفني بأجواء القاهرة التي لا يراها السائح. كان له صديق غامض للغاية جاء فجأة من الصعيد، يجلس صامتًا ولا يتحدث مع أحد أبدًا، لكن يبدو أنه رأى فيَّ شيئًا ما فقد اختصَّني بالكلام، اندهش العزب وسأل: لماذا أنت بالتحديد؟ هذه هي شخصيات المدن الكبرى الغريبة، التي تعيش حياتين أو ثلاثًا، أما نحن أبناء القرى فلا نعيش سوى بوجوه سافرة وبسيطة، عرفت أيضًا الشاعر أحمد بخيت، وكذلك محمد سلماوي، الاثنان عاملاني كأخٍ وصاحب مكان، كل المصريين فيهم تلك البساطة الآسرة، أشخاص بدون تعقيد، يتعاملون مع الحياة بمنطق ساعة لقلبك وساعة لربك”، يضحك: “لكن عليَّ أن أعترف أن صداقة المثقفين المصريين خطرة!”.
صداقاته مع الفلسطينيين كثيرة، زهير أبو شايب، يوسف عبد العزيز، المتوكل طه، زياد خداش، يوسف المحمود، مراد السوداني. يرى أن كلمة “عداقة” أقرب إلى تعريف علاقته بمعظمهم أكثر من كلمة “صداقة”، ربما لأن كل كاتب يشعر بأنه الكونُ كلُّه، وبذلك يجب، كما يذهب، أن تُقدَّم له فروض المحبة والطاعة والاحترام.
التقى رفيق بمحمود درويش مرتين أو ثلاثًا. يقول: “كان الحوار بيننا لا يجري مجرى جيدًا للأسف. ولذلك لم أزره إطلاقًا رغم أنه شاعر كبير جدًّا، أما سميح القاسم فاستضفناه هنا في رام الله، وقابلته أكثر من مرة. إنه عن قربٍ رجلٌ جميل، رغم أنه يتعامل كالطاووس، كان مرتاحًا ماديًّا، وبالتالي جعلته الطمأنينة يتصرف طوال الوقت كشاعر، لقد أحببته، وظلت العلاقة بيننا على بساطتها محترمة للغاية”.
وأخيرًا يقول: “إذا منحني الله العمر، فإنني أرغب في العودة إلى يَعْبَد، لأعيش في أرضي، مع أشجاري مثل أبي، أحيا وأكتب وأتذكر”.
** المصدر: مجلة الجسرة الثقافية. العدد: 63