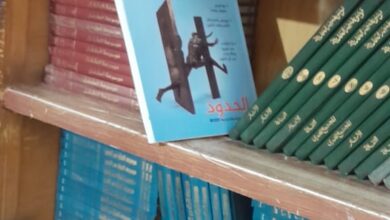رحلة في الزمان والمكان إلى إسطنبول.. مدينة الأعاجيب

هي مدينة دار السعادة، وسعادات (أو دار الحظ السعيد)، في الكتابات العثمانيّة القديمة، ومدينة الله لتعدّد الهُويات الدينيّة
الأغرب في هذه المدينة أنها صبغتْ صفة التناقض -التي اتسمت بها- على حُكّامها، فالسُّلطان محمد الفاتح كان مركبًا من التناقضات؛ وحشي ووديع وقاسٍ ومتسامح
شغف الفاتح بأن يجعل من مدينته مدينةَ العالم، دفعه إلى الذهاب إلى بورصة وإجبار الصُّناع على الانتقال إلى العاصمة الجديدة، وقدّم لهم الكثير من الإغراءات
كل مَن زارها مِن الرحالة أُعجب بها ووصفها بأنها مدينة متفردة في كل شيء، فهي المدينة الكوزموبوليتانية، المتعدّدة الأديان والأعراق، والهويات
زارها جوته وفلوبير ونرفال ودي أميكس، والرسام ملينج، ومن العرب الرحالة ابن بطوطة الذي سجّل في سفره العظيم “تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار”
إسطنبول ليست مجرد مدينة في كتابات باموق، بل هي صورة مُصغرة لتركيا بكافة وجوهها، وعبرها يرصد مستقبل تركيا، وهو يحفر في تعرجات وأخاديد ماضيها

——————-ممدوح فرّاج النّابي
لم تحظَ مدينةٌ من المدن بكم هائل من التناقضات مثلما حظيت مدينة إسطنبول، على المستوى الثقافي والديني والعرقي وعلى مستوى الموقع الذي يشطرها بين قارتي آسيا وأوربا؛ فاكتسبت هويتها بذلك تركيبة كوزوموبوليتانيّة لا مثيل لها في بلدان العالم، مِن حيث التعايش، واحتفاظ كلّ عرق بهويته وديانته ولغته؛ حتى قيل إنك تسمع في شوارعها اللُّغات اليونانيّة والأرمينيّة والإيطاليّة واللغة المشتركة والألبانيّة والبلغاريّة والصربيّة بانتظام، فضلًا على العربيّة والفارسيّة والتركيّة، إنها مدينة الله والأعاجيب كما وصفها الرحالة في يومياتهم وكتبهم.
تتميّز المدينة بطابعها الأثري (التاريخي) الذي يمزج الأصالة بالمعاصرة، والطابع الديني بالعلماني، والسلطة والنفوذ بالاضمحلال والسقوط؛ لذلك تعج بمعالم تعكس ثراء المدينة الحضاري والتراثي، وفنها المعماري الأصيل ومكتباتها التي كانت تسحَر القلوب وتجعل الرِّحال تُشدّ إليها من كلّ مكان، وكانت قوافل الجمال تنقل الكُتب القديمة إلى المدينة بصورة دائمة ما جعل مكتباتها تفيض بالكتب والمخطوطات، وأشهر مكتباتها مكتبة جامع السليمانيّة، وهي المكتبة التي أمر سليمان القانوني (في عام 1927) أن تكون مُلحقة بالجامع الذي ضاهى في روعة بنائه وتصميماته، ومآذنه مسجد أيا صوفيا، وهي مكتبة فريدة إذْ تحتوي على العديد من المخطوطات النادرة، إضافة إلى مجموعات خزائن شخصية تبرع أصحابها إليها مثل: مجموعة عبد الغني أغا، وأيا صوفيا، ومجموعة جار أفندي ، ومجموعة وقف الخير وغيرها الكثير تبلغ 117 مكتبة شخصية.
دار السعادة
وقد أخذت المدينة منذ نشأتها أسماء كثيرة تكشف عن هذه التعدديّة التي اتسمت بها، فعرفت لدى كل عرق باسم مختلف، يعكس هويته، فهي مدينة دار السعادة، وسعادات (أو دار الحظ السعيد)، في الكتابات العثمانيّة القديمة، ومدينة الله لتعدّد الهُويات الدينيّة، وما اقترن بها من مساجد وكنائس وكنس، ومدينة الأعاجيب، وبيزنطة والقسطنطينيّة التي تأسّست على يد الإمبراطور قسطنطين ومنه أخذت اسمها، وكان يريد أن يُسمّيها روما الجديدة، لكن أبتْ عليه وتمنعتْ، وهناك أسماء أخرى مثل: رومية الكبرى، وأورشاليم الجديدة، ومدينة الحج ومدينة القديسين، ودار الخلافة، وتساريغراد (أي مدينة القياصرة)، والبوليس في اللغة اليونانيّة اليوميّة أي المدينة، كأنّ لا مدينة سواها، وعرش السلطنة، والأستانة (التي تعني بالفارسيّة مقر الدولة)، وباب السّعادة، وعين العالم ومأوى الكون، ثم هناك الدار العليّة، والتكية الكبيرة، والآستانة أي عتبة الباب والمركز، وملكة المدن، وإسلامبول وهو الاسم الإسلامي الذي حُرّف منه الاسم الحالي، وهو بمعنى (حيث يسود الإسلام)، وقد جاء الاسم تقديسًا للصحابي أبي أيوب الأنصاري، الذي مات أثناء حصار يزيد بن معاوية للقسطنطينية عام 669 ه، فأخذت المدينة الطابع الإسلامي منه، وغيرها من الأسماء التي عبّر كل اسم منها عن المرحلة التاريخيّة التي هيمنت عليها، لكن يبقى اسم مدينة الله أو المدينة المتسامحة هو أكثر الأسماء اقترانًا بها. وقد قال عنها نابليون الأول “القسطنطينية! القسطنطينية! إنها إمبراطورية العالم“.

الأغرب في هذه المدينة أنها صبغتْ صفة التناقض -التي اتسمت بها- على حُكّامها، فالسُّلطان محمد الفاتح كان مركبًا من التناقضات؛ وحشي ووديع وقاسٍ ومتسامح، بنى مدارس وأسواقًا بالحماسة نفسها التي أمر بها بالتعذيب وارتكاب المذابح، والسلطان سليمان القانوني، صاحب الفتوحات، بقدر ما كان ورعًا مغرمًا بالفتوحات، إلا أنه كان مولعًا بالنساء، ومثلما كان شاعرًا مهذبًا، كان قلبه حجرًا أمر بقتل ابنه مصطفى وإخوته، أما السلطان ياووز سليم الذي صارع أباه وقتل أخاه جيم، وأعدم طومان باي، فقد كان شاعرًا رقيقًا عاشقًا، وشعره يحمل لمحة صوفيّة.
في الأصل هي مستعمرة يونانيّة قديمة تُعرف باسم بيزنطة، تأسّست في القرن السّابع قبل الميلاد، على يد مجموعة من المستوطنين الإغريق الوافدين من مدينة ميغارا، وأسسوا مدينة باسم ملكهم بيزاس، وبالنسبة لموقعها الآن، فهي تقع في منطقة مرمرة شمال غرب البلاد، وهي شبه جزيرة مثلثة، تحيط بها المياه من ثلاث جهات؛ شمالاً مرفأ القرن الذهبي، وفي الجنوب بحر مرمرة (الذي يربط بين بحر إيجة والبحر الأسود)، وفي الشرق مضيق البوسفور الذي يفصل بين قارتي آسيا وأوربا، ويُقسِّمها إلى قسمين، شرقي وغربي، يقع القسم الشرقي في قارة آسيا (شبه جزيرة كوجالي)، ويقع القسم الغربي (شبه جزيرة تشاتالجا) في قارة أوربا شرقي منطقة تراقيا الواقعة جغرافيًّا جنوب شرقي البلقان.
وتعدُّ إسطنبول أكبر المدن في تركيا، وثاني أكبر مدينة في العالم من حيث السُّكان، وكانت عاصمةً للكثير من الدول والإمبراطوريات عبر تاريخها الطويل، وبحكم موقعها المتميز الذي جعلها من أكثر المواقع الدفاعيّة في العالم، فكانت عاصمة للإمبراطورية الرومانية، والإمبراطورية البيزنطيّة (أو الإمبراطورية الرومانيّة الشرقيّة)، والإمبراطورية اللاتينيّة، وهي الدولة الصليبيّة الإقطاعيّة التي أقامها قادة الحملة الصليبية الرّابعة التي انتزعوها من الإمبراطورية البيزنطيّة بقيادة البندقيّة، والدولة العثمانيّة، وقد وصفها أحد البيزنطيين بأنها “المدينة التي يشتهيها العالم“.
عُرفت بهذا الاسم بعد أن سقطت القسطنطينية على يد محمد الفاتح (البالغ من العمر عشرين عامًا) في 29 مايو / أيار 1453 م، بعد حصار استمر 53 يومًا، وقد دخلها على حصان أبيض، وقد اقترن فتحها وقائدها ببشارة عن الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- قبل ثمانية قرون من فتحها “لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش”، ظلت تتردد في كل مناسبة.
بعد الفتح نقل الفاتح عاصمة الدولة العثمانية من أدرنة إلى القسطنطينية والتي أصبح اسمها إسلامبول أي مدينة الإسلام، وكانت المدينة من خلق آل عثمان تشبّهًا بتلك المدن التي أسستها عائلات مثل “آل هابسبرغ الذين أوجدوا فيينا)، فهم كانوا في حاجة إلى مدينة عالمية في مستوى إمبراطوريتهم، خاصة وأن الفاتح أطلق على نفسه لقب “فاتح العالم”، أو “ملك العالم”، ومدينته “عالم بيناب Alem penab، التي تعنى “مأوى العالم”، وقد حوت قوميات متعدّدة ضمّت اثنتين وسبعين قوميّة ونصف قوميّة، ومن ثمّ غدت التعدديّة القوميّة جوهر القسطنطينية، وقد يرجع البعض سبب هذه التعدديّة إلى أن السُّلطان محمد الفاتح كان يحتاج في عاصمته الجديدة إلى سُكّان كثيرين ومزدهرين لخدمة القصر وماكينة الدولة، ولم يكن هناك ما يكفي من الأتراك والمسلمين لجعل القسطنطينيّة مدينة تركيّة تمامًا.

وحسب المؤرخ كريتوفولوس أن السلطان الفاتح بعد عام 1453، جمع أُناسًا “من كل أرجاء آسيا وأوربا، ونقلهم بكل عناية وسرعة، وهم أناس من كل الأمم، خاصّة المسيحيين، فقد كان ولعه بالمدينة شديدًا، وكذلك بتأهيلها بالسُّكان، وإعادة ازدهارها السابق”، ومن الطريف أن في كل مَحلّة (أي حي باللغة التركية) كان يوجد “وحدة المعيشة الأساسيّة التي تضمّ دور عبادة لقاطنيها، ودكاكين وأسبلة وحراسًا ليليين”، وكانت تحتفظ باسم المدينة الأصليّة التي جاء منها سكانها ، وكذلك عاداتهم الخاصّة ولغاتهم وأساليب عمارتهم.
شغف الفاتح بأن يجعل من مدينته مدينةَ العالم، دفعه إلى الذهاب إلى بورصة وإجبار الصُّناع بالانتقال إلى العاصمة الجديدة، وقدّم لهم الكثير من الإغراءات، وأمرهم ببناء البيوت الضخمة، والحمامات العامة، والخانات والأسواق، والورش، وأيضًا استورد الفاتح يونانيين، وكما جلبَ الأرمن، وقد حافظوا على هويتهم ولغتهم، وبرعوا في أعمال الصِّناعة والصَّاغة والتِّجارة، وبالمثل استقدمَ إيطاليين مع توسُّع فتوحاته. حالة التعايش التي شهدتها المدينة، وقدّمت نموذجها لكلّ مُدن العالم في تسامحها واستيعابها للجميع تحت مظلتها، حتى غدت مدينة الله، يؤكدها نموذج التاجر ألفيس غريتي، فإلى جانب كونه واحدًا من الأوربيين الذين كوّنوا ثرواتهم على ضفاف البسفور، وممثلًا دبلوماسيًّا للصدر الأعظم وتاجرَ جواهر، كان يعيش (حسب ما تردّد) حياة المسلمين بين الأتراك، وحياة المسيحيين بين الأوربيين الغربيين، وعلى أرضها عاش اليهود الذين جذبتهم المدينة، بل شجعت الإمبراطورية اليهود على الهجرة إليها، ومن قبل عانى اليهود من استعباد ووحشية العثمانيين أثناء الفتح، بل أرغموهم على السرغون أو التهجير القسريّ.
ومن جانب آخر سبّب تنامي هذه الإمبراطورية مخاوفَ كثيرة؛ إذ اعتبر العلّامة ابن خلدون أن خطر آل عثمان المقيمين في إسطنبول، أكثرً تهديدًا على الشرق من المغول وهولاكو الذي كان زحفه مستمرًا، فقال بصريح العبارة: «ما يُخشى على مُلك مصر إلا من ابن عثمان»، في إشارة إلى الدولة العثمانية التي كانت لا تزال وقتها في طور الإمارة، وسنوات الصعود العسكري السريع بآسيا الصغرى «الأناضول».
مدينة الأضداد
كل مَن زارها مِن الرحالة أُعجب بها ووصفها بأنها مدينة متفردة في كل شيء، فهي المدينة الكوزموبوليتانية، المتعدّدة الأديان والأعراق، والهويات، وهو ما جعلها ملتقى لكلّ الأضداد؛ الأديان المتقاتلة، والقوميات المتصارعة خارج أسوارها، والمتع الحسيّة على اختلافها وإلى أقصى درجاتها، وعاصمة العدو الذي يجب أن تستعاد والذي يجب أن يُباد، والملجأ والملاذ، أو مأوى الكون كما سماها حُكّامها، كما كانت عاصمة الإسلام والكنيسة والأرثوذكسيّة وجزءًا من نظام الدول الأوربية، ومقصدًا للأفكار والبشر من باريس إلى دلهي وجاكرتا.
وقد زارها جوته وفلوبير ونرفال ودي أميكس، والرسام ملينج ، ومن العرب الرحالة ابن بطوطة الذي سجّل في سفره العظيم “تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار”، بعض الغرائب أو المتناقضات التي رآها في بلاد الأناضول “آسيا الصغرى” منشأ دولة العثمانيين، أن طوائف الحشاشين تنتشر في البلاد، وعاداتهم التي تمزج الرقص والشراب بالتصوف، إضافة إلى إعلائهم اليهود على المسلمين، وعدم نهيهم عن المنكر الذي أمر الإسلام بالنهي عنه، كما سجل ملاحظة بداية ما عُرف “الدوشرامة” أي اختطاف الصبيان المسيحيين من بلاد الأناضول، وإجبارهم على اعتناق الإسلام، ثم تدريبهم ليكونوا جنود الإنكشاريين فيما بعد، كما تعجب من تولّي النساء أمر المملكة؛ إذ لاحظ أن السُلطانة هي الحاكمة والمسيطرة.
الغريب أن هذه الكوزموبوليتانيّة (أو ما لمّح له ابن بطوطة بالانحياز لغير المسلمين) كانت موضع انتقاد وسخرية من الأتراك أنفسهم، حتى إن أحد الشّعراء كتب ناقمًا:
- إذا أردت أن تكون صاحب حظوة على عتبة السلطان
- فلا بد أن تكون يهوديًّا أو فارسيًّا أو فرنجيًّا”.
الطابع الإسلامي الذي سعى السلطان محمد الفاتح إلى ترسيخه في المدينة، كان متجليًّا بصورة أوضح في المساجد المنتشرة في المدينة، ولم يضاهها مدينة أخرى في عدد مساجدها، التي كانت بمثابة حق السلطان في الحكم بصفته “ظل الله على الأرض”، وما رافق هذه المساجد من أوقاف وتكايا ومدارس، لكن هذا الصنيع لم يَرُقْ لابنه بايزيد الثاني والذي كان حاكمًا ورعًا ومسالمًا، فاعتبر أن مستشاري أبيه من بطانة السوء وبسببهم خالف شرع الله، فباع معظم الصور والمنحوتات الإيطاليّة، كما وضع طلاءً فوق اللوحات الجصيّة الشهوانيّة في القصر، ومن مظاهر الاهتمام بالجانب الإسلامي أن مكانة المفتي صار لها قيمتها، فعُرف باسم شيخ الإسلام، وأضحى الرجل الثالث في الدولة بعد السلطان والصدر الأعظم، وهناك روايات تشير إلى تقدير “بايزيد” للمنصب، فكان يقف عند استقباله، ويجلس في مقعد أعلى من مقعده، وأخذت قيمة العلماء تتنامي فأصبحوا في عهد “بايزيد الثاني” طبقة من نبلاء الثوب، شبه الوراثيّة، متميزة عن نخبة السُّلطة ممثَّلة في الباب العالي، بيد أنها تُمارِس تأثيرًا كبيرًا في تصرفات المدينة نفسها وعاداتها.
ومثلما كانت المدينة مقدّسة عند المسلمين، كانت على السواء مقدّسة عند المسيحيين الأرثوذكس، وهو ما دفع فيليب ما نسيل (في كتابه: القسطنطينية المدينة التي اشتهاها العالم) يقول إن المدينة بوركت بفعل وفرة الآثار المقدسة على أراضيها، فقد احتوت “عباءة أم الرب والعباءة الأرجوانية والرمح والإسفنج والسهم [التي عرضت على السيد المسيح أثناء الصلب]، وهناك طاولة العشاء الأخير، وأبواب سفينة نوح، ورفات الحواري أندراوس . والأهم على أنها مدينة الرب أو مدينة الله”، ففي الوقت الذي كانت أوربا تُمارِسُ إبادات جماعيّة، وتشدّدًا وإكراهات انتهت بالطرد وإقصاء للمختلفين معهم دينيًّا “فالزنادقة يُحْرقون أحياء في لندن وبرلين، ويذبحون في باريس، وغيرها من أقليات عانت في ظلّ العنف الديني، في المقابل منحت الإمبراطورية العثمانيّة الحريّة الدينيّة للمسيحيين واليهود، وهو ما أكّده جورج المجري بقوله: “الأتراك لا يُكْرِهون أحدًا على ترْك دينه، ولا يحاولون إقناع أحد بذلك، وليست لديهم مواقف متشدّدة من المرتدين”، نفس الشيء ردّده المسيو دي لا موتراي بقوله “لم يكن ثمة بلد على وجه الأرض، تُمارَسُ فيه كلّ الأديان بالحريّة والرحابة التي تمارس بها في تركيا”، وما يُعزّز حالة السّماحة التي بدت عليها المدينة مع الديانات الأخرى، أن معظم التاريخ العثماني ظل سكان القسطنطينيّة المسلمين يتوازى عددهم مع المسيحيين، والفارق بينهما ليس كبيرًا، كما أنه لم يشهد أحد أن ثمة إكراهات مورست على إجبار غير المسلمين لدخول الدين الإسلامي.
ومع ما تمتعت به المدينة من صفات وخصائص جعلت الرحالة والكُتّاب والفنانين يتوافدون عليها، إلا أن الاستشراق اختزل رحابة المدينة وتعددها وصورها الباذخة في صورة -مع الأسف- قميئة، صورة متخيلة عن شرق غرائبي، وشهواني، وغامض، ومثير، وممتلئ بالجواري والحريم؛ أي محصورة في الحريم وسوق النخاسة، وقد اختزل الفنان الفرنسي جان أوغست دومينيك آنغر(1780 -1867) -عبر هذه النظرة النمطية للشرق (كما مثلته إسطنبول وبغداد في مخيلة الغرب)- المدينة في صورة “الحريم التركي”(1862)، واللوحة عبارة عن جمهرة من الوصيفات العاريات اللائي يكشفن عن جمالهن الفاتر على حافة حوض تحيط به جدران بدون نوافذ، وهي ذات الصورة النمطية التي تكررت أيضًا عند هنري ماتيس (1969- 1945) في وصف الجواري التركيات لوحة “الوصيفة ذات السروال الرمادي القصير”، على الرغم من أن الحقيقة تقول بأن الجواري لم يكنَّ سافرات داخل القصر بل كن يتجولن بسراويل طويلة لا تختلف عن سراويل الرجال، وقد شاهدهن “توماس دلام” وهو إنجليزي أوفد إلى القسطنطينية في مهمة خاصّة (تركيب الآلة الموسيقيّة)، وقد أتيح له رؤية الحريم وهن يلعبن الكرة، فانبهر بما رأى. وبالمثل كانت المواضيع التي استحوذت على أذهان المراقبين الغربيين الذين ترددوا على إسطنبول، فمارك توين في “الأبرياء في الخارج” (1869)، يتخيّل أن الصفحات الاقتصادية في الصحف الأمريكية الكبرى نشرت أسعار آخر المحاصيل من الفتيات الشركسيات والجورجيات وإحصاءات حيوية عنهنَّ”.
تكررت التيمة في الأدب الغربي الذي اعتنى بالمدينة وقدم صورة سلبيّة عنها؛ حيث ركز على: تكايا الدراويش والحرائق وجمال المقابر، والقصر وحريمه، والشحاذين ومجموعة الكلاب الضالة، وتحريم الخمر، وعزلة النساء، والجو الغامض في المدينة، هذه المعالم التي ركزوا عليها جعلت أندريه جيد يعلن كراهيته للمدينة، وشعبها، ويعبر عن سبب كرهه، أن الملابس التي يرتديها الأتراك تدل على بصمة عرقية واضحة، وفي نظره هي بشعة.
المدينة في المخيال الروائي
رافقت المدينة الأدباء الأتراك في كتابتهم، فتتبعوا تطوراتها ونشأة الإيديولوجيات بما فيها المتشدّدة، وما نشب عنها من صراعات فكريّة وصلت إلى صراعات دمويّة، وأيضًا ما مارسته المدينة من إكراهات على النازحين لها من الأطراف، فأوقف الروائي التركي أورهان كمال (1914 -1970)، بعض رواياته مثل رواياته “الكنّة” و”مفتّش المفتّشين” و”الأبله” على واقع إسطنبول الأرضي؛ فأظهر للعالم الأوضاع الاجتماعية التي كان يعيشها المجتمع التركي، وخاصّة الإسطنبولي، في تلك الفترة، في قالبٍ واقعي، فكتب عن الفقراء، والمسحوقين، والفلاّحين، والنساء. وهذه الصورة التي تكشف عن واقعية القاع، عبر عنها -كذلك- الروائي يحيى كمال (1884- 1958) قائلًا: “إن إسطنبول، التي تتمتع ببعض أجمل المناظر في العالم، تشبه مسرحًا هو أجمل ما يكون في الصالة، لكن الفقر المدمر، وأحيانًا الأحياء القذرة تملأ الأجنحة”، بالمثل عند أحمد حمدي طانبنار (1901-1962) خاصة في كتابه “خمس مدن: رحلة في تاريخ جغرافيا تركيا” (1946).
انحياز يحيى كمال وأحمد طانبنار إلى هذه الأحياء جاء كتأكيد لهوية إسطنبول التركية بعيدًا عن أفق أيا صوفيا الذي شغل الرحالة والكتاب، وكذلك بعيدًا عن فكرة التشويه ورسم صورة سوداوية للمدينة، بل على العكس تمامًا، فهذه الأحياء (في نظرهما) ظلت بكرًا لم تفسد ولم يمسسها الغرب، أي أنها صورة قومية للمدينة، فمع أنها “كانت خربة، وكانت فقيرة وبائسة”، لكنها “احتفظت بأسلوبها، وطريقتها الخاصة في الحياة”.
وهي التيمة التي اشتغل عليها الروائيون اللاحقون كتعزيز لأصالتها، ومن ثم راحت أليف شفق تبحث عن الهُويّة التركيّة، كما اشتغلت على التوليفة السّكانية (الإثنولوجيا البشرية) التي تتألف منها تركيا (أكراد / تُرك / أرمن،…) عبر تمثيلات واقتطاعات من حيوات لسكان مختلفين من قاطني المدينة الأصليين، أو النازحين من بقاع داخليّة أو أصقاع مختلفة، فجاءت روايتها «لقيطة إسطنبول» (2006)، لتقدّم صورة عن المجتمع التركيّ في صراعات هوياتيّة متعلّقة بالنسب والبحث عن الأصول، سواء عبر شخصية آسيا التي ولدت ولا تعرف هوية أبيها، أو آرمنوش الفتاة الأميركية من أصول أرمينية، والتي جاءت إلى المدينة / إسطنبول للبحث عن أصولها.
وإذا كانت أليف عبرت في “لقيطة إسطنبول” عن الوجه القاسي للمدينة، فإنها في رواية «الفتى المُتَيَّم والمُعلِّم» (2013) تتجاوز -في بنيتها العميقة- حكاية المعلِّم سنان وتلاميذه الأربعة، التي اتبنت الحكاية على أساسها، إلى حكاية تأسيس مدينة وكذلك التأريخ لسلطنة بعمارتها وممالكها، بكل ما تحمله كلمة مدينة من معاني الحداثة والكوزمبالتية (مسلمون ومسيحيون ويهود، ويونان وأرمن وجورجيون، وعرب وكرد ونساطرة وجراكسة وكازاخستانيون وتتار وألبان وبلغار ويونانيون…)، والعلم والمعرفة (إنشاء المرصد الفلكي، ووجود شخصية كالفلكي تقيّ الدين في حضرة السَّلطنة)، وأيضًا ما تحويه كلمة سلطنة من قصور وجوارٍ وقيان وخصي، وحروب وفتوحات ودسائس.
أبشع صورة للمدينة، بوصفها المدينة القاتلة، هي تلك التي جسدتها أليف شفق في رواية “10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب”(2019)، فطلت مدينة إسطنبول، ولكن بوجهها الخفي (القبيح) الذي لا تعلن عنه وزارة السياحة في برامجها؛ فيطل وجه المدينة القاهِرة والقاتلة في آن واحد، حيث الدعارة وتجارة الرقيق والمواخير، والأحلام الموءودة على أرصفة شوارعها، والآمال المدفونة في مقابر الغرباء.
وكذلك طلت المدينة القديمة وتحولاتها، سواء على المستوى الاجتماعي حيث كثرة اللاجئين والفارين إليها، وأيضًا على المستوى السياسي حيث الصراعات السياسية، وأشهرها ما حدث في أحداث آيار/ مايو 1977، وهو ما يعد إدانة كاملة لهذا التناحر.
لا يختلف أورهان باموق عن أليف شفق في استحضار المدينة؛ فتحضر بكل تناقضاتها، فعنده هي؛ المدينة المُسَالِمَة ومدينة الصِّرَاعات السّياسية والفتن والمؤامرات، والمدينة المَتاهة للغرباء، ومدينة الحُلم والأمل للقادمين من الأناضول والجنوب، وأيضًا المَدينة اللَّعْنة بقهرها لأحلام البُسطاء.
إسطنبول ليست مجرد مدينة في كتابات باموق، بل هي صورة مُصغرة لتركيا بكل وجوهها، وعبرها يرصد مستقبل تركيا، وهو يحفر في تعرجات وأخاديد ماضيها، وكأنه يسعى إلى إعادة اكتشافها عبر مروياته التي تضرب أحيانًا في التاريخ، وكأنها ذاكرة بديلة عن المكان القديم؛ فقدّم مجموعة من الروايات معظمهما دارت في إسطنبول المدينة القديمة، راصدًا لتحولاتها السياسيّة والاجتماعيّة والثقافية، وصراع الإنسان لمواجهة قدره، فجاءت روايات “جودت بك وأبناؤه” (1982)، و”البيت الصامت ” (1983)”القلعة البيضاء” (1991)، و”اسمي أحمر” (1998) “ومتحف البراءة” (2008)”، و”غرابة في عقلي” (2014)، وبالمثل تحضر صراعات المدينة السياسية في رواية «المرأة ذات الشعر الأحمر» 2016.
كانت إسطنبول شاهدًا على حركة التغييرات التي مرت بها تركيا، بدءًا من انحلال الدولة العثمانية بعد سقوط الرجل المريض، إلى الحقبة الأتاتوركية، وما شهدته من تغيير الهويّة الإسلاميّة إلى نقيضها العلمانيّة / الغربيّة، وكانت مدينة إسطنبول هي شاهده ومعمل تجاربه على حالة الصراع أو الصخب التي وصلت إلى العنف من أجل التغيير، وإن كان نقله إلى مدينة أخرى هي “قارص” كما في رواية “ثلج” (2002)، ورغم أن أحداث الرواية تدور في مدينة غير إسطنبول إلا أن أصداء ما حدث في المدينة من صراعات إيديولوجية بين القوميين والإسلاميين واليساريين، كان نتيجة لحالة التفاعل مع الصراعات التي تشتبك في المدينة الكبيرة، وما كانت المدينة الصغيرة البعيدة الأطراف إلا تمثيلًا لصراعات المركز، في تأكيد على أن كرة اللهب تفاقمت وعلى وشك أن تحرق الجميع، لا فرق بين المركز والأطراف.
وبالمثل تشكّل المدينة حضورًا مائزًا في سيرته الذاتيّة “إسطنبول: الذكريات المدينة ” (2003)، التي تقاطع فيها التاريخ القديم لتركيا بالحديث، وتناول فيها ذكرياته في المدينة التي ارتبط بها حتى صارت قدره حسب قوله “إن قدر إسطنبول قدري وأنا مرتبط بهذه المدينة لأنها جعلتني ما أنا عليه”، وكذلك يسرد في أسلوب عذب عن انعكاسات ثقافة المدينة وكوزوموباليتانيتها على وعيه وتشكيله، بل قدّم -بطريقة غير متعمدة- صورة عن المدينة الفنيّة، وجمالها الباذخ، بأماكنها الخلّابة، وبعشقها للفنون، الذي انعكس في اللّوحات الفنيّة، عبر عرضه لمجموعة صور عن المدينة وشوارعها وأحيائها بتصويره الشخصي، أو بتصوير أتراك وغربيين، فكان الكتاب قبل أن يكون سيرة مجتزأة عن حياة الحائز على نوبل، سيرة فنية للمدينة، وفي نفس الوقت مرثية للإمبراطورية المنهارة، ويكتب عن الحزن الذي تغلغل في ثقافة المدينة وشعرها، وحياتها اليومية وموسيقاها، وقد أرجع هذا بنبرة مِن التأسّي والحزن إلى الرؤية الصوفية وما تراه من إجلال لهذه النبرة السوداوية، وهو ما انعكس على ملامح المدينة.
الخلاصة، ليست إسطنبول مدينة زائرها ينسى تفاصيلها وتأثيراتها بمجرد مغادرتها، بل ترتبط هي بالروح، ويمكن وصفها بأنها مدينة الألف وجه، أو الوجوه المتعددة تبعًا لنظرة زائرها، وماذا يريد أن يرى، فلن تخذله أبدًا، فستكون كما اشتهاها ورغب فيها، ذاك هو سر إسطنبول التي اشتهاها العالم!
ــــــــــــــــــ
اعتمدت مادة المقالة على:
- ابن بطوطة :”تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار” أو “رحلة ابن بطوطة”، قدم له وحققه: الشيخ محمد عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم، بيروت، ط 2، 1992.
- إدوارد سعيد: “الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق”، ترجمة محمد عناني، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 2008.
- أورهان باموق: “إسطنبول: الذكريات والمدينة”، ترجمة أماني توما، وعبد المقصود عبد الكريم، سلسلة الجوائز، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2007.
- فاطمة المرنيسي: “شهرزاد ترحل إلى الغرب”، ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل، المركز الثقافي العربي، نشر الفنك، د.ت.
- فيليب مانسيل: “القسطنطينية المدينة التي اشتهاها العالم (1453- 1924)”، ترجمة مصطفى محمد قاسم، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، جزآن، يوليو – أغسطس 2015.
- بالإضافة إلى الأعمال الروائية لـ: أليف شفق، وأورهان باموق، أورهان كمال، ويحيى كمال، وأحمد حمدي طانبنار.
** المصدر: مجلة “الجسرة الثقافية”. العدد: 63