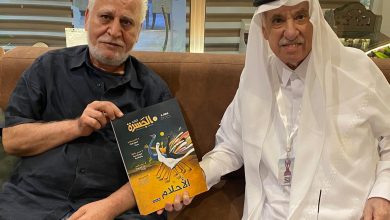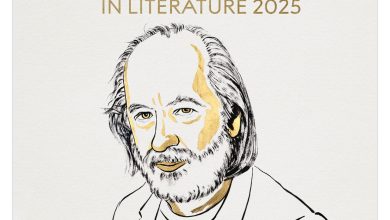أفكار “ابن خلدون” .. ابتكار .. وتناقضات وضعف أيضًا

الجسرة الثقافية الالكترونية
*جهاد فاضل
لم يستأثر جيلٌ واحدٌ من الأكاديميين العرب المعاصرين بدراسة ابن خلدون بل توزّع الاهتمام به على أجيال عدّة. فهو على الدوام على لائحة الباحثين والدارسين العرب، المشارقة منهم والمغاربة، والمغاربة بشكل خاصّ، ربما لإحساس هؤلاء بأن ابن خلدون منهم.. ولكن ابن خلدون في الواقع ظفر باهتمام المشارقة كما ظفر باهتمام بالمغاربة. ولعل الأولين هم من افتتح عالم دارسيه عندما قدّم طالب مصري درس في السوربون قبل مائة سنة تقريبًا من اليوم أطروحة دكتوراه عنه، اسم هذا الطالب طه حسين، وهو من مصر، وقد طبقت شهرته الآفاق فيما بعد، كما يقولون.
تلك كانت شرارة اهتمام المشارقة به إذا اعتُبرت مصر مشرقًا، ولكنْ في ذلك أقوال مختلفة. وكان من دارسيه المشارقة الأوائل أيضًا العلاّمة ساطع الحصري (أبو خلدون) الذي أصدر كتابًا ضخمًا عنه حاول تبرئة ابن خلدون فيه من تهمة التحامل على العرب، معتبرًا أن ابن خلدون قصد «بالعرب» في «مقدمته» لا العرب بالمعنى المعروف للكلمة، بل البدو سكان الصحراء، أو الأعراب بلغة القرآن والإسلام الأول. وأيًا كان مبلغ التوفيق في فرضية الحصري هذه، إذ الكثيرون لم يقتنعوا بها، فإن اهتمام المشارقة بابن خلدون قد تتابع واستمر بعد ذلك وإلى اليوم. فمن الذين قدّموا عنه أطروحات جامعية عنه الدكتور ناصيف نصار عميد كلية الآداب في الجامعة اللبنانية سابقًا. ومن الذين درسوه في مصر الدكتور لويس عوض.
أما المغاربة فالاهتمام بصاحب «المقدمة» عندهم مستمر بلا انقطاع فلا يكاد ينتهي مؤتمر عن ابن خلدون في تونس، حتى يبدأ مؤتمر آخر عنه، سواء في تونس أو في الجزائر أو في المغرب الأقصى. والمعروف أن ابن خلدون حضرمي الأصل في الأساس، ولكنه أقام في الأندلس حينًا، وفي بلدان المغرب الثلاثة حينًا آخر. وقد عاش فترة من حياته في دمشق ومشهورة مقابلته فيها مع الغازي تيمورلنك، كما عاش فترة أخرى في القاهرة، فهو إذن «قومي عربي» وإن تحامل على العرب على النحو الذي سنبيّنه لاحقًا.
ويبدو أن أحكامًا كثيرة سابقة حول ابن خلدون تهاترت، وحلّت محلّها أحكام أخرى، حتى تنهض نظريات وتحليلات أخرى تلغي ما سبق من أحكام أو تعدّلها. وهذا ما يستنتجه قارئ كتاب “أعمال الندوة الدولية”، عنه الذي يعرض لما كان سائدًا ولما يسود اليوم حوله. ويضع الذين أعدوا أعمال هذه الندوة للطبع عنوانًا فرعيًا هو «راهنية ابن خلدون» وهذا يعني أنه بنظرهم ليس مجرد «شخصية تراثية» أو شخصية من التراث العربي الإسلامي، انقضى أمرها وباتت جزءًا من الماضي، وإنما هو شخصية فكرية راهنة، بمعنى أن فكرها ما زال يلبّي مطالب الحاضر ويمكن أن نستفيد منه راهنًا. وإذا كان في ذلك من الآمال أكثر مما فيه من الحقيقة أو الواقع، فإن ابن خلدون مازال يجذب الكثيرين إلى اليوم ويقدم لهم رؤى ووعودًا كثيرة.
في الندوة التي عُقدت في صفاقس بتونس بهمة أساتذة علم الاجتماع التونسيين، واجه ابن خلدون أصنافًا عدّة من الباحثين المسلحين بمناهج وطرائق بحث حديثة. هناك من انحاز إليه، ولكن هناك من اعتبر أن «مقدمته» تتضمن نواقص وسلبيات كثيرة، واعتبر بعضهم أن لا مكان الآن للدعاوى العريضة التي تنسب لابن خلدون أنه مؤسس علم الاجتماع والعمران البشري، وأنه مؤسس علم السياسة وفلسفة الحكم، وصاحب النظريات في التربية، كما لا مكان على الإطلاق لما ذهب إليه البعض من أنه واضع علم الجباية والدراسات المالية، والحال أنه يصرّح بكثير من الوضوح أنه اقتبس أكثر النظريات والمقولات التي أودعها في مقدمته من أقوال السابقين ولم يبتكرها ابتداءً.
طبعًا لا يستطيع أحد أن يُنكر أن ابن خلدون يمثل منعرجًا هامًا في تاريخ الثقافة العربية، وأنه كان قمة عصره، لكن من المبالغة برأي الدكتور عبدالجليل الميساوي، وهو باحث تونسي في الحضارة الإسلامية، اعتباره قمة الثقافة العربية، إذ لا قمة في العلم والمعرفة لأن التاريخ يمشي إلى الإمام ولم يتوقف بعد حتى نعرف قممه ومنخفضاته.
ولكن لم يشك كثيرون في الندوة بأن مقدمة ابن خلدون كانت أول محاولة جادة في الثقافة العربية للتمييز بين رواية التاريخ وتفسير التاريخ. ولا شك أن الاهتداء إلى هذا المبدأ وإدراك ما للتاريخ من ظاهر وباطن هو في حد ذاته إبداع فكري ومنهجي عظيم، وفيه تلميح نقدي طريف مضمونه أن المؤرخين العرب إلى حد عصره اكتفوا برواية الأخبار والوقوف عند ظواهر الأحداث، وأن الوقت قد حان لتعديل هذا المنهج واستبداله بمنهج يزاوج بين «الرواية» و«الدراية» ويولي عناية أكثر لتفهّم العلل والدوافع والأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الظواهر ووقوع الأحداث المخبر عنها، بحيث يكون للتاريخ منطق يسير وفقه يسمح للباحث والقارئ بنقد الأخبار وغربلة المرويات، بل ويسمح بتوقع ما لم يحدث بعدُ إذا توفرت أسبابه.
وقد يكون ابن خلدون أول من وسّع مفهوم التاريخ فلم يعد التاريخ عنده مجرد إخبار عن الدول والقرون الأُول، وإنما صار هناك تاريخ عام للأمم والمدن والملوك، وتاريخ خاص للعلوم والفنون والصنائع، وتاريخ للعقائد والأديان.
وذلك ما جعله يجمع في مقدمته مبادئ كل المعارف والعلوم رغبة منه في توفير الآليات الأساسية التي يحتاجها المؤرخ لأي موضوع أو فن أو صناعة أو غير ذلك.
ومن أروع إبداعاته تأسيسه فكرًا نقديًا علميًا قوامه الموضوعية والتجربة كانت المدونة الثقافية العربية حتى عصره تفتقر إليه. فقد أكّد أن الكذب من الظواهر الملازمة للأخبار والروايات التاريخية، ومن ثم وضع جملة من الآليات التي يمكن اعتمادها في نقد الخبر.
ولكي يكون الباحث موضوعيًا في تعامله مع ابن خلدون من خلال كتابه «المقدمة» فلا يتحامل عليه ولا يظلمه ولا يبالغ في تضخيمه فينسب إليه ما ليس له، يتعين عليه أن يتفهم طبيعة الكتاب أولًا، وأن يميّز ثانيًا في مضامين هذا الكتاب بين ما هو من مقاصد الكتاب ومطالبه، وبين ما أورده الكاتب عرضًا باعتباره من الوسائل التي لا بد منها لخدمة الموضوع الرئيس للكتاب.
أما طبيعة كتاب ابن خلدون، أي المقدمة، فهو بالأساس كتاب تعريفات وتصنيف للعلوم عالج ابن خلدون ٢٥٩ موضوعًا بعضها يمثل علومًا ذات خصوصية متميزة، وبعضها فروع من علوم ومن غير المعقول الادعاء بأنه كان متمكنًا من كل تلك العلوم تمكن العلماء المؤسسين، وإنما الحقيقة أنه عانق الإبداع في بعضها وغلبت عليه الضحالة والسطحية في بعضها الآخر، كما هو حاله في المباحث المتعلقة بالجغرافيا أو المتعلقة بالتنجيم وعلوم الطلسمات وإدراك الغيب التي بلغ فيها حد الخبط والخلط.
ولكن مع ذلك ورغم ذلك فإن مقدمة ابن خلدون تبقى أجمع دائرة معارف عرفتها الثقافة العربية حتى اليوم، وقد وفرت لكل طالب علم الحد الأدنى من المراجع التي لا يمكنه الاستغناء عنها.
وهكذا فإنه لا يمكن الحكم على ابن خلدون إلا بعد قراءة «المقدمة» وتعرّف مضامينها فصلًا فصلًا ومبحثًا مبحثًا، حيث يمكننا الوقوف على جملة من الإبداعات التي لا تخلو من روعة، وعلى جملة من النقائض والتناقضات التي لا يعرو عنها جهد بشري، خصوصًا في عمل ضخم مثل هذا الذي نهض به ابن خلدون.
أول إبداعاته جهاز مفاهيمي مبتكر، كان لابن خلدون سبق على غاية الأهمية يتمثل في ذلك الجهاز المفاهيمي المبتكر وذلك السجل الكلامي المتميز إلى جانب تلك المقولات الدسمة التي يرتقي بعضها إلى مستوى النظريات والتي منها: «الإنسان مدني بالطبع» و«العدل أساس العمران»، و«الظلم مؤذن بخراب العمران» و«التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية» و«الدولة دون عمران لا تتصوّر والعمران دون الدولة والملك متعذر» و«العوائد منزّلة منزلة طبيعية أخرى»، و«العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره» و«قِدم الاصطلاح لا يصيّره حجة»، و«الصنائع لا بد لها من العلم”، و«الشدّة على المتعلمين مضرة بهم”، و«إن القليل في الكثير كثير».
ولكن هذه المقولات لا ترتقي بصاحبها إلى مستوى الفيلسوف أو العالم المؤسس لعلم الاجتماع والعمران البشري كما يزعم البعض، لأن العلم والفلسفة كليهما تساؤل مستمر لا يكتفي أي منهما بالمسلمات التقديرية. فما اكتشف العالم أو الفيلسوف حقيقة أو لاحظ ظاهرة إلا دفعته إلى طرح جملة من التساؤلات وحملته على وضع العديد من الفرضيات واقتراح عدد من الإجابات وذلك ما لم يفعل ابن خلدون شيئًا منه. فقد كان يقرر فقط، وفي أفضل الأحوال يحاول البرهنة وإقامة الدليل على صحة وجهة نظره، ومن ثم فهو لم يتجاوز في جميع مقولاته دور الواعظ والموجّه الناصح.
ثانيًا: إن ابن خلدون رأى أن من أسباب الغلط في رواية الأخبار هو الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل العصور ومرور الأيام.
وقد عبّر عن هذا الموقف في هجوم عنيف على المتأخرين من أجيال الرواة ضمنه في تصدير كتابه فقال: « ولم يأتِ بعد هؤلاء (فحول الرواة والمؤرخين) إلا مقلد بليد الطبع والعقل، أو متبلد ينسج على ذلك المنوال ويحتذي منه بالمثال ويذهل عما أحالته الأيام من الأحوال واستبدلته من عوائد الأمم والأجيال.
يكرّرون في موضوعاتهم الأخبار المتداولة بأعيانها تباعًا لمن عُني من المتقدمين بشأنها ويغفلون أمر الأجيال الناشئة في ديوانها بما أعوز عليهم من ترجمانها فنستعجم صحفهم على بيانها».
وليس هذا حال المؤرخين وحدهم وإنما هو حال المفسرين ورواة الحديث والسير وناقلي المقالات العقدية والمذاهب الفقهية.
وهو يدعو إلى عزل العقل كليةً في الأمور المتعلقة بالعقيدة والشريعة من ذلك قوله: «فإذا هدانا الشارع إلى مَدرك فينبغي أن نقدّمه على مداركنا ونثق به دونها، ولا ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه بل ونعزل العقل عنه». وهو ما أثار غضب بعض الباحثين عليه في الندوة.
وقد يكون من الإبداعات التي لم يسبق ابن خلدون إليها تمييزه بين الحقيقة الإنسانية الثابتة المشتركة بين جميع البشر، وبين المضاف الاجتماعي والثقافي والحضاري الذي يتفاضل فيه الناس واعتباره الحقيقة الإنسانية قيمة يتساوى فيها جميع البشر مساواة لا تتأثر بفوارق الغنى والفقر والذكاء والغباء والحضارة والبداوة. فتلك جميعها مكتسبات زائدة عن الحقيقة الإنسانية للأفراد والشعوب قد تساهم في تحسين الطباع وتهذيب الأذواق أو إفسادها. ولكنها لا تكون مدعاة للتفاوت في الإنسانية.
على أن من طريق اللمعات العارضة في «المقدمة» وفي مقدمة الحقائق التي لم تفته الإشارة إليها تأكيده قدرة الإنسان العربي على الإبداع وعلى العطاء الفكري والعلمي وأنه قادر على الابتكار والاختراع وعلى إنجاز الأعمال الكبيرة والمساهمة الفاعلة في صنع التاريخ وبناء الحضارة. وقد سجل ذلك في سياق حديثه عن العلم الذي استحدثه.
إلى جانب هذا الموقف النبيل يسيء كثيرًا إلى الأمة العربية والإنسان العربي إساءات ترتقي إلى مستوى التحامل، أو هو على الأقل كان سببًا في الإساءة إليهما باستمرار بسبب تعمدّه استعمال مصطلح «العرب» بدل مصطلح «البدو» فاستغلّ المغرضون والمتحاملون هذا الاستخدام لترويج جملة من المقولات المسيئة إلى الإنسان العربي والأمة العربية تلك المقولات التي تزايد تداولها في ظل الانقسامات العربية.
والغريب أنه يشرّع القهر والاستبداد إذ لا يكاد يتصوّر الملك بمعزل من القهر والاستبداد. من ذلك قوله: «سياسة الملك والسلطان تقتضي: أن يكون السائس وازعًا بالقهر وإلا لم تستقم سياسته»!.
إنه يقرّ بأن القهر هو الأصل في الحكم والسياسة متجاوزًا بذلك دعوة القرآن القادة والزعماء إلى اللين والرفق في قوله للنبي القائد: «لو كنت فظًا غليظ القلب لانفضّوا من حولك».
ولا يقف ابن خلدون عند هذا الحد، بل يقول في مكان آخر من كتابه: «إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع وذلك لأنهم أقدر على التغلب والاستبداد واستعباد الطوائف لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم ولأنهم يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم».
إنه كلام لا يعدو وصفًا للموجود السائد، وتقريرًا لما هو شائع ومعروف من النظم البدائية وشبه البدائية لا يحمل أي نقد أو تحليل، ولا يتضمن أي تصور لشيء من التطوير والتحسين، إضافة إلى ما فيه من إضفاء للشرعية على القوة والعنف. ويزداد الأمر خطورة وتعقيدًا حين يكشف ابن خلدون أن لديه تصورًا آخر للحكم والسياسة لا قهر فيها ولا استبداد.
ولكنه يمسك عن شرحه ويضنّ بالحديث عنه، فلا يقول فيه أية كلمة، ويتعمد إبقاءه في طي الكتمان والغموض. ويدرك الباحث الناقد ذلك من قوله: «التغلب هو الملك وهو أمر زائد عن الرئاسة لأن الرئاسة إنما هي سؤدد وصاحبها متبوع وليس له عليهم قهر في أحكامه، وأما الملك فهو التغلّب والحكم بالقهر»!.
وهكذا يبدو الفكر الخلدوني الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فكرًا لا يخلو من لمعات مضيئة ومقولات مكتنزة عميقة ومنهجية دقيقة ومبتكرة ولكنه في الوقت نفسه لا يخلو في تناقضات مخلّة ونقاط ضعف مثيرة للتساؤل والاستغراب. ويبدو على ضوء مداخلات هذه الندوة أن ما أنجز حول هذا الفكر من دراسات كانت في جلّها دراسات انتقائية سلكت في التعامل معه مسلك التنويه والتمجيد، الأمر الذي جعل المقدمة حتى اليوم أقرب إلى المادة الخام لم تُدرس دراسة نقدية ولم تُحلّل تحليلًا موضوعيًا يسمح بتحديد ما فيها من نقاط الضعف ومواطن القوة ويكشف عما تجاوزه الزمن منها.
وقد أثار الباحث عبد الحميد الفهري جوانب أخرى في ابن خلدون.
فابن خلدون صوّر العرب في بداوة لم يكن معها من الممكن أن يفهموا السفانة والملاحة وركوب البحر. فهو يقول: «وإن العرب كانوا لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرة في ثقافته وركوبه والروم والفرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم في التقلب على أعواده مرنوا عليه وأحكموا الدربة بثقافته».
وهو يعتبر أن دخول الأعاجم الإسلام كان وراء معرفة العرب البحر وإتقان ركوبه: «فلما استقّر الملك للعرب وشمخ سلطانهم وصارت أمم العجم خولاً لهم وتحت أيديهم وتقرّب كل ذي صنعة إليهم بمبلغ صناعته واستخدموا من النواتية في حاجياتهم البحرية وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته واستحدثوا بصراء بها فشرهوا في الجهاد فيه وأنشأوا السفن فيه والشواني وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح».
هذا رأي اعتبره الفهري البوابة التي ولج منها المستشرقون والغربيون عامة ليرتبوا العرب في أدنى سلّم الحضارات البحرية وآخرها. ولكن إزاء ضعف ردود العرب في الدفاع عن حضارتهم البحرية، جاء الجواب من الباحثة السوفييتية نينافكتورفنا بيغوليفسكيا في كتابها:
(العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع إلى القرن السادس الميلادي) التي اكتشفت مصادر أخفاها المؤرخون اللاتينيون عن الباحثين، وهي كافية لتقيم الدليل على عراقة الأسطول العربي في اليمن وعُمان والبحر الأحمر.
بل إن هذه الباحثة السوفييتية تقدّم وثيقة تبيّن انتصار عرب ممالك كندة وحمير في أشواط عديدة على الأسطول البيزنطي وإخراجه من العقبة قرنين قبل الإسلام.
ابن خلدون اسم كبير ولكن هذا الأسم كثيرًا ما يقع في الخطأ على النحو الذي رأيناه والذي سنرى في حلقة ثانية عنه في عدد قادم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الراية