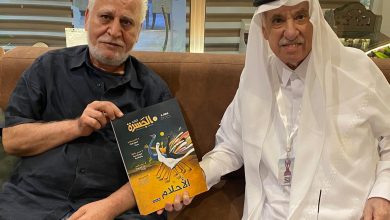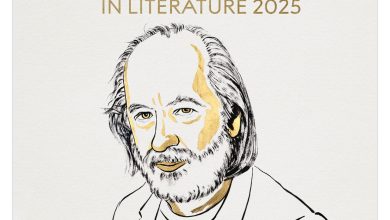شوقي وعبد الوهاب .. علاقة فريدة في تاريخ الشعر والطرب

الجسرة الثقافية الالكترونية
*جهاد فاضل
المصدر:الراية
تعيد مصر الاهتمام بمسرحية «مجنون ليلى» لأمير الشعراء أحمد شوقي التي كان أمير المُغنين محمد عبدالوهاب قد لحّن بعضًا من نصوصها في حياة شوقي وبعد رحيله. في أكثر من حديث أو مقابلة مرئيّة صرّح عبدالوهاب أنه كان ينوي تلحين مسرحية «مجنون ليلى» لشوقي كاملة وعرضها على المسرح لتكون مشروعه الخالد الكبير. كان يؤكد أن أجزاء كبيرة منها قد لحنها، ولكنه غادر هذه الدنيا ولم يترك لنا إلا أربعة مقاطع منها هي ما أنجزه وغناه فعلاً. بعض العاملين في الحقل الغنائي في مصر يؤكدون أن عبدالوهاب ترك بين أوراقه الخاصة ألحانًا لقطع أخرى من المسرحية لم يُغنّها لا هو ولا سواه. الأعمال التي غنّاها عبدالوهاب من هذه المسرحية هي:
– جبل التوباد التي تمنّت أم كلثوم مرة على عبدالوهاب أن يأذن لها بغنائها، فكان جوابه: «الله الله يا ست! ده شرف كبير».. ولم تتحقق أمنية كوكب الشرق.
– تلفتتْ ظبيةُ الوادي فقلتُ لها
لا اللحظُ فاتكِ من ليلى ولا الجيد
سجا الليل / وهو مونولوج يترنم به قيس حول خباء ومضارب ليلى، وهو في المسرحية قبل لقائه بليلى ملتمسًا منها قبسًا من النار. ولكن عبدالوهاب جعله خاتمة لواقعة طرده من قبل المهدي بعد أن فطن لحجته، الواهية في طلب الحطب والنار.
– الديالوج الخاص بين قيس وليلى الذي كثرت فيه التقاطعات الصوتية واختلفت خلاله الحالات بين الرفض والسخط والنشوة والرضا والغضب والحب. وفي كل هذه الحالات يجيد عبدالوهاب التعبير دراميًا بالموسيقى.
حديث شوقي وعبدالوهاب ومجنون ليلى وبقية شعر شوقي الذي غنّاه المغنّون الكبار في العصر الذهبي للغناء في مصر، يعود إليه الباحث المصري أحمد عنتر مصطفى في كتاب حديث له صادر عن المجلس الأعلى للثقافة، وفي هذا الحديث يحتل عبدالوهاب، وهو المطرب الذي قرّبه شوقي منه أكثر مما قرّب سواه، مكانة مميزة. هذا مع الإشارة كما يقول الباحث إلى أن شوقي لم يكتب في عبدالوهاب شعرًا كالذي كتبه في كبار المطربين السابقين أو كالذي كتبه في أم كلثوم، ولكنه اكتفى بالإشارة إليه في عدد من القصائد.
ولكن عبدالوهاب يروي أن أمير الشعراء كثيرًا ما كان يقول له إنه يقصده تمامًا في هذا البيت، أو في هذا المعنى، وقد قال مرةً له إنه استوحى منه هذا البيت في «مصرع كليوباترا».
وأُذْنُ المغنّي تحسُّ النسيمَ
وتسمعُ في الكأسِ همسَ الحبب
وإن هذا البيت نتيجة تأمل شوقي لعبد الوهاب المُنصت الصامت المستغرق في الاستيعاب.
ولكن الباحث يعود في صفحات أخرى من كتابه، وبعد أن ينشر إحدى القصائد الشوقية التي يغنيها عبدالوهاب ومطلعها:
يا شراعًا وراء دجلة يجري
في دموعي تجنبتك العوادي
ليؤكد «أن هذا النص لم يكتبه شوقي ليغنيه عبدالوهاب أمام الملك فيصل الأول ملك العراق، بل إنه النص الوحيد الذي كتبه شوقي «في» عبدالوهاب. ذلك أن أمير الشعراء تألم لفراق عبدالوهاب وسفره إلى بغداد خصوصًا أن عبدالوهاب النحيل كان يشكو آنذاك علة في إحدى رئتيه.
كتب شوقي هذا النص في وداع مطربه وربيبه المسافر، ودعا له أن «تتجنبه العوادي» وقد جرى شراعه في دموعه التي امتزجت بماء دجلة. وقد جرفت مشاعر شوقي الحارة شاعرنا بعيدًا فلم يلتفت إلى الملك فيصل – على غير عادة شوقي – إلا في البيت الأخير من النص.
ولكن شوقي تغنى بعبد الوهاب نثرًا ليلة زفاف علي شوقي، نجل شوقي، قبل أن يتغنى عبد الوهاب «بطقطوقة» تقول:
دار البشاير مجلسنا
وليل زفافك مؤنسنا
إن شا الله تفرح يا عريسنا
وإن شا الله دايما نفرح بيك..
أما «المنثورة» الشوقية في عبد الوهاب فتقول:
«غرّدْ يا عبد الوهاب! غرّد يا كناري الوادي واصدح يا هزار الوادي واحدُ الركاب وهزّها يا حادي..
أهذا يا بلبل الوادي تغريد، أم هذا وسواس الحلى على الخرّد الغيد غّنِ من الكبد آنًا ومن القلب أحياناً وقل عاطفة ووجدانًا.
آمنتُ ببيان الحناجر وباللحن الساحر والعصب الشاعر وشهدتُ أن وتراً يخلقه الله ويشدّ به اللسان إلى اللهاة لا يصنع له مثيلاً وإن ألفيتهم صنعوا جليلاً وسمّوا صنعهم فناً جميلاً.
وقد وهب الله لك عبدَ الوهاب أندى الحناجر، وخلق لها ألين الأوتار، وخلق منها أرخم الأصوات، وولاّك على الصوت تنشره وتطويه، وتُميته ثم تحييه، وتقلبه وتنظر فيه، كأنما صوتك في يدك وكلُّ مُغَنِّ صوته في فيه».
كان ذلك ليلة الاثنين أول يونيو ١٩٢٥ كما نشرت «الكشكول».
أما اللقاء الأول بين أمير الشعراء وأمير المغنين فكان عام ١٩١٥ ولم يكن سارّاً للفتى المطرب النحيل الذي كان يعمل مع فرقة عبدالرحمن رشدي.
وعندما صعد المسرح للغناء أثار ضعفه ونحوله وصغر سنّه عاطفة شوقي الذي كان يحضر العرض فطلب من «رسل باشا» حكمدار القاهرة أن يُصدر أمرًا بمنع السهر والعمل ليلاً للصغار والفتيان. وقد ترك هذا الحادث جرحًا مؤلمًا في روح عبدالوهاب الطموح والفقير إلى ذلك الدخل الذي كان يتقاضاه نظير غنائه وظهوره على المسرح.
وفي عام ١٩٢٤ الذي اعتبره عبدالوهاب بعد ذلك أسعد أعوام حياته، التقيا مرة أخرى. كان عبدالوهاب هذه المرة شابًا تجاوز العشرين. فقد شاءت الأقدار أن يستمع إليه في حفل أقامه نادي الموسيقى الشرقي بفندق سان ستيفانو بالإسكندرية، وغنّى عبدالوهاب من أدوار محمد عثمان: «جدّدي يا نفس حظك» و«ملا الكاسات». وفي هذه المرة حاز إعجاب شوقي فاستدعاه إلى مقصورته وطلب إليه أن يتردد عليه في القاهرة، وبدأت تلك الرفقة الخالدة التي دامت ثماني سنوات وانتهت برحيل شوقي سنة ١٩٣٣.
إنه قدر العباقرة والفن، وهو نفس القدر الذي جمع أم كلثوم برياض السنباطي في أحد الأعوام الأولى من عشرينيات القرن الماضي على محطة قطار الدلتا، وكان كلاهما صغيرًا في صحبة والده الذي يتكسب من إحياء ليالي الموسرين بالإنشاد الديني والغناء، ثم افترقا.. ليلتقيا بالقاهرة سنة ١٩٣٦ وكل منهما قد عرف طريقه، وشاء القدر أن يبدآ معًا منذ لقائهما الثاني الذي بدأ بـ«على بلد المحبوب ودّيني» رحلة جزيلة العطاء من الفن الرفيع.
لم تقف العلاقة بين شوقي وعبدالوهاب عند الإعجاب والصداقة بل تجاوزتهما إلى الرعاية الشاملة والتبني. فقد أخذ شوقي على عاتقه مهمة تثقيف صوت عبدالوهاب وتوجيهه. وظلّ عبدالوهاب في معية أمير الشعراء منذ ذلك اليوم إلى آخر يوم في حياته. حتى إنه أعدّ غرفة خاصة له في كرمة ابن هانىء بالجيزة أطلق عليها اسم «عش البلبل.
يدين عبدالوهاب لشوقي بمآثر كثيرة، وقد ذكر عبدالوهاب في أحاديثه ولقاءاته الكثير منها. لعل أهمّها أنه أخذ عن شوقي اهتمامه بتجويد فنه ودقته في ذلك، واحترامه لإبداعه والإخلاص له وتقديمه على أولويات الحياة. وكذلك إحساسه بالكلمة والإلمام بأبعاد معانيها فضلاً عن تنمية تذوّقه للفنون والآداب ومنها الرسم. وقد صحبه لزيارة لمتحف اللوفر بباريس عام ١٩٢٧ وفتح عينيه هناك على الأوبرا والموسيقى العالمية. «لقد فتح شوقي مسام عبدالوهاب على العلم والحضارة» على حد تعبيره.
وعرف عبدالوهاب عن طريق شوقي عشرات الشخصيات النابغة والفاعلة في تاريخ مصر والوطن العربي في شتى مناحي الفكر والفن والأدب والسياسة، فتعرف إلى سعد زغلول وأحمد لطفي السيد وطه حسين وإسماعيل صدقي وغيرهم. يقول عبدالوهاب: «فتح القدر لي عن طريق شوقي مدارس لم يوفق إليها أحد». كما أرسله شوقي، نيابة عنه وتلبية لدعوة تلقاها، إلى الملك فيصل الأول ملك العراق عام ١٩٣١، وكان شوقي وعبدالوهاب التقيا الملك على السفينة خلال عودتهما من باريس عام ١٩٢٧، وقد نظم شوقي قصيدته الخالدة «يا شراعاً» ليغنيها عبدالوهاب في زيارته تلك لبغداد.
«يا شراعاً.. التي قلنا إنها عبارة عن قصيدة غزل قالها أمير الشعراء «في» عبدالوهاب تعتبر من أجمل ما صدح به موسيقار الجيل، ونصها كالآتي:
يا شراعًا وراء دجلة يجري
في دموعي تجنبتك العوادي
سرْ على الماء كالمسيح رويدًا
واجرِ في اليمّ كالشعاع الهادي
وأتِ قاعًا كرفرف الخلد طيبًا
أو كفردوسه بشاشة وادِ
قفْ تمّهلْ وخذْ أمانًا لتلبي
من عيون المها وراء السوادِ
والنواسي والندامى أمنهم
سامر يملأ الدجى أو نادِ
خطرت فوقه المهارة تعدو
في غبار الآباء والأجدادِ
أمة تنشئ الحياة وتبني
كبناء الأبوّة الأمجادِ
تحت تاج من القرابة والملكِ
على فرق أريحي جوادِ
ملك الشط والفراتين والبطحاء
أعظمْ بفيصلٍ والبلادِ!
هناك أثران مهمان خلفتهما تلك العلاقة الحميمة بين شوقي وعبدالوهاب:
– الأول أن عبدالوهاب انتهج أسلوبًا معتدلاً في حياته الشخصية كما كان يفعل شوقي، بعكس ما كان يفعله فنانون آخرون عباقرة مثل سيد درويش الذي قيل إن تعاطيه المخدرات هو الذي أدّى إلى موته مبكرًا.
– الثاني إن عبدالوهاب لم ينضمّ في حياته إلى حزب سياسي، مثل شوقي الذي كان بحكم ارستقراطيته يميل إلى «الأحرار الدستوريين» ولم ينضمّ إلى الحزب، بل ظلت علاقاته بأقطاب الأحزاب كالوفد وسواه قائمة ومتصلة.
كذلك لم يعلن عبدالوهاب تأييده لحزب أو لعهد معين، بل أبدع في ظل كل العهود رغم التناقض والتباين بينها.
وامتد تأثير شوقي في عبدالوهاب ليشمل العادات والسلوكيات التي ترسبت خلال المعايشة اللصيقة لثماني سنوات، منها قلقه في فترات الإبداع، وحرصه الشديد على الحياة والجزع والهلع من ذكر الموت، والنرجسية الجميلة النابعة من الإحساس بالقدرات الخارقة على الإبداع. ثم «الوسوسة» ذلك السلوك المرضي الذي عُرف عن عبدالوهاب حتى إنه، كما قال هو عن نفسه، إذا سقطت منه قطعة صابون على الأرض في الحمّام يكاد يغسلها بصابونة أخرى جديدة.
أخذ عبدالوهاب ذلك كله عن شوقي وعكس لنا صورة حية من تناسخ الإبداع.
على الجانب الآخر كان حب شوقي لعبد الوهاب عميقًا وجارفًا. لم يبخل عليه بعلمه وثقافته وتجربته ودعمه له في كل المواقف. فعندما هاجمته الصحف مرة نصحه بأن يضعها تحت قدميه ويقف عليها فترتفع قامته. وتمنّى يومًا أمامه أمنية غريبة: أن يموت.. فزع عبدالوهاب، فقال له شوقي فيما تروي الروايات:
«حتى أكتب فيك أعظم قصيدة رثاء فأخلد بها أنا وتخلد أنت».. وقد بلغ حب شوقي له أن كتب له خصيصًا بالعامية أدوارًا وأغاني ومونولوجات ومواويل كثيرة.. ولم يكن شوقي ليتخلى عن الفصحى إلا ليتألق صوت عبدالوهاب وتحلق كلماته عبر حنجرة عبدالوهاب الذهبية.
غنى عبدالوهاب ستة وثلاثين نصّاً لشوقي ما بين فصحى وعامية. وهذه النصوص وفق قوالب الغناء كالآتي:
– سبع عشرة قصيدة فصحى
– أربعة أدوار
– ستة مونولوجات
– طقطوقة واحدة
– ثمانية مواويل
وتشكل هذه الأعمال التي غناها عبدالوهاب لشوقي نسبة ٦٫٥ بالمئة من إجمالي إنتاج عبدالوهاب.
ويأتي عبدالوهاب في طليعة شعراء الفصحى الذين غنّى لهم عبدالوهاب.
يحتل شوقي المرتبة الرابعة بين المؤلفين الذين غنى لهم عبدالوهاب، حيث يسبقه كل من :
– حسين السيد بنسبة ٢٧٪
– أحمد رامي بنسبة ٥٩٪.
– مأمون الشناوي بنسبة ٥٦٪.
لحّن عبدالوهاب سبع عشرة قصيدة من شعر شوقي: قدّم عشرًا منها حتى وفاة شوقي سنة ١٩٣٢، وسبعًا بعد رحيله انتقاها من الشوقيات، وتخيّر بعض أبياتها بما تقتضيه المناسبات المختلفة لتقديمها.
أضاف عبدالوهاب الكثير في بعض هذه الألحان. فتلحين القصائد في بدايات القرن الماضي كان يلتزم بأساليب التجويد والترتيل، والجملة اللحنية تنتهي بانتهاء الصدر أو العجز في البيت الشعري فهي – أي الجملة اللحنية – مستقلة تمامًا مثلما البيت الشعري مستقل. وفي قصيدة «يا جارة الوادي» جمع عبدالوهاب لأول مرة صدر البيت وعجزه في جملة لحنية واحدة. وفي قصيدة «تلفتت ظبية الوادي» اهتم عبدالوهاب بالعمق التعبيري موسيقيًا. ومن أول كلمة في القصيدة: «تلفتت»، يأتي بها منفصلة عن بقية السياق ويردّدها تعبيرًا عن القلق والتردّد. وفي البيت: «ليلى مُنادٍ دعا ليلى».. يكرر «ليلى» مرات ويعلو صوته بالنداء في لهفة وضياع معًا. وغني عن الذكر تجديدات عبدالوهاب في إدخال الآلات الموسيقية الحديثة والغربية في هذا الصدد.
أما بالنسبة إلى أعمال شوقي المكتوبة بالعامية – وقد كتبها خصيصًا لعبد الوهاب حتى إنه كان يغيّر في بعض كلماتها إذا أحسّ بثقل الكلمة خلال أدائه لها، فهذه الأعمال وعددها ١٩ مختلفة القوالب غنائيًا. وقد غناها عبدالوهاب كلها في حياة شوقي باستثناء «النيل نجاشي» التي قدمها سنة ١٩٣٣ بعد عام من رحيل شوقي وأهداها إلى روح شوقي في فيلمه «الوردة البيضاء».
ومن أهم الملاحظات على هذه الأعمال أن شوقي أضفى على الأغنية شكل وجو القصيدة. ويغلب على هذه الأعمال الاحتفاء بالطبيعة حتى إن بعضها يأتي كصورة وصفية:
النيل نجاشي حليوه
أسمر عجب للونه دهب ومرمر
وفي «بلبل حيران»:
بلبل حيران على الغصون شجي معنّى بالورد هايم
هذا التشكيل البصري الممتزج بتشكيل موسيقي يتجلى ظاهريًا في حرص شوقي على تصريح كل بيت بقافية داخلية للأشطر الأولى، ساعد عبدالوهاب على انطلاق ملكة «التعبير» في غنائه وكأن النغمة عنده حلّت محل الريشة عند الشاعر.
ولم تُخل هذه الأعمال العامية من العربية الفصحى لفظاً وخيالاً وبناءً.
والصياغة العربية لا تتخلى عنه في «اللي يحب الجمال»، يقول:
“من بابل السحرا”، «وفي الليل لما خلي» نجد «وعيون سوالي هواجع»، هذا الجمع الغريب على العامية.
وفي «بلبل حيران» نجد الصياغة: «سكران بغير الكاس/ من عنبر الأنفاس، ومنظر الخدّ.. بل إن عبدالوهاب عندما يغنيها، يجرّ المضاف إليه: «الوردِ» و«الخدِّ» كما هو متبع في الفصحى.
ويبقى لعبدالوهاب فضل على الكلمة المغناة، فلولاه ما كتب شوقي العامية.
ونذكر أخيرًا كلمة شيخ العروبة أحمد زكي باشا:
«الآية التي جاء بها شوقي للشرق والفن والتي ما زال ينفخ فيها الحياة بعد وفاته، هي الناطقة ببرهان الألحان الماثلة للعيان بألوان الأنغام: شخص محمد عبدالوهاب»!.
ونتابع الشوقيات المغناة مع كوكب الشرق في عدد قادم.