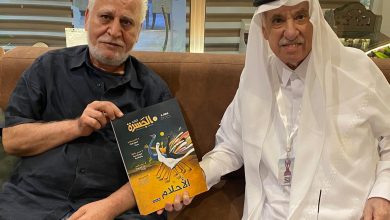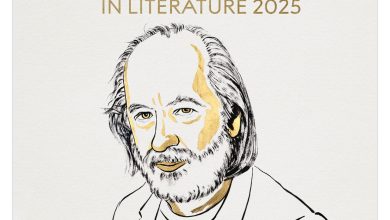حمدي البطران: طفَت على السطح مئات الروايات الميتة

الجسرة الثقافية الالكترونية
*أحمد سراج
المصدر: الحياة
يرتبط الكاتب المصري حمدي البطران بمسيرة إبداعية حافلة بالنصوص والتحقيقات، على خلفية روايته «يوميات ضابط في الأرياف»، والتي كتبها أثناء عمله في جهاز الشرطة في مصر. فقد وظيفته لكتابته تلك الرواية، وتخلى عنه اتحاد كتاب مصر، مندداً بمستواها، لكنه يكمل مسيرته متنقلاً بين القصة القصيرة والرواية. وأخيراً، صدرت له رواية «كل شيء هادئ في الجنوب»، ويستعد لإصدار «المحاكمة» التي يتعرض فيها لوقائع محاكمته عن روايته «يوميات ضابط في الأرياف».
> كيف يمكنك وصف مشروعك الروائي؟
– لم أفطن إلى أن لدي مشروعاً روائياً محدد المعالم، إلا عندما بدأت أشعر بمدى فداحة ما يتعرض له المصريون في الصعيد. معاناتهم متعددة المعالم والأنواع، فهم يعانون مع الحكومة التي تتعامل معهم بمنطق العجرفة أو السيادة، وتمارس سلطاتها دائماً مع المواطن بتعسف.
المواطن في الصعيد يستشعر هذا التعسف بحساسية زائدة، مع أن له ميراثاً ممتداً عبر آلاف السنين مع هذا الظلم الرسمي. حاولت أن أكتب عن هذا الجانب المظلم، في التعامل الأمني الرسمي مع الأهالي.
> هل يقلقك أن يربط القراء بين كتابتك الروائية وعملك السابق كشرطي؟
– أبداً، لم أشعر بأي قلق، لأنني كشرطي شعرت بمدى المعاناة، وربما كان الإحساس بها، بسبب معايشتي للناس، فكنت أشعر بفداحة ما يحدث، خصوصاً عندما يتولد عن تلك الأعمال الروتينية التي يمارسها زملائي ضرر، قد لا يرونه واضحاً أمامهم، ولا يستشعرونه. فمثلاً يستوقف الشرطي مشتبهاً به، ويستمر احتجــازه بــقصد التـحري عنه، ثم يطلق سراحه، من دون أن يعلم مــدى الضرر المادي الناجم عـــن هذا الاحتجاز القسري، ناهيــك عن الألم النفسي وهو أقسى وأشد.
> لماذا اخترت عنوان «يوميات ضابط في الأرياف»، برغم وجود عقبة رواية لتوفيق الحكيم بعنوان «يوميات نائب في الأرياف»؟
– لم يكن قصدي أن أنافس توفيق الحكيم، فهو قامة شامخة في مجال الفكر والأدب، ولكن بعض الباحثين عقد تلك المقارنات بيني وبينه، والنتيجة في غير مصلحتي، بالطبع، ربما لأن لتوفيق الحكيم الريادة في الحديث عن المسؤول الحكومي السلطوي، عندما يعمل وسط الأهالي، ومن محاسن الصدف أنه كتب عن الأماكن التي كتبتُ أنا عنها، ولكن بفارق 50 عاماً، ولعل الناقد يدرك الفرق بين معالجته ومعالجتي للظروف نفسها. ولكن خيطاً رفيعاً يربط العملين، هو التسجيل اليومي للأحداث، وإن كان الحكيم بالغ في التصوير، بعض الشيء.
> هل جاءت كتاباتك غير الأدبية انحيازاً إلى فكرة أن الأدب غير قادر على معالجة أمور الحياة؟
– أحياناً أشعر أن الرواية لا تسعفني في أن أقول كل ما عندي. كتبت «مصر بين الرحالة والمؤرخين»، لأنني لاحظت أن المؤرخين العرب ظلموا مصر، حين كتبوا عنها، وتحدثوا عن بداية جديدة لها في ظل الوافد الجديد، وتناسوا تماماً أنه كانت هناك حضارة، وكانت هناك دولة. كما أن المؤرخين العرب كتبوا بالسماع، ولم يـــؤرخوا بالدقة العملية، كما أنهم أهملوا الإنسان المصري تماماً وكأنـه غير موجود، ونقلوا من كتب بعضهم بعضاً. ربما كان الجبرتي هو الوحيـــد بينهم الذي عاصر الوقائع والأحداث التي كتب عنها، أما الرحالة الأجانب، فجاءوا ليعرفوا ويكتشفوا، وكتبوا عن مشاهدة فعليه، وتحدثوا عن الناس، وعن طرق معيشتهم ومعاناتهم.
> يسود مصطلح «زمن الرواية»، فإلى أي مدى تراه دقيقاً؟
– الرواية هي الفن الذي يستجيب طموح كل الكتاب والأدباء، لأن بعضهم يراه غير خاضع لمعايير صارمة كالشعر والمسرح وبقية الفنون التعبيرية، فدائماً ما تلبي الرواية احتياج الروائيين للتعبير عما يجول في خواطرهم.
غير أن هناك سبباً آخر وراء انتشار الرواية، وهو أن الأحداث الكثيرة التي واكبت نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين، جعلت الكتاب يميلون إلى تسجيل تلك الأحداث في روايات، فضلاً عن الإقبال على قراءة الأعمال الأدبية والترويج لها.
> لماذا اخترت الصعيد مكاناً لأحداث أعمالك الأدبية، وجاء الزمن الماضي متحكماً في مجريات الأحداث دائماً؟
– لم يكن اختياري الصعيد انتقائياً، ولكنه تمّ بقوة الأمر الواقع، فقد نشأت فيه، لذا فأنا أحس به داخلي، ولدي رغبة عارمة في الكتابة عن كل ما رأيته وشاهدته. الصعيد عالم آخر، خلاف العالم الذي أظهرته المسلسلات التلفزيونية، التي لم تعبر إلا عن جانب واحد من جوانب. الصعيد عالم يموج بالإثارة. أما عن الزمن الماضي، فهو اختيار، لأنه يضفي نوعاً من الواقعية على الحكي والقص، وفضلاً عن ذلك يتيح مساحة أكبر للتذكر.
> لا تخلو أعمالك من الحديث عن المسيحيين وتجاوزات الشرطة والجنس، فلماذا تصر على ذلك؟
– لا يمكن تجاهل المسيحيين، كفئة من فئات المجتمع المصري، لهم مشكلاتهم الخاصة، فهم يعانون من بعض المتعصبين، والمغيبين، والجهلة، ولا يمكن أن نتظاهر بأننا لا نراهم، فهم يتألمون في صمت، وفي كل الأوقات، يجب أن نشعر بأنهم شركاء لنا. وقد حاول الأميركان استغلال مشكلاتهم للضغط على مصر، وتبين لنا أنهم يضمرون الشر لنا. والحق أنهم لم يسعوا قط لتدويل قضيتهم، كما حاول بعض المتطرفين خارج مصر، وقد وقفوا خلف قيادتهم الدينية رافضين أي مساس ببلدهم.
أما الجنس فهو ضرورة لأنه يدخل في إطار صورة متكاملة لمجتمع نعيش فيه، ولا يمكن تجاهله، أو تجاهل الآثار المترتبة عليه، من كبت وصراع داخلي يسبب التوتر، فهو المحرك الفعلي لكل الحكايات.
> تفضل استخدام اللغة العارية من المجاز، وتقطيع النصوص إلى فقرات مشهدية، كما تدل لغة الحوار على بيئات محددة، ألا ترى أن ذلك يقلل من جماليات العمل الأدبي؟
– لكل كاتب بصمته التي تميز كتاباته، وأعتقد أن ما ذكرته هو نوع من الشكل، ولا يؤثر في المضمون بأي حال من الأحوال، أما عن تقطيع النصوص إلى مشاهد، فكان بسبب رغبتي في أن أضع القارئ مكاني، ليرى ما أراه. أنا أحب أن أنقل إليه كل ما وقع تحت إدراكي ليدركه مثلي، من دون تحيز مني.
> «يوميات ضابط في الأرياف»، و «كل شيء هادئ في الجنوب» و «خريف الجنرال»؛ يرى بعضهم أنها تنتمي إلى السيرة الذاتية أكثر من انتمائها إلى العمل الروائي، فما رأيك؟
– هي روايات تنتمي إلى الأدب الواقعي، ومن الطبيعي أن تتوخى الصدق الفني في التعبير، ومن يقرأها يعتقد أنها سيرة ذاتية، ولكنها مزيج من السيرة الذاتية لي ولغيري من الشخصيات التي عاصرتها، ومن الخطأ أن نقول إنها سجل وثائقي لي. ومن الطريف أنني عندما حوكمت بسبب نشري رواية «يوميات ضابط في الأرياف»، أنهم تصوروا أنها تاريخ تسجيلي وفعلي للوقائع، فاتهموني بإفشاء أسرار العمل، وكأنه كهنوت.
> تعد الآن لإصدار كتاب تحت عنوان «المحاكمة»، فهل سيكون في سياق روائي؟
– يتضمن هذا الكتائب وثائق محاكمتي، في إطار روائي ليسهل على القارئ التعامل معها، فهي نصوص قانونية جامدة تتسم بالصرامة، وهي تشكل كل ما يتعلق بروايتي الأولى وما أحاط بها من ملابسات.
> كيف تربط كتبك في مجابهة العنف بمشروعك الأدبي؟
– مجابهة العنف ومحاولة السيطرة عليه، جزء من مشروع إنساني، نرغب جميعاً في تحقيقه، وكنت أود أن أشارك فيه. مشاركتي تأتي عبر كتبي عن الأمن ومنها «تأملات في عنف وتوبة الجماعات الإسلامية»، و «الأمن من المنصة إلى الميدان». في الأول كل ما يهم القارىء معرفته، عن نشوء وظهور الجماعات الإسلامية المسلحة، وكيفية مواجهة الشرطة لها، ويتناول الكتاب الثاني آلية أجهزة الأمن والملفات الشائكة التي أسندت إليها، وكيفية اختيار وزراء الداخلية في مصر. كما تتناول «يوميات ضابط في الأرياف»، و»كل شيء هادئ في الجنوب» بعضاً مما وقع من تلك الجماعات على الشعب المصري، في محاولة منها لصبغه بالصبغة الأصولية القاتمة.
> ما هي في رأيك معوّقات التواصل بين الكتّاب العرب وقرائهم؟
– أعتقد أن «الإنترنت» قدمت الكثير لتحقيق هذا التواصل، غير أنه تواصل غير مكتمل، لأنه يتركز على الجانب الشخصي والاجتماعي الضيق، ويمكننا أن نعزو عدم اكتمال هذا التواصل بين الكتاب العرب وقرائهم إلى الجانب الانتقائي الذي يمارسه القائمون على الثقافة الرسمية في البلدان العربية، وتغليب الجانب الطائفي عليها، فهم دائماً يدعون أصدقاءهم ومعارفهم، في شكل شخصي، مبتعدين عن الأدباء الآخرين. لذلك تكوّنت شلة في كل البلاد العربية تدعو الأصدقاء ولا سبيل لمنعهم.
> كيف ترى الجوائز الأدبية؟
– الجوائز شيء طيب ومفيد للكتَّاب، ويعطيهم حافزاً وأملاً، لكنها قد تؤطر لمشروعات سياسية، وقد تنحاز إلى النصوص المعبرة عن تلك المشروعات بطريقة جيدة، وتكون العصمة دائماً في أيدي المحكّمين الذين يتم اختيارهم بعناية شديدة، للتأكد من مناهلهم ومشاربهم، لتحقيق هذا المشروع السياسي غير المعلن. هناك نسخة عربية من البوكر، نتمنى أن تصبح أكثر رسوخاً وصدقية. أما الجوائز المصرية الرسمية، فالحديث عنها يستوجب استدعاء المؤسسة القائمة على معظمها، أي وزارة الثقافة.
> لماذا يتجه كثر من الكتاب لكتابة الرواية؟
– الرواية هي الفن الذي يستجيب أنواع المغازلة الكتابية كافة، فهي السهل الممتنع، ويعتقد بعضهم أن هناك ترفًا ما، يتحقق في ممارسة الكتابة، خصوصاً ممن تتوافر لديهم المبالغ الكافية لطبع رواية، بعد أن أصبحت دور النشر، لا تدقق إلا في الأوراق المالية. وهكذا طفت على السطح مئات الروايات الميتة، ولكنهم يبعثون الحياة فيها بوهم الأكثر مبيعاً، وفي الواقع هي لا تصمد كثيراً أمام النسيان.
> لديك مؤلفات عدة في العنف والإرهاب، فما أهم الدوافع إلى كتابتها؟
– الدافع، كما قلت، هو المساهمة بجهد متواضع في محاولة تجنّب التعصب الطائفي، والإرهاب الفكري والسياسي، القائم على أساس ديني، والذي عمل دائماً على تحلّل الكثير من القيم الإنسانية، التي سادت في فترات سابقة.
> ترى أن هناك اختلافاً بين تعامل المجتمع مع طه حسين وعلي عبد الرازق وبين تعامله مع نجيب محفوظ، فإلى ماذا تعزو ذلك؟
– لدي قناعة بأن ما حدث مع طه حسين والشيخ علي عبد الرازق، نابع من مواقف ودوافع سياسية. فمسألة تحويل طه حسين للتحقيق القضائي، تولاها أحد الأحزاب، لأن طه حسين كان ينتمي الى حزب سياسي آخر، ولما تمت المعادلة، أعلن عن تبرئته وحفظ التحقيق، مع أن القارئ لمذكرة الحفظ يرى أنها مذكرة إدانة، ولكن العبرة دائماً بالسطر الأخير. وما حدث مع الشيخ علي عبد الرازق كذلك، أما ما حدث مع نجيب محفوظ، فلم يكن سياسياً، بل كان تعصباً عقائدياً، فالذين حاولوا اغتياله، فعلوا ذلك بتوصية من أحد الشيوخ، الذي قال: لو قتل سلمان رشدي، لما ظهر نجيب محفوظ. وهو ما ظهر جلياً أثناء محاكمة القتلة، كان هناك جانب عقائدي يساندهم، وهم أيضاً من ندّدوا بجنازته، وحاولوا إجهاض شعبيتها