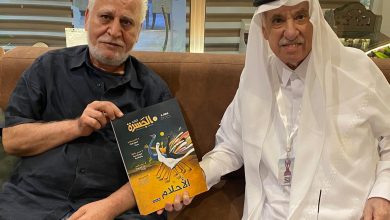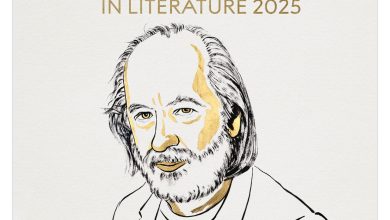ملامح الخسارة والتحايل في رواية «مسك الكفاية» لباسم خندقجي

الجسرة الثقافية الالكترونية
*علي عبيدات
المصدر / القدس العربي
بعد النظر إلى أدب السجون وأدبيات السجن سنكون أمام ثنائيات لا فكاك منها، أبرزها العدل والظلم، القيد والحرية الضيق والسعة، الرحمة والجبروت، والثبات والخيانة، على امتداد نصوص هذا الأدب وبمختلف أجناسه. فمنذ أبي فراس الحمداني، مروراً بمحمد الماغوط وحتى مك باسم في سجنه، وهذه الثنائيات لا تأفل ولا تزول في مخيلة السجين، عبر لاوعيه أولاً وفي مخرجات هذا السجين التي تخالط تلقي المتلقي ثانياً وأخيراً.
يُحاصر السجين في زوايا المكان الضيق – حسياً- ولا تفارقه الأماكن المتسعة الأكناف – ذهنياً- عبر الصور التي يحيكها والاستجلاب الذي يتحايل على نفسه ليريحها من خلاله، ويحّال هو إليه باعتباره مبدعا يدرك أهمية الحرية ولا يقبل التقولب على مقاسات الظروف، فأول مسوغات الإبداع «الحرية المطلقة»، وأن يتحرك المبدع في الوسعة التي تتبعثر فيها ذاته لينتج لنا ابداعه من دون حدود أو أُطر.
ومن الخيارات التي تكون أمام صاحب القلم السجين، إن وقعت واقعة القيد وصار محدداً بمساحة لا يملك غيرها: أولاً مواظبة العمل الإبداعي وبيان تفاصيل ما يحدث هناك، كما في رواية هاشم غرايبة «القط الذي علمني الطيران» أو محاولة التفكير في الأسباب التي جعلت المبدع سجيناً وكيف له أن يخرج لنا واقعا مختلفا لا يزج الناس في السجن وهم فيه، كما في أدب محمد الماغوط، وبعضهم حاول أن يدمج الطريقتين في قالب واحد، شارحا تفاصيل المكان ومتمرداً على خارجه، لأن لا يسجن آخرين للأسباب ذاتها.
وفي رواية «مسك الكفاية»، نرى باسم خندقجي يخرج عن المألوف، مواصلا إبداعه خارج قضبان السجن وخارج زمن الحرية أيضاً، وموغلا في مرحلة تاريخية قلقة أسقط عليها رموز حاضره بطريقته، ورسم معالم هذا الحاضر الماضي على نحو يضمن له هدف الكاتب الأزلي «أن يرسم صورة حاضره كما يريد» فاختيار هذه المرحلة بالتحديد وبعناية وبعد بحث وافٍ لم يكن عبثاً بقدر ما حاكى رؤاه ونظرته للطابع العام الذي مدَّ طابعه النفسي بزوادة الكتابة والانقلاب على أدب السجون الذي صار عضوا فيه منذ أحد عشر عاما.
رفض باسم أن تكون روايته ارتدادا لحمى القضبان ومتلازمة القيد والجدران العالية والممرات الضيقة، وكان ذا رغبة قوية بالانعتاق من المكان والزمان لينتقل إلى عصر القلاقل والقوافل والفيافي الواسعة، متشحاً بفلسفة الخسارة والفَقد التي شاعت بين طيات هذه الرواية، وفي جسد المشهد الروائي الذي صاغه متحايلاً عليه أو متجاهلاً لما يقاد حوله في تكهف على الذات يغرق صاحبها بيبوس الهوية التي تنتمي لها.
تتقاطع ذات باسم مع بطلة روايته «صاحبة الظلال» في غير موضع وبأكثر من تأويل وإسقاط، عبر المشاهد التي تحتم على القارئ ألا ينسى سجن باسم الذي حاول أن يتجاهله منذ أول حرف في روايته وعلى طول تجاهله للاستبطان والغرق بالذات.
ولعل اللاوعي الذي سيطر على الدينامية الإبداعية لباسم يشي للقارئ بكثير من التقاطعات التي امتاز بها السجين، وميز بها بطلته من دون أن يشعر – وربما شعر..!
يبدأ عامل الدهشة بالظهور تزامناً مع الصمت المطبق والخوف الشفيف في فصل تعارف القارئ على الرواية، ومع علو صهيل الخيل وتأجج الطِعَان واحمرار الأجساد التي تُقطع بمعية حضور شطّار الدولة العباسيَّة، فتضيق الصحراء بتلك المسكينة، بعد أن تحولت لهدية سيد قائد الجند الذي أمر بالبَّطش وسفك الدماء، وكانت قرية المسكينة «شبوة» سلسلة من سلاسل القتل التي مارسها أمير الجند، تماماً كمن حاكم باسم بالمؤبدات الثلاثة ضمن محاكمات لم تنته منذ مئة عام ونيف، هناك في أرض فلسطين، فكلاهما بطَّش وكلاهما جعل أرحب أماكن الكون في ذروة الضيق.
وبالتدريج تمر فلسفة الخسارة في بنى المشاهد التي أسبغ باسم على المقروء والمسموع منها وداعة المسالمين وبشاعة من هم قيد الوصول بكامل جبروتهم وقتلهم وجرائمهم، وكل هذا على طريق السجن الذي لم تعرف بعد أسواره ولا يسع المرحل/ة أن يتنبأ بطول شارب السجان هناك ولا بطول المدة التي سيقضيها السجين/ة الذي بدأ يتحول من مندهش لخاسر شيئا فشيئا.
ومن أول الرواية لآخرها لن ترى باسم منسجماً مع أناه ويشكو مآسيه الشخصية، بل هو يستثمر المشهد الذي يحرقه تارة ويرعاه تارة أخرى ليقول ما تصرخ به ذاته من أعماقها، بعد أن تطورت استجابة المبدع الذهنية مع النص الذي نوى أن يكون متخيلاً وبريئاً منه، وصار النص في تماهٍ لا فكاك بين طرفيه «باسم والضحية».
تداعت ذكورية العقلية العربية بحضور مقلق بين ما كانت عليه من فحولة وما أمست عليه من عقم عجزت عنه أقوى مقويات المروءة التي ساهم تلاشيها بزج شاب في مقتبل العمر بين سراديب السجون، تماماً كما واجهت المقاء فحولة التاريخ بكامل أنوثتها، وبعد أن أمست بكارتها هدية خنوع العبد المأمور (أمير الجند) لسيده، ولنا في هذا دلالة على خنوع آخرين صُيرَّ لهم أن يخدموا سيدهم من دون أدنى رفض، فالفتاة الجميلة مجبرة على دفع فاتورة جمالها، وبين أن تكون الفتاة جنساً آدمياً أو أرضاً يتصارع عليها المتصارعون منذ آماد، فرق جدُ يسير، فالفتاة هنا تحمل الطعام وبكامل خصوبة عمرها وحملها، وتمشي على طريق مشى عليه باسم ذات اعتقال لا يعرف آخره.
هذا السلام على صعيد المشهد- يتحول لورم خبيث جعل المسكينة لعوبا ماكرة وتكيد للسلاطين كيدا، ومثل هذه الانقلابات والتحولات النفسية تصيب السجين الذي يلبس ألف عباءة قبل عباءة الخنوع التام والإيمان المطلق بحتمية السجن والاعتراف بواقعة الزج به.
في السجن أو في القصر إن كان سجناً كبيراً، كما حدث مع باسم أولاً/ والمقاء ثانية يكون السجين/ة على موعد مع حياة أخرى وطباع جديدة وتصرفات هجينة ونتائج ورؤى لم تكن واردة، وخدم هذا النص الروائي كثيراً لما فيه من اتساع للحدث ـ على قصر زمنه- وابتكار للحوار ـ بكامل رمزيته وتكثيفه – فكما كانت نسوة القصر متفاوتات في العلم والجمال والحظوة ـ على كبرها وصغرها- في قلب الفحل الأول والأخير ومولى الجميع، ففي السجن أيضاً أنت أمام معارف ونفوس وقصص لا ناهية لها ولا حد لغرابتها ولا نصيب كنصيبها في تغيير السجين/ة سواء كان للأفضل أم للأسوأ.
يبقى السجين/ة على أمل سرمدي بالخلاص، رغم الإيمان التام بحتمية السجن التي حاول أن يتمرد عليها، فمهما كان السجن ثانوياً في حياة السجين المتجاهل للممرات الضيقة، يبقى على أمل بأن يحضر الخلاص ولو بعد حين، فكما أنقذ العربي الأبي (المقنع) تلك المسكينة من براثن الاغتصاب والسبي، ثمة متسع لكفالة أو عفو أو صفقة تبادل للأسرى يتلألأ في الأفق، وكما كان المُخلص مقنعاً لا يعرف من هو للوهلة الأولى، فهو مثلنا ونحن نراقب الأرض المغتصبة آملين أن يستفيق مقنع من طراز آخر لخلاصها، وكذلك السجين/ة. فمكان إقامة المقنع ونسبه (الصعاليك) وسبب وجودهم هناك تماماً كمخلص الأرض المنتظر، الذي ربما يقطن خارج الزمان والمكان الذي نحن فيه، وفي إرث المخلصين نرى أن المخلص مجهول مطلق.
وفي القصر، باعتباره سجنا أكثر رحابة إن كان محطة السبي الأخيرة- لنا وقفات مع التأويل والرمز الغافي بين ردهاته، فالقصر في ركن السياسة مكان الحكم والقول الفصل وحتمية تنفيذ الأوامر، وإن شئت هو مقصد الموالين ومركز ورم التواطؤ الخبيث من وجهة نظر المعارضين، وهو ذاته رمز أولي الأمر ومن صادقوا على ما حلَّ بالمسكينة وما خدش حرية المسكين الآخر، واستثمره باسم مراعياً الكوامن النفسية وانثيال السلوكيات التي يسلكها من أجبر قسراً على الوجود هناك، ممعناً النظر في النفس البشرية وكيف تتقولب بين مكر وضحية وانتقام، وتعويض للنقص المكتمل باجتثاث ومواربة مفادها التحايل وخديعة الذات المجهدة.
مع تعلم المسكينة دروس الدهاء والمواظبة على أخذ الحق من محيط أجبرها على أن تخلع برقعها وتنام على بطن الفيافي، وبين الأمصار والعواصم، يتزايد تماهي السجين مع سجنه بعد أن قرّر أن يقرأ أكثر ويكتب أكثر إيماناً منه بأن هذا مخرج وحيد لخداع الرطوبة وجولات التفقد والاستراحة المبتورة – دائماً- في هواء السجن المقيد، فهي أصبحت الخيزران وتواجه شراسة الجواري في صراع البقاء الأطول على سرير المهدي، وهو اختُصر برقم لعين صار اسمه ولخُصِ به أرخبيل الحبر الذي اقتاده إلى حيث هو.
بين أن تدفع الجملية «المقاء» ضريبة جمالها لفحولة التاريخ، وأن يدفع صاحب القلم الجميل (الشرس والرافض والمقاوم بالنسبة لنا) ضريبة حبره الذي تشرب الرصاص والحجارة، نجد ذاتين مجهدتين في ركن المشهد الروائي على امتداد تمنع المقاء دلالاً وأنين السجين توقاً للصراخ في سماء فلسطين وعلى امتداد حب الله لها.
كان لقاء المهدي بالمقاء في حدائق يانعة وبدأت رحلة المعاناة السعيدة لمن يراها والممزوجة بقاعدة «صراع البقاء» بالنسبة لمن تعيشها، نلمح باسما صحافياً فلسطينياً في حديقة رسمها نضاله على صورة وطن محرر ومن حق أهله أن يعيشوا برغد ودعة، وكانت النار تخنس عن جارية الخليفة وعن المناضل الحالم في قفا الحديقتين.
رسم باسم لنا شخوصاً من وحي خياله وزمناً عاشه الأجداد ونعيش بعضاً منه، تحدث عن ورم الخبث الذي تملؤه أهواء النفس البشرية إن فقدت أو أُفقِدَت انسانيتها، وعن المرأة بين تاريخين بظروف ثابتة، وإن تغيرت ملامح حسنها أو سُبل ظلمها، في ملحمة الذات المتكهفة بمعية عشرات البشر ومئات السنين. كان هناك شعب يقارع الزمان، خارج نطاق الزمن.
ولعل «مسك الكفاية» الذي وصلت له الخيزران بعد عناء المقاء ومرحلة الضحية ومحررة العبيد لا تختلف عن «نيرفادا» السأم الذي عاث ويعيث بقلب السجين خراباً حتى الآن..
الحرية لباسم…. لنرى هندسة روائية أخرى ترفعنا لناطحات سحاب الإبداع في العلو الخندقجي..!