هوية مسيحيي مصر كما ترويها هويدا صالح
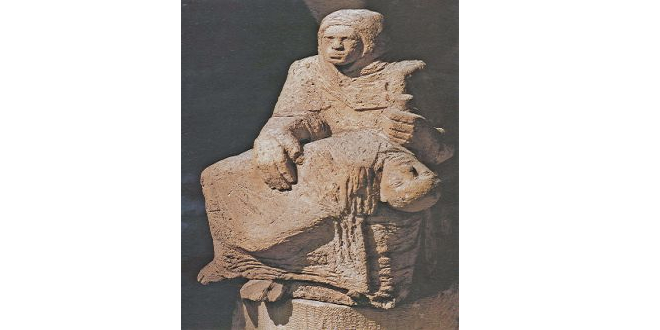
عمار علي حسن
قبل أيام سألتني باحثة في علم الاجتماع عن مصادر ومراجع تُمكنها من وصف وتحليل المسار الاجتماعي – الاقتصادي الذي سلكه المسيحيون في مصر صانعين به شبكات وأنماط مصالح وعلاقات وعالماً خاصاً من المصطلحات والإشارات والرموز والتصورات والمدارك حيال الذات والآخر، بما يجسد «ثقافة فرعية» تصب في مجرى الثقافة العامة والأصلية للمصريين، وتأخذ حالات متعددة من التجاور والتفاعل والتنافس والمضاهاة والانسجام والتفاهم. أجبتها طارحاً على مسامعها بعض الكتب والمراجع، ثم نصحتها أن ترجع إلى الروايات والقصص التي كتبها أدباء مصريون مسيحيون، فبدت مندهشة، لكنني قلت لها: ليس غير الأدب بوسعه أن ينبئك بما سكتت عنه المعارف الأخرى، ففيه الوصف والبوح وما خفي عن شبكات التواصل والعلاقات والأنماط والتقاليد والطقوس والرؤى، وهو وحده الذي بوسعه أن يحرق لك مراحل ستسغرق وقتاً طويلاً منك إن أردتِ دراسة «المجتمع المسيحي» عن كثب، بالمعايشة أو الملاحظة بالمشاركة، أو على الأقل يشكل لك خلفية متينة في التحليل والبرهنة.
في الحقيقة؛ ليس الأدباء المسيحيون فقط هم من انشغلوا بتفاصيل المجتمع المسيحي في مصر، واتخذوا منه عالماً لأعمال سردية، قصصية وروائية، بل كثير من الأدباء المصريين الذين يدينون بالإسلام كانوا أيضاً منشغلين، بل إنهم وجدوا في هذا المجتمع فرصاً سانحة لسياقات وعوالم وحكايات مختلفة ومغايرة، أو كان لديهم الدافع لتقريب هذا المجتمع إلى عموم المصريين من المسلمين، الذين يجهلون الكثير عن الدين الذي يعتنقه شركاؤهم في الوطن، ولا يعرفون عنه إلا بما تجود به التفاسير والسير والتاريخ الإسلامي عن المسيحيين. من بين هؤلاء؛ بهاء طاهر في «خالتي صفية والدير»، وسلوى بكر في «البشموري»، ويوسف زيدان في «عزازيل»، وسعيد نوح في «أحزان الشمَّاس»، وعادل سعد في «رمضان المسيحي». وتوجد الرواية التي نحن بصددها في هذا المقام وهي «جسد ضيق» للكاتبة والأكاديمية هويدا صالح (دار الراية – القاهرة – 2016).
تدخل بنا «جسد ضيق» في حذر معلوماتي، ولكن بجرأة في التناول، إلى عالم الراهبات المعزول الغامض، عبر بطلة الرواية، وهي فتاة أحبَّت فتى مسلماً، فقامت الدنيا من حولها ولم تقعد، ولم يكن أمامها من سبيل سوى الهروب إلى الدير، لتلوذ به من ضغط الأهل والنفس والزملاء والأقران.
لكن الكاتبة لم تكتف بهذا، بل غاصت إلى عمق اجتماعي أبعد، حين تناولت جانباً عريضاً من حياة المسيحيين في صعيد مصر، ووضعت يدها متوسلة بالفن على كثير من الجراح التي تُنكأ، بين حين وآخر، وتتسبب في مشكلات وأزمات مثلما تواجه مصر الآن، وواجهت في سنوات سابقة، لاسيما منذ منتصف سبعينات القرن العشرين.
تبقى مشكلة الروايات التي يكتبها أدباء عن الآخر، في سعي إلى اكتشاف ثقافة غير متداولة بغزارة بين العموم، إنهم قد يندهشون حين تقع عيونهم على ما لا يُدهش من يكتبون عنهم، ويكتفون بما يعتبره هؤلاء أقل القليل عنهم، أو العادي في حياتهم، لكن هويدا صالح عالجت هذا العيب عبر استفادتها من خبرتها الشخصية، كسيدة قادمة من صعيد مصر خالَطت في مراحل تكوينها مسيحيات في القرية والمدرسة، ومن وعيها الذاتي وقراءتها عن حياة الرهبنة وعلاقة المسيحيين بالكنيسة وعلاقتهم بالمسلمين، وتأثرها أيضاً بالسياق المكشوف أمام الجميع.
وجاءت المعالجة الأكبر في توسيع الكاتبة المساحة الإنسانية في عملها، والاتكاء على الجوانب النفسية والمونولوج في الوقوف على دخائل شخصيات الرواية، بوصفهم بشراً، يفرحون ويحزنون، ويخافون ويتشجعون، ويحبون ويكرهون، وكذلك «الرجع» الذي أتاح للكاتبة من خلال تقنية التذكر ألا تقع في ضرورة اللجوء إلى التفاصيل الدقيقة، مستعيضة عنها بالمواقف والمواضع المتقطعة، وهي الطريقة التي تعمل بها الذاكرة، متنقلة من موقف إلى آخر، بلا ترتيب أو سير في خط مستقيم من الخلف إلى الأمام.
وربما لم تجد الكاتبة نفسها مجبرة على الخوض في التفاصيل أو الرسم الدقيق لحياة المسيحيين، إذ إن معظم القراء يجهلون الكثير عنه، وهي مسألة تعبر عنها وهي تصف حال بطلتها حين تقول: «لا تعرف لماذا لا يتعامل المسلمون مع دينهم بهذا الغموض، صلواتهم مذاعة، وقرآنهم في تفاصيل الحياة اليومية. إذا دخلت محلاً أو سِرتَ في الشارع أو حتى نِمتَ في سريرك يصلك قرآنهم عبر ميكرفونات تحرمك النوم أحياناً. أما تفاصيل وطقوس الدين المسيحي فهي سر من أسرار الكنيسة. تمنت كثيراً أن تتحدث عن دينها مثلما تفعل زميلاتها في الحجرة. تمنت أن تسمعهم آية من آيات الإنجيل مثلما تسمع هي ليل نهار القرآن والأحاديث».
كما لجأت الكاتبة إلى المقاطع أو «الاسكتشات» التي بلغت واحداً وثلاثين مقطعاً، تبدو مُلَخِصةً لما يأتي بعدها، أو مفتاحاً له، أو إشارة إليه، أو دليلاً عليه، أو تمهيداً له، أو حتى محطات للربط بين أجزاء الرواية، والتقاط القارئ أنفاسه. وقد أعطت كل مقطع منها عنواناً لافتاً، ومنها: «عرائس المحبة القطنية/ الست سارة/ البحث عن الخلاص/ الخواجة حنا/ يا بائع الطين بِع لنا حِنَة/ أم يوحنا/ ليس ثمة رجوع/ عن العروس/ كما يبنغي لعاشق/ فردوس/ فخاخ عزازيل في مسألة الجسد».
وعلى رغم أن عنوان الرواية هو «جسد ضيق» فإننا نواجه فيها أجساداً ضيقة، أو أجساداً تضيق بها الرغبة أو يضيق آخرون بسعيها إلى تلبية نداء الرغبات الدنيوية الطبيعية. فخلافاً لـ «فردوس» المعذبة بالعقاب البدني في المدرسة ثم بكبت رغبتها في المحبة الإنسانية، هناك «دميانة» التي بَرُدَ اشتهاؤها للرجال، وزوجها «حنا» الممرض الذي يتلصص على أجساد النساء لأن زوجته لا تُشبِعُ رغبته، لكن الأمر يصل إلى ذروته مع حياة الرهبنة، التي تحاول، عبر مجاهدة طويلة، أن تسمو على رغبات الجسد وأشواقه الدنيوية. وكل هؤلاء لا يواجهون ما يجري لهم بالتصدي والتحدي إنما بالهروب في الصبر والانتظار، وترويض الوقت والغريزة، والتوحد مع الذات، والانعزال في طريق العبادة.
وما بين البداية المقبضة والنهاية الغارقة في الهروب تمر بنا الرواية عبر بطلتها في محطات اجتماعية عدة؛ نعرف منها طبيعة علاقة المسيحيين بالمسلمين في ريف مصر وحضرها، وفي مؤسساتها ومدارسها وجامعاتها ودور العبادة، ثم العلاقة البينية عند المسيحيين أنفسهم، لاسيما حياتهم الأسرية وما يدور فيها، والمسار الذي يربطهم برجال الدين. يتم كل هذا عبر راوٍ عليم، وبلغة تبتعد عن التكلف، وصور إنسانية وجمالية، وانتقال في الأمكنة، وترحال في الأزمنة، لتصنع بكل هذا سرداً أكثر إحكاماً وانسجاماً مما ورد في أعمالها القصصية والروائية السابقة.
(الحياة)




