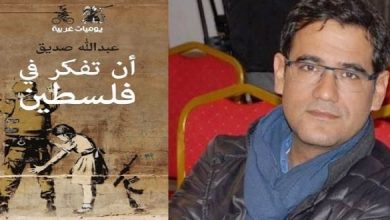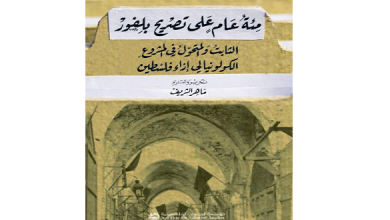غادة جميل تبحث شفاهية وكتابية الشعر الجاهلي

عبد السلام فاروق
قليلة هي الدراسات الأكاديمية الجادة التي تعكف علي دراسة قضية أو مشكلة يستطيع من خلالها الباحث أو الباحثة هنا الدكتورة غادة جميل قرني في كتابها “الشفاهية والكتابية في الشعر الجاهلي .. دراسة في تأويل النص” الصادر حديثا عن دار النابغة للطباعة والنشر.
تسعي الناقدة الدكتورة غادة جميل إلى تطبيق نظرية التأليف الشفهي على الشعر الجاهلي، متسائلة هل كان الشعر الجاهلي عروضاً شفهية متنوعة لحكاية أو حكايات معينة؟ وهل كان الشاعر الجاهلي أمياً لا يعرف القراءة والكتابة؟ وهل وجود عبارات صيغية متكررة في الشعر الجاهلي تعني شفاهية هذا الشعر أم أنها تشير إلى نوع من التقاليد الأدبية للكتابة في ذلك الزمان تحمل ميراثاً شفاهياً؟
وهل مطولات الشعر الجاهلي التي تنطوي على أغراض متنوعة قد تم تأليفها وتأديتها في لحظة زمنية واحدة؟ وهل ما قدمه الباحثون، استناداً إلى نظرية التأليف الشفهي، يمكن النظر إليه بوصفه تأويلاً جديداً جديراً بالتقدير؟ ولما لا يمكن النظر إلى النص الشعري الجاهلي بوصفه نصاً كتابياً يعتمد على التبصر والتأمل والنظر وتأويله طبقاً لذلك؟
وهل الروايات المختلفة للقصائد تجعلنا نعتقد أن النص الشعري الجاهلي تم تأليفه شفاهياً أو هو وجود عائم يتخلق مع كل أداء؟ ولماذا لا نعتقد أن فكرة الراوي هي المسئولة عن الروايات المختلفة للقصائد، وهذه الفكرة لا تنفي كتابية النص ذاته؟ ولماذا لا نعتقد أن النص الجاهلي هو ممارسة كتابية تدفعنا إلى الدخول في عالم الدال ولعبته، ففاعلية الكتابة مشروطة بهذه اللعبة ومراح الدال العفوي الذي يتأبى على القولبة والمعنى الثابت والمدلول المسيج المتعالي ويستجيب إلى الإحالة النهائية والارتحال الدائم؟
وترى الدكتورة غادة جميل أن: “الشفاهية والكتابية في الشعر الجاهلي: دراسة في تأويل النص”، وهو عنوان، فيما نظن، يحمل دالين أساسيين هما: الفحص والتأويل، فأولهما يسعى إلى وضع تصورات عن طبيعة النص الشعري الجاهلي، وثانيهما يعتمد على هذه التصورات، فينهض بعملية تأويل النص. ولذلك فإن هذه الدراسة تقع في بابين يعني أولهما بعملية الفحص ويعني ثانيهما بعملية التأويل.
ويشتمل الباب الأول، المعنون بـ “شفاهية وكتابية النص الشعري الجاهلي”، على فصلين، يناقش أولهما مسألة شفاهية النص الشعري الجاهلي، ويعتني بوجهة النظر التي عاينت النص الشعري الجاهلي بوصفه نصاً شفاهياً، مميزاً في البداية بين النزعة الشفاهية والنزعة الكتابية وطبيعة العلاقة بين النزعتين، ومنتقلاً بعد ذلك إلى المسألة الهومرية؛ وتأسيس ميلمان باري وألبرت لورد لنظرية التأليف الشفهي، ثم يعرض بعد ذلك دراسات المستشرقين التي طبقت نظرية التأليف الشفهي على الشعر الجاهلي، ووقف عند دراسة جيمس مونرو المعنونة بـ “التأليف الشفهي في شعر ما قبل الإسلام”، ودراسة مايكل زويتلر عن: “التقليد الشفهي للشعر العربي الكلاسيكي: خصوصيته وتضميناته”.
وينتقل بعد ذلك إلى عرض ما قدمه الدارسون العرب حول شفاهية الشعر الجاهلي فوقف عند دراستين أولاهما: “مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي”، لـ عبدالمنعم خضر الزبيدي، وثانيتهما: “الشعر والغناء في ضوء الرواية الشفوية”، لـ فضل بن عمار العماري، وينتهي هذا الفصل بتقييم لنظرية التأليف الشفهي ومحاولة تطبيقها على النص الشعري الجاهلي.
أما الفصل الثاني المعنون بـ “كتابية النص الشعري الجاهلي”، فإنه ينفتح بالإشارة إلى أن الجهود التي قدمها مستشرقون وعرب حول شفاهية الشعر الجاهلي لم تفحص مسألة كتابيته، وتأسست على فكرة جوهرية هي أن الشعر الجاهلي صدر عن شعراء لا يعرفون الكتابة والقراءة أو شعراء أميون، ولذلك بدأ فحص مسألة كتابية النص الشعري الجاهلي بمناقشة مصطلح “الجاهلية” وما يشير إليه من معان منتقلاً إلى مصطلح “الأمية”، ثم يعرض بعد ذلك شيوع القراءة والكتابة بين العرب في العصر الجاهلي، وفحص أدوات الكتابة وموادها والمكتوب ذاته، ونشأة الخط العربي.
وينتقل بعد ذلك إلى مناقشة طرائق التأليف الشعري التي تؤكد اختلاف لحظة التأليف الزمني عن لحظة الأداء أو القراءة، ثم يناقش بعد ذلك فكرة تخزين المكتوب أو حفظه مشيراً إلى أن فكرة المعلقات، التي تؤكد دوال الحفظ والتخزين والاستحسان، تحيل بدورها إلى دوال الكتابة.
ويناقش الفصل بعد ذلك ممارسة الشعراء للكتابة الشعرية وما تشير إليه الروايات التاريخية عن انتخاب الألفاظ وتنقيحها، منتهياً إلى أن النص الشعري الجاهلي قد تمت كتابته فعلياً، وتم إنتاجه عن طريق الكتابة وليس عن طريق التأليف الشفهي. لكن هذا لا يمنع من تسلل قوالب صياغية إلى المكتوب يمكن تعليلها بالأصل الشفاهي للنص المكتوب. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك أميين نظموا شعراً شفاهياً، لكن هذا الشعر لا يمكن أن يكون قصيدة مطولة متعددة الأغراض وإنما هو تعبير عن موقف معين يستدعي الارتجال والقول العفوي.
ويشتمل الباب الثاني المعنون بـ “تأويل النص” على توطئة وثلاثة فصول، وتشير التوطئة إلى أن الفحص الذي تم في الباب الأول انتهى إلى أن النص الشعري الجاهلي قد تم إنتاجه عن طريق الكتابة، وأن النص الشعري الجاهلي لا يقع في دائرة العروض الشفاهية المتنوعة لحكاية ما تفترض تشابهاً وتكراراً في الصيغ والعبارات. وربما يبدو صحيحاً أن الشعر الجاهلي، مثله مثل أي شعر آخر، قد يقع فيه صيغ وعبارات متكررة، لكن ذلك لا يقوم دليلاً على أنه شعر قد تم إنتاجه شفاهياً، وإنما يشير إلى تقاليد معينة للكتابة الأدبية، هذه التقاليد ربما تحمل ميراثاً شفهياً.
أما الفصول الثلاثة، فقد حملت عناوين: المرأة والطلل والظعائن، والوشم، والحيوان؛ لكنها اعتمدت على وعي تأويلي وصفه بول ريكور بـ “العمل في الفكر الذي ينطوي أو يتوقف على فك شفرة المعنى المختفي في المعنى الظاهر، أو كشف وفتح مستويات من المعنى المضمن في المعنى الحرفي”.
ويتأسس هذا الوعي على ثلاث استراتيجيات تأويلية، أولها: النظر إلى النص الشعري الجاهلي بوصفه ممارسة كتابية، وثانيهما: تتبع الدوال في النص بما يقتضي النظر إلى دوال الطلل مقترنة بدوال المرأة والظعائن ومحيلة إلى دوال الوشم والحيوان. إن التأويل في تلك الحالة ينزع إلى لعبة الدال، فيتحرك من الأمام إلى الخلف، ويتحرك أيضاً من الخلف إلى الأمام، لكنه يظل محكوماً بانتشارية الدوال في النص، تلك الدوال، فيما أتصور، لا تكف عن الإحالة والاستدعاء لدوال أخرى لانهائية.
وثالثها: يتعلق بالنماذج التي تم تأويلها في الفصول الثلاثة، فهذه النماذج لم تقف فقط عند شعراء مشهورين، وإنما تجاوزت ذلك إلى شعراء مهمشين أو شعراء لم تسلط عليهم الأضواء النقدية بطريقة كافية أو شعراء القبائل. إن التأويل يتعامل مع منتخب من الشعراء يشبه إلى حد كبير منتخب الأصمعيات أو المفضليات أو غيرها. ويجب الانتباه أن الفصول على الرغم من أنها حملت عناوين محددة، فإنها تأولت مفردات متنوعة مثل الحكمة والفخر والرحلة والهجاء وغير ذلك. إن التأويل يجول في القصيدة من الأمام إلى الخلف، ويتحرك من الخلف إلى الأمام، ويستدعي دوال لكي يتم تأويل دوال أخرى.
بقيت نقطة أخيرة وهي تتعلق بالمنهج المستخدم في هذه الدراسة، فإنه يعتمد على مفهومين أساسيين هما الفحص والتأويل، ولقد استدعى المفهوم الأول أطروحات النقد الشارح من حيث إنها أطروحات تقوم بعملية “فحص النظريات والمقاربات النصية للمعنى النصي، وعلاقة الكاتب والقارئ بالنص، والمعيار الذي يتم بمقتضاه الحكم على النصوص والصناعات الثقافية الأخرى”، أما المفهوم الثاني فإنه استدعى أطروحات تفكيكية في المقام الأول، وهي أطروحات تتأسس على لعبة الدال أو الدال العائم الذي يظل في حالة من البحث المستمر عن مدلوله، وإن وجده يتحول إلى دال جديد وسلسلة لانهائية من الدوال. إن التأويل في تلك الحالة محكوم بانتشارية الدوال ومراحها العفوي الذي يتأبى على القولبة والمعنى الثابت.
(ميدل ايست اونلاين)