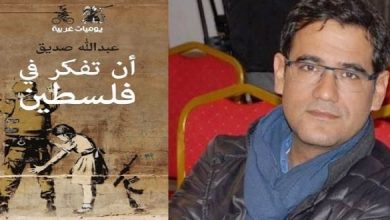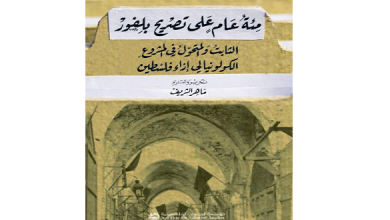رواية التاريخ وفق سلطة المفاهيم الدينية

محمد عبد الرحيم
كيف كان التفكير الإسلامي في القرون الوسطى؟ كيف صاغ الخيال في ظِل الإسلام رؤية العالم، والبحث عن معناه وإنتاج دلالته؟ يحاول كتاب الإجابة على هذه الأسئلة، من خلال دراسات عدة تتناول الكتابات النظرية، التأريخ، الذكريات والقص والتعبير الرمزي. وهنا يتضح كيف تفاعل الفرد في تلك الفترة مع العالم في إطار المقدس، وكيفية النظر للآخر عقيدة ومذهباً مغايرا لما عليه المسلم الذي يعيش في دولة توسعية بمفهومنا الحاضر، كانت ذات يوم مركز العالم، ولو حتى في عُرف هؤلاء.
هذه الدراسات التي أعدتها مجموعة من الباحثين، وحررتها جوليا براي أستاذة الأدب العربي في جامعة باريس 8، وقام بترجمتها الشاعر المصري عبد المقصود عبد الكريم. تعد قراءة جديدة تسعى لتفكيك تراث فكري وعقائدي في المقام الأول، وربما تصبح حافزاً لأفكار لم تزل جديرة بالاكتشاف. صدر الكتاب عن المركز القومي للترجمة في القاهرة.
الحقيقة والخيال
في بحثه عن أحمد بن علي بن زنبل الرمّال يرى روبرت إروين أنه يعد أول روائي تاريخي في العالم العربي، مُستشهداً بكتابه «انفصال دولة الأوان واتصال دولة بني عثمان». وفيه يشهد ابن زنبل زوال دولة المماليك وصعود نجم العثمانيين. ورغم حسراته وتعاطفه مع زوال عصر الفروسية، إلا أنه يؤكد على عدالة قضية العثمانيين. ومن خلال الكتاب نرى كيفية تفكير الراوي.. فطومان باي هو القديس البطل، والشرير لم يكن السلطان سليم العثماني، ولكن الخونة من المماليك. يسرد الراوي دوافع الشخصيات وسلوكها، وبذلك هل يعد الكتاب مؤلفاً تاريخياً؟ أم من الممكن اعتباره رواية؟ فالكتاب يضحي بدقة الواقع لصالح الدافع السردي. فالأحلام تخبر طومان باي بنهايته المأساوية، هناك حلم بطوفان مدمر، ثم خمسة كلاب سود تهاجمه، وبعد قليل يظهر النبي في حلم ليخبره بأن قضيته خاسرة وسلالته هالكة، وبناء على ذلك يطرح طومان باي سيفه في المياه. فالسرد يعد مناظرة درامية للشرعيات المتقابلة للمماليك والعثمانيين، وبينما كان الأنذال في السير الشعبية مسيحيين أو مجوساً أو يهودا، لكن الحرب هنا بين نظامين إسلاميين سُنيين. ويرى الباحث أن ابن زنبل وإن كتب عن هلاك المماليك، إلا أنه جعلها رسالة إلى العثمانيين أنفسهم، فقرأ بعضهم الكتاب الذي يصف أحداث الماضي في ضوء مخاوفهم بشأن المستقبل. فـ»انفصال» قصة لا ترتبط فقط بسقوط المماليك، لكنها تتنبأ ضمنياً بسقوط العثمانيين في المستقبل.
تأسيس أساطير الثقافة الإسلامية
«المادة الخام للتاريخ الإسلامي هي التقرير الفردي، قد تكون هذه التقارير متداولة من بداية الإسلام، ومع ذلك بمجرد ان اكتسبت أقوال الأبطال الأوائل في الإسلام قيمة معيارية، أي اعتبرت نموذجاً للسلوك السياسي الحالي». ومنه فهذه الأقوال تعد مبررات لإقرار وضع آني في عصرنا الراهن. هكذا يحاول روبرت هولاند البحث من خلال علاقة التاريخ بالقصة والحكايات المؤلفة، وكيف يمكن إعادة إنتاج الواقعة لتتناسب والظرف الاجتماعي، وبالتالي توظيف الحكاية لهدف يفوقها، اجتماعيا أو سياسيا لو أردنا الدقة. الأمر الآخر وهو المتعلق بكيفية انتقال الأحاديث المحمدية، فالأهم هو ناقل الحديث من دون الاهتمام بحقيقة الحديث نفسه. فتأكــــيد صحة الحديث لم يكن يرتبط بتحليل النص، قدر ارتباطه بمعرفة الرجال الذين نقلوه، وبالتالي كان الاتهام بالتدليس لا يوجه إلى تلفيق الروايات، بل إلى الذين تناولوا أسانيد معيبة.
الحكاية أيضاً لا تستقيم من دون بناء حبكة وبنية تفسيرية أعلى.. فقصص الدخول في الإسلام تروى بطريقة مُبرمجة تماماً.. يُعرض الإسلام على الشخص/يُقرأ القرآن أمامه/يؤمن الشخص حتماً ويصدق. وهنا يتم استخدام بعض الكلمات الأساسية (العرض، القراءة، الإيمان، التصديق) للتوفيق بين روايات كانت شديدة الاختلاف، فاختيرت هذه الأفعال الخاصة للاعتقاد بأنها متوائمة مع المعنى الأكبر للأحداث.
والمعنى الأكبر هذا ينبع من مبادئ موجهة أو فكرة عامة شاملة تقود المؤلف إلى تنسيق الكثير من المواد المروية والربط بينها وفق معتقده ولخدمة أهدافه السياسية والاجتماعية، فكل التواريخ الإسلامية لها اهتمام واحد هو.. ترسيخ شرعية نبوّة (محمد) وأمته وسيطرة الإسلام، فيتم تقديم أمة محمد بوصفها الوريث النبوي لتراث التوراة، والوريث الدنيوي لبلاد فارس والممالك الأخرى، بينما توضع الجاهلية في مقابل التنوير الإسلامي.
الأمر نفسه يخص (الصحابة) فلولاهم ما كانت البلاد للمسلمين، ولا انتشر هذا الدين. ولكن المأزق يتمثل في تورطهم في الحرب الأهلية التي دارت حول انتقال الخلافة، فكانت المهمة الشاقة للبحث عن حل من خلاله يمكن تبرئة كل الأطراف، ويستشهد الباحث بكتاب «الجمل ومسير عائشة وعلي» لسيف بن عمر التميمي، وهنا يصور الصحابة بأنهم ضحايا أبرياء للسبئية، متهماً أتباع اليهودي (عبد الله بن سبأ) أنهم ضالعون بدور مثيري الشغب، فهم الذين حرضوا على موقعة الجمل، ورغم حروب الصحابة في الجانبين، إلا أن المؤلف يرى أن نواياهم كانت تتجه إلى الصُلح.
وضعية النساء في كتابات إسلام القرون الوسطى
لا يخفى أن وضع المرأة الذي تم تأسيسه منذ كتابات الإسلام الأولى لم يزل محل جدل حتى الآن في المجتمعات الإسلامية، بداية من نص مؤسس (القرآن) حتى النصوص التاريخية أو التاريخ القصصي. ويستشهد جولي سكوت بكتاب «النساء والنوع في الإسلام: جذور تاريخية لمناظرة حديثة» لليلى أحمد، أنه قد تأسست المصطلحات الإرشادية السائدة لجوهر الخطاب الديني، وبالتالي تطورت مؤسسياً وفق هذا الخطاب. فهناك توتراً أساسياً بين رسالة المساواة في القرآن، والعلاقة الهرمية بين الجنسين، المتمثلة في بنية الزواج التي أسسها الإسلام، وكذلك هذه العلاقة التي عكست وجهات نظر أصحاب سلطة ذلك العصر. من ناحية أخرى ترى فدوى مالطي في كتابها «جسد المرأة، كلمة المرأة: النوع والخطاب في الكتابة الإسلامية العربية» أن كل أشكال الكتابة تقوم بأدوار أساسية في لعبة النوع، وفي انتشار أفكار وقيم الخطاب الإسلامي العربي، فالكلمة بالنسبة للمرأة مرتكزة على الجسد، فكل النصوص إذن تعكس واقعاً حضارياً تحدده معايير المثاليات الدينية للإسلام. ومن خلال مؤلفات مثل «ألف ليلة وليلة» و»حي بن يقظان»، فحكايات النساء بالأساس خطابات يتحكم في رواياتها ذكور. من ناحية أخرى يتم تصوير العالم المثالي بأنه العالم بدون نساء، فالرغبة المثلية ــ المثلية الاجتماعية ــ تسود الخطاب العربي الإسلامي.
(القدس العربي)