راجح خوري يكتب الشعر تحت «غصون الباكيات»
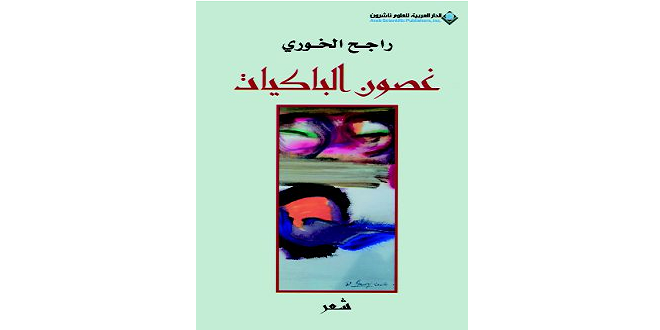
عبده وازن
يجمع راجح الخوري بين وجه المعلّق السياسي الدؤوب ووجه الشاعر جاعلاً منهما وجهين لشخص واحد هو الاثنان معاً. ولئن كان ينحاز كما يعبر دوماً، إلى صفة الشاعر، فهو لم يجاهر بها كثيراً على حساب الكاتب السياسي الذي أمضى ردحاً من عمره ولا يزال، في حقل الصحافة. لكنّ غالب قرائه يعرفونه من خلال مقالاته اليومية والأسبوعية وقلة منهم تتابعه شاعراً، ولعله تواطأ شخصياً في هذا الأمر، مبقياً الشاعر الذي فيه على هامش السياسة ومتاهتها التي تزداد اتساعاً في عالم اليوم. الشاعر هو الصوت الآخر أوالقرين الذي يمارس وجوده بعيداً من صخب العالم ومن التلوث الذي يصيب الحياة التي باتت ماديةً ولم يبقَ فيها زاوية ولو ضئيلة للمشاعر والأحاسيس النبيلة والحب والحنين…
إلا أن راجح خوري بلغ ديوانه الرابع مع صدور «غصون الباكيات» (الدار العربية للعلوم – ناشرون) ما يؤكد مضيه في تجربته الشعرية، ولكن بعيداً من المعترك الشعري وقضاياه وفي منأى عن التنظير والنقد اللذين يمارسهما الشعراء عادةً. كل همه أن يكتب وأن يعبر عما يجيش في القلب والروح والعقل من مكابدات وأحزان وتأملات وأمنيات. وهو يكتب بصوت صاف وهادئ حيناً، وبنبرة غاضبة وحادة حيناً آخر، صابّاً غضبه على الظلم والإثم واللاعدالة التي تتحكم بالإنسان فرداً وجماعةً. ولا غرابة في أن يحمل في قرارته موقفاً شبه رثائي إزاء حال الانهيار التي يعيشها الوطن الذي هو لبنان، شعباً ورمزاً. وها هي قصيدته «الطوفان» التي يستهل بها ديوانه تسترجع قصة الطوفان التوراتية وتستعيد شخصية نوح مجازياً لتصور «الليل الصقيعي» الذي «يعربد»، و«المدينة» التي لم يبقَ فيها غير القاع يحتضنها و «سبايا نيوب الماء». إنها المدينة التي «ليس من برق يضيء حلكتها»، يجتاحها السيل وفيها «يعوي الرضيع من هول المجيء». لكنّ مأساتها الحقيقية تتجسد في عجز نوح عن اجتراح المعجزة فهو ينشد بلهجة اليأس: «يصل الربيع بالصراخ/ يمضي الخريف بالنواح». وقد تكون قصيدة «المنارة المطفأة» رمزاً آخر من رموز هذه المدينة التي أغرقها الطوفان وغابت عنها باخرة نوح فهو يقول: «ليكن لهذه المنارة ضوء/ يهدي الأشرعة الهالكة/ والسفن الغريقة». ولئن انتهت الحرب اللبنانية ظاهراً أو شكلاً، فإن أثرها يظل حاضراً في وجدان الشاعر والصحافي الذي عاش مأساتها منذ اندلاعها عام1975. الطيف الأسود للحرب وخرابها الكبير لا يغيب البتة عن جو بعض القصائد وإن في طريقة غير مباشرة: «تسقط الشجرة مثل قتيل/ تقيم الغابة مأتماً/ في وسعك سماع/ نحيب الغصون ورؤية الدموع/ في البراعم/ ألم ترَ الأكمة غارقة في الحداد/ ما كل هذا الأسود إذاً؟».
قد يكون من الطبيعي أن يظهر عنصرا اليأس والتشاؤم في بعض قصائد الديوان، فالشاعر الذي يعاني يسائل الوجود ويتأمل في حال الكون الرهيب وفي الموت الذي يمثل قدر الإنسان: «نحن كمشة تراب/ في قبضة الجذور» يقول، ويقارب النظرة العدمية إلى العالم قائلاً: «نحن من عدم دامس/ إلى عدم دامس». وهذه الحال التشاؤمية تلامس الإنسان نفسه، كائناً وجماعةً كأن يقول: «بكّائين نخرج من تراب/ بكائين ندخل في تراب»، وهذا ما يذكر بمآل الإنسان الذي كما يقول العهد القديم: «أذكر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود». وفي قصيدة شديدة السوداوية عنوانها «النسيان» يبلغ خوري مصاف الشعراء العدميين الذين فقدوا كل أمل بهذه الحياة وواجهوا جهاراً تجربة الفراغ فهو يقول: «إما أن يكون/ الثقب الأسود/ في عمق المجرة /ابتلعني/ وإما أن تكون/ المجرة المرتحلة فقدتني/ ورقة تهوي / في الفراغ السحيق».
ولكن في غمرة هذا الهجس العدمي والتشاؤم، ثمة ضوء يشرق دوماً من وراء الغيوم التي تلبد السماء، والضوء هنا هو شعلة الماضي الجميل، شعلة الطفولة والأرض والطبيعة. فالحنين إلى الماضي وبراءته وصفائه هو سلاح الشاعر في مواجهة الواقع المملوء بشاعةً وشروراً. هكذا يجد الشاعر في الطبيعة وعالمها ملاذاً يلجأ إليه ويستعيد عبره جذوره وكينونته. ولعل المعجم الطبيعي الذي تزخر به قصائد الديوان دليل على حضور الطبيعة ليس كموضوع أو كمادة كتابية، وإنما بصفتها جزءاً من الذات العميقة واللاوعي: إكليل الجبل، الحبق، الزنبق، العشب، النهر، الشحرور، العليق، الطيون، الجنادل… وفي هذا الماضي الجميل، يسترجع الشاعر صورة جدته الحافلة بالبراءة والخير: «في كف الجدة/ جوز ولوز وزبيب». لكنه يرثي أباه، وهو يمثل أيضاً إحدى صور الماضي الجميل، يصفه بـ «الفارس القاطع مثل سيف/ والمنقض مثل رمح»، ويخاطبه: «يا ملك النار وسيد المطارق/ وأمير الفولاذ/ اللهب في يسارك/ والنور شرر يمينك». ولا تغيب صورة الأم أيضاً وهي الكائن الأرقّ والأعذب والأحن، فيكتب عنها: «ماتت أمي/ وهي تغسلنا بالدموع/ وتدثرنا بالدموع/ إن جئنا من غياب بكت/ وإذا جرفنا البعاد بكت»، ثم يتصاعد الكلام عنها تصاعداً غنائياً فيقول الشاعر: «عندما صعدت إلى السماء/ تركت لنا ثروة لن تنضب/ وصية لمسيرة شتاءات طويلة/ نمضيها في غصة دائمة…» وفي قصيدتين هما «تعبرين كنصل» و «زيارات» يخاطب الشاعر الأم الغائبة مخاطبةً وجدانيةً قائلاً في القصيدة الثانية: « تهبطين دائماً من غابة الزيتون/ تدخلين البيت النائح/ من شقوق النوافذ وأخاديد القلب/ تلفحين وجهي بزيت وبخور».
في ديوانه الرابع «غصون الباكيات» ينتصر راجح الخوري للشاعر الذي فيه، ولكن ليس على حساب الكاتب أو المعلق السياسي. لعله نجح في الجمع بين الشخصين جمعاً حقيقياً، فإذا بالأول يكمل الثاني والثاني الأول.
(الحياة)




