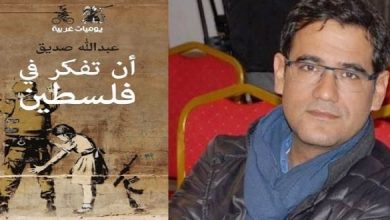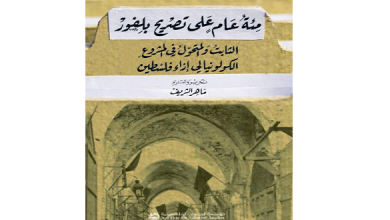أحمد الملا يصنع من الصور العابرة قصائد

محمد مظلوم
في ديوانه الجديد «ما أجمل أخطائي» (دار مسارات، 2016)، يولي الشاعر السعودي أحمد الملا عناية خاصة واهتماماً لافتاً بالمشهد والصورة. ومع أن مثل هذا الاهتمام معروف في شعر الحداثة الأميركي منذ بدايات القرن العشرين، تبقى درجة تمثُّله في الشعر العربي بحاجة إلى التدقيق النقدي، على رغم أننا إزاء ما يشبه «الظاهرة» في شعرنا الحديث. ومن الدروس النقدية التي زامنت ظهور الإيماجية التي نظَّر لها عزرا باوند، وبشّر بها، وكتب نماذجها المبكرة، أنها تعتمد في جانب أساسي منها على «التجلي» الذاتي للمشهد، وهو على كل حال تجلٍ طيفي وشبحي، كما يصفه باوند نفسه. وهي لا تنشغل باستبصاره أو اكتناه بواطنه، ولهذا فهي قصيدة حيادية أو يمكن إحالتها بسهولة إلى الغرض الوصفي شتَّت التسمية أم قرُبتْ. وفي ديوان الملا نلمس كثيراً من مواضع هذا الوصف الصوري المحايد: «تلك العربةُ ملقاةٌ على الرصيف/عربةُ طفلٍ مدهوسة/وعاملُ الدكان/يشطفُ الدّمَ والزجاجَ/من الشارع».
وتُعدّ قصيدة «في محطة للمترو» لباوند نفسه النموذج المؤسس للشعر الإيماجي والدرس النصي لمعنى الإيجاز، فهي قصيدة من سطرين وأربعة عشر كلمة لا غير، بجملتين أسميتين من دون فعل، ومع ذلك فإنَّ القصيدة لم تتمثل في تلك الكلمات، بل خارجها، أي في الإيحاء المتواري خلف السطرين.
وفي قصيدة الملا إيجاز لغوي ظاهر، لكنه مصحوبٌ بتتابع الأفعال على نحو يجعل من ذلك الإيجاز تراكماً صورياً: «يجرُّ حذاءَ المبالغات/يلبسُ قميصَ المربّعات/يضعُ طرطوراً مكسوراً/ويقفُ أمامَ المرآة/طويلاً يحدّقُ/يحدّقُ ويبحث/ولا يجدُ ضحكتَه». لكنّ العناية المفرطة بالتصوير، لا تجعل القصيدة وصفية وشيئية فحسب، وإنما تدخلها كذلك في مأزق المعنى وهو ما يعترف به باوند نفسه: «أجرؤ على القول أنَّ لا معنى لها… وإنها مجرد قصيدة تسجيلية للحظة دقيقة في الخارج».
هذه التسجيلية كثيراً ما نجدها لدى شاعر «علامة فارقة» فهو حين يصوِّر المشاهد في المكان لا يكاد يخبرنا شيئاً لافتاً عن نفسه، ولا يهتم، كذلك، في تأويل المشهد أو أمزجة أشخاصه ولهذا يبدون، غالباً، كأنهم أشباح، وأطياف لأشخاص متعددين ومختلفين. بينما يستبدل الشاعر هوية الرائي بالراوي، فهو لا يتجوَّل في الجانب الآخر من حياة الآخرين، بل يكتفي بالمراقبة من بعد بتلصص ظاهر.
إضافة إلى ذلك ثمة تمددٌ باضطراد لافت للأفعال، والانشغال بالخارج مهيمن بصورة واضحة، وهو انشغال على حساب الافصاح عن التجربة الذاتية الداخلية. إنها تتأرجح في لعبة شكلية تستهوي الملا من البداية، بحيث يفهرس في مفتتح كتابه ما يسمَّيه «فهرست الأخطاء»، ويصيغ جملاً متفرقة تُمثّل العناوين الداخلية لقصائد الديوان. لكنّ صياغتها على طريقة السرد المتصل توحي بأنها كتبت هذا النحو عن عمد: «باتجاه الحيرة تعويان معاً، مفتاحُ الضوء يأخذك بيده، ما يراه المهرّج صرخة يخفيها الليل بين الأكتاف مستبقاً الخوف، مستنقع البحيرة ألبوم الغياب، البهلوان ظلٌّ يتبعني…».
ولكن فلننسَ قليلاً هذه اللعبة الشكلية، ولنذهب إلى ما أراده من العنوان نفسه. ما هي الأخطاء؟ أو ما هو الخطأ الشخصي الذي يحشد له صاحب «تمارين الوحشة» كل تلك الإشادة، وإلى أي مدى كانت المغامرة الروحية محفوفة بالأخطار والأخطاء على حد سواء؟ ثم ما هو الفرق أن تكون تلك الأخطاء سلوكية أو ذهنية أو روحية؟ أهي أخطاء كبرى توازي الخطايا والجنايات؟ أم سوء تقدير لا تنقصه البراءة؟
في قصائد الملا ثمة أخطاء، هي في الواقع، أقلُّ من ارتكابات، وهي لا تشبه الأخطاء التي عرفناها في الشعر الميتافيزيقي مثلاً حين يكتبُ الشاعر عن الإثم والخطيئة بوصفهما موروثاً جمعياً، لهذا يكون الاعتراف في هذا النموذج من الشعر ذا نكهة أخرى، لكننا هنا حيال أخطاء صغيرة، بالمعنى الفيزياوي، عثرات يومية ربما، نوادر، وربما حتى فكاهات. لكنه لا يوسع العدسة ليضع يومياته في الكادر المليء بحشود الآخرين وهمومهم وانشغالاتهم. هو يتحدث عادة عن أخطاء مفترضة، فيصف جمالها ويطري عليها من دون أن يسمح لنا أن نلمسها أو نراها: «لم آسفْ على أخطائي/يا ربّ/ما أجملَها من أخطاء/لم ينلها سواي/فلا تلمني/زيّنتُ بها ندمي/خرمتُ أذني/وعلّقتُ أحلاها متباهياً».
هكذا تدرج معظم قصائد الديوان لتغدو ضرباً من الإطراء الذاتي، وموضوع الإطراء الذاتي واحدة من المشكلات الفنية التي واجهت نماذج كثيرة في شعر الحداثة، ذلك أنها تستدرجه نحو الغنائية مهما حاول الشاعر التذرُّع بلغة حديثة أو مقاربة مواضيع مختلفة عما سبقها ذلك أن مستوى الأداء لا يقف عن حدود هجر بلاغات مستقرة، والانتباه إلى بلاغة أخرى، إنما يتصل بالأسلوب وهذه هي الهوية الداخلية المغايرة التي تنتج منها البلاغة الخاصة.
القصائد هي التقاطات منتقاة من مشاهد متنوعة. كأنّ ثمة كاميرا محمولة، تتحرك، وإلى جانبها لغة تصف ما يجري: «يدي ممدودةٌ إلى أغصان الطريق/ثمارها يانعةٌ وفي متناول النظر/لكنّي في عجلةٍ/من أمري/ أركضُ إلى شجرةٍ لستُ أراها/ أسرعُ نحوَ زهرةٍ لا أعرفُ اسمَها/وأميّزُ رائحتَها من بعيد».
إنها رؤية العابر المتعجِّل، مشاهد خاطفة لا تكاد تأنس إلى استبصار داخلي، والمسافة التي يخلقها الملا بين حياته الشخصية، وما يتشكل من مشاهد يومية، هي تلك المسافة الحرجة بين شؤونه الصغيرة الغائبة ويوميات الآخرين الحافلة. كأنها استعادة صور بعيدة في ذاكرة الشاعر، وأعني عالم الطفولة، وما الكتابة سوى استذكار لتفاصيل تلك الحياة التي مرت، لكننا حين ندقِّق في تلك التفاصيل المستذكرة نجدها متمثلة في شكل أساسي في عالم الطفولة وأجوائها الذهبيَّة.
السرد لدى صاحب ««سهم يهمس باسمي» يتضاد أحياناً مع الحالة الموجزة، حتى وهو يلجأ إلى التقطيع في المشهد، والتنقل المفاجئ بين أكثر من مشهد. ولعل السبب الأساسي في هيمنة هذا النوع من السرد إمعانه في وصف الخارج. فالعالم من حوله منثور، تسكنه معالم بلاغة مكانية متاحة للجميع، بلاغة تبدو مكتفية بذاتها. مما يجعلها أقرب إلى صورة فوتوغرافية لما يحدث، فتغدو أشبه بعدسة مفتوحة على نحو اعتباطي تكتفي بالتصوير. لذا فحين قلت إن العين هي سيدة الحواس في شعر الملا، فقد عنيت به هذا الوصف الفائض في القصيدة مقرونة بنعوتٍ لغوية.
يبدو شعر أحمد الملا في «ما أجمل أخطائي» مفعماً بالمشاهد الحياتية اليومية، لكنّ حياة الشاعر فيها ليست سوى ظلٍّ خافتٍ. ومن هنا فإنَّ الحديث عن جمال الأخطاء الشخصية هو في المحصلة الأخيرة صكّ براءة مسبق للشاعر، أكثر مما هو نبرة اعتراف.
(الحياة)