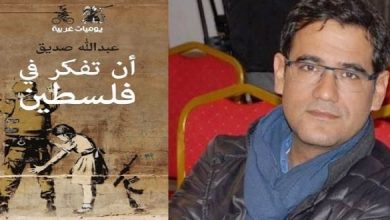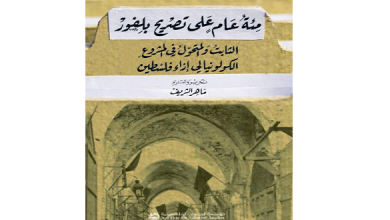وجه بيروت الطبقي في «حي السريان»
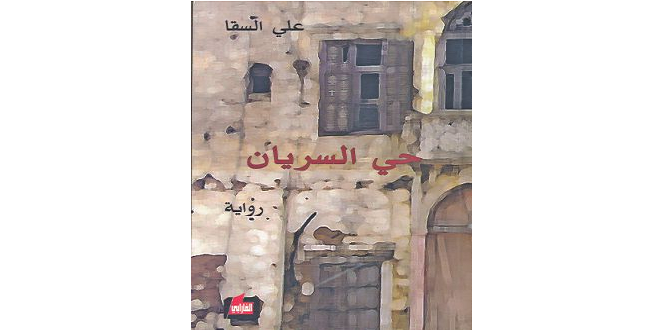
سلمان زين الدين
«حي السريان» (دار الفارابي) هي الرواية الأولى للكاتب اللبناني علي السقا، ومع هذا فهي تخلو من تعثّر البدايات، وتعكس نَفَساً روائيّاً طويلاً، وامتلاكاً واضحاً لأدوات الكتابة الروائيّة، والإمساك بخيوط السرد والتصرّف بها، والخروج على تقليديّة الخطاب الروائي.
يطرح علي السقا في روايته السؤال الطبقي في مجتمع لبناني حيث اشتعلت الحرب اللبنانية، في جانب منها، على خلفيّته، وجاءت لتفاقمه وتجعله أكثر حدّة. إنّ قيام أحياء البؤس في بعض مناطق بيروت وحولها بفعل التهجير الناجم عن الاعتداءات الإسرائيلية المتعاقبة على الجنوب أو بفعل الهجرة الداخلية الناجمة عن الفقر في البقاع، من جهة، وقيام الأبنية الحديثة والعمارات الشاهقة على مقربة من هذه الأحياء، من جهة ثانية، أدّيا إلى تناقض مكاني صارخ يعكس تفاوتاً اجتماعيّاً تعبّر عنه الرواية بالتجاور بين حي السريان، الذي يكتظّ بالفقراء ولا تتوافر فيه أدنى مقوّمات العيش الكريم، و «الجنّة الشاغرة» التي تفتقر إلى الحركة الاجتماعية وتتوافر لها أقصى المقوّمات.
وعلى هامش السؤال الطبقي، ثمّة أسئلة أخرى تطرحها الرواية، تتعلّق بالفساد والطائفية والتواطؤ بين رأس المال والميليشيات وبعض رجال الدين، وتَشَكُّل فئة اجتماعية من أغنياء الحرب الذين أثروا على حساب أوجاع الناس وآلامهم…
هذه الأسئلة تطرحها الأحداث والشخصيات الروائية والحوارات في ما بينها؛ ولا يقدّم علي السقا
حكاية تقليدية في بنائها – تبدأ عادةً من نقطة البداية، وتنمو وتتعقّد في ذروة معيّنة ثم يليها الحل- إنّما يقدّم مجموعة حكايات، طويلة أو متوسّطة أو قصيرة، لمجموعة شخصيات، تنتمي بمعظمها إلى شريحة الفقراء من قاطني أحياء البؤس. وهو يقدّم هذه الحكايات في إطار من الفوضى المنظّمة، بحيث تتناثر أجزاء الحكاية الواحدة على الوحدات السردية المختلفة دون مراعاة تسلسل زمني لهذه الأجزاء، ويكون على القارئ جمع هذا النثار ليرسم البورتريه الروائي لكل شخصية. وهذه الحكايات تتزامن، وتتماكن، وتتقاطع، وتفترق، ويكمل بعضها الآخر لتطرح السؤال الطبقي الذي يتكرّر كلازمة على ألسنة الشخصيات المختلفة، ويشكّل المنظور الروائي الذي يغلّب العامل الطبقي على ما عداه في قراءة واقع لبناني تحيل إليه الرواية، مما يجعل القراءة مبتسرة، حتى وإن كان هذا العامل يتداخل مع العاملين الطائفي والمذهبي في بعض الصفحات.
وإذا كانت أحداث الرواية مستوحاة من الواقع أو يمكن إسقاطها عليه، فإن بعض الأحداث لا تنسجم مع اللحظة الزمنية التي تُنسَب إليها. واقعة الضغط على بعض المالكين لبيع شققهم بالترغيب والترهيب مثلاً تنتمي في الرواية إلى ما بعد أحداث 7 أيار (مايو) 2008، بقرينة أنّ الاجتماع بين الحاج اسماعيل، المسؤول الحزبي، وعمر الشوباصي، النائب الرأسمالي، يحصل بعد هذا التاريخ حيث يطلب الثاني مساعدة الأول لإفراغ البيوت من أصحابها مقابل حصّة معيّنة، الأمر الذي لا ينسجم مع اللحظة الزمنية التي حصلت فيها مثل هذه الوقائع التي تعود إلى بداية التسعينات. وبغضِّ النظر عن التناسب بين الوقائع وزمن حصولها، فإنّ الرواية أرادت تعرية التواطؤ بين رأس المال الجشع وقوى الأمر الواقع على حساب حقوق الناس وممتلكاتهم.
تنتمي معظم شخصيات الرواية إلى شريحة الفقراء، وتتحدّر من أسر مفكّكة، تعيش أوضاعاً مزرية، وتؤول إلى مصائر موجعة؛ فرضيّة، صاحبة الخيط السردي الأطول في الرواية، سيّدة ستّينيّة يقودها حظّها العاثر إلى زواج فاشل، فتقع بين مطرقة زوج عاجز جنسيّاً وحماة متسلّطة ما يودي بها إلى الطلاق. وهي تحمل ذكريات حب أوّل لمحمود، ابن خالتها، الذي جاء زواجها المفاجئ من خليجي غني ليجهضه، وحب ثانٍ لأمجد، الفدائي الفلسطيني، الذي قُتِل في الحرب اللبنانية. وتعيش قلقاً على ابنها علي، وخوفاً من احتمال هدم بيتها وإخراجها منه.
أمّا علي (ابنها) فينقطع عن الدراسة، ويعمل لدي أبي ظافر الفوّال ويطعنه بسيخ في مؤخّرته دفاعاً عن النفس، فَيُلقى القبض عليه ويُوضع في مصلحة الأحداث حتى إذا ما خرج منها يلتحق بعبدالله الدادو ليعملا معاً في خدمة الزعيم المحلّي الحاج اسماعيل. وحين ينحاز علي إلى شريحته الاجتماعية، ويتصدّى للحاج وشركائه العاملين على إخلاء زاروب الشحاذين من أهله، يتدبّر الأخير أمر إدخاله الى السجن بتهمة ملفّقة.
ويتحدّر صافي، الفلسطيني الأب، ابن حي التنك، من أسرة فقيرة تُضطرّ فيها الأم إلى بيع ابنها الأكبر لعدم قدرتها على إعالته، يُوضع في مصلحة الأحداث إثر جرم ارتكبه. وحين يتصدَى لتحويل حي التنك إلى مكب نفايات يُعتقل ويُعذّب حتى الموت. ويأتي عبدالله الدادو، العراقي الأصل، يتحدّر من أسرة فقيرة، هو صبي شرس ومشاكس، يعمل في خدمة الحاج اسماعيل، ويمارس أعمال الضغط والابتزاز والتشبيح متنكّراً لأصوله الاجتماعية، ويتواطأ معه على رفيقه علي الذي تجرّأ على مواجهة الحاج ومخطّطاته، فيدس له المخدّرات في درّاجته ما يؤدّي إلى اعتقاله.
هكذا، نرى أن مصائر هذه الشخصيات هي نتاج مساراتها البائسة، وهي تتراوح بين الشيخوخة، والاعتقال، والموت تحت التعذيب، والتحوّل إلى أداة بيد الطبقة الغنية من محدثي النعمة الذين أفرزتهم الحرب.
وإذا كانت هذه الشخصيات تنتمي إلى الطبقة الدنيا، فإنّ شخصيات أخرى تحدّرت من هذه الطبقة ما لبثت أن تنكّرت لها؛ فالحاج اسماعيل صعد على ظهر الحرب والمقاومة، تنكّر لأصوله الاجتماعية ومنطلقاته الفكرية، وتحوّل إلى أداة بيد رأس المال وشريكاً له. وهو ازدواجي يتظاهر بالتديّن، فيرفض التكلّم مع أصحاب الملاهي بحجّة بيعهم الخمر ويقوم بحمايتهم مقابل المال. إنه يستخدم كلّ ما يساعده في تحقيق أهدافه، بدءاً من شبّان الحي العاطلين من العمل، وصولاً إلى الشيخ حسين، الذي يستغلّ سلطته الدينية لتحقيق مآربه الخاصّة. وهو يمارس التحريض المذهبي، ويقدّم نموذجاً سيِّئاً عن رجل الدين الذي يستغلّه السياسيّون لتلميع صورِهم. على أنّ ثمّة نموذجاً آخر إيجابيّاً لرجل الدين يمثّله الشيخ زيد الذي ينحاز إلى الفقراء، ويتصدّى للحاج اسماعيل ومشاريعه المشبوهة.
في الخطاب الروائي، يصطنع السقا راويين اثنين لروي الأحداث؛ الراوي العليم الذي يستأثر بمعظم الوحدات السردية، والراوي المشارك، فيُسند إلى رضية روي حكايتها بنفسها بالإضافة إلى ما يرويه عنها الأوّل. وهو يقطع السرد بمساحات وصفيّة ترسم الخلفيّة للمشهد الروائي، أو تصل بين مشهدين اثنين، أو تقول المشهد، كما في حادثة موت الجنرال ابراهيم الشويفاتي. إنه وصف يُعنى بالتفاصيل والجزئيّات، ويضيء الخلفيّات، ويدخل مع السرد في علاقة تكامليّة. ويقطع السرد أيضاً بتقنيّة الرسالة، فيُورد رسائل محمود وأمجد إلى رضية، وقد يقطعه بمقال صحافي (ص 394). وإذا كان كسر نمطيّة السرد أمراً مستحبّاً، فإنّ إيراد رسائل بكاملها وتوثيقها يبدوان كأنّهما لزوم ما لا يلزم، ويُثقلان كاهل النص بدل أن ينوِّعاه.
أما اللغة السردية فهي لغة مناسبة، سلسة، تستخدم الجمل القصيرة والمتوسّطة، وتشتمل على مفردات معبّرة في تراكيب معيّنة لا بديل لها، كقوله: «كش» للذباب، و «تدلق» للطعام، و«تدحش» للقمة في الفم، و«تتخصور» للبنت التي تضع يديها على خصرها، وسواها… وقد تتضمّن تعابير وأمثالاً شعبية كقوله: و «كانت عظام جدّي صارت مكاحل.» (ص62)، وقد تنحو في بعض عباراتها منحى أدبياً يلامس الشعر. إلى ذلك، لعلّ طول الرواية (447 صفحة) أدّى إلى تضارب في اسم الشخصية الواحدة، فشربل يتحوّل إلى ميشال، وحسن يتحوّل إلى علي… وعلى الرّغم من ذلك، تُشكّل الرواية بداية واثقة لصاحبها، وتثبت امتلاكه أدوات الكتابة الروائية، وتستحقّ القراءة.
(الحياة)