ناشر مصري يروّج «علماً جديداً» مرتبكاً
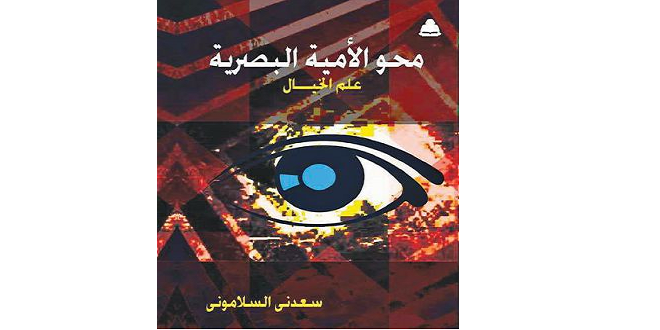
وائل سعيد
لا شك في أن من يتتبع بدايات شاعر العامية المصري سعدني السلاموني منذ تسعينات القرن الماضي، سيجد تجربة تستحق التقدير. والتقدير هنا ليس حُكم قيمة على «مُنجزه الشعري»، من ديوانه الأول «رغاوي الألم»، مروراً بمجموعاته اللاحقة: «تصبح على خير، عضم خفيف، أول شارع شمال، وديعة في البنك»، بالإضافة إلى «رواية شعرية»! بعنوان «دافنشي»، يزعم أنها أصل المسلسل التلفزيوني «هي ودافنشي»، الذي نسبته جهة إنتاجه إلى مؤلف آخر، عند عرضه العام الماضي، ووصولاً إلى كتابه الأخير، «محو الأمية البصرية – علم الخيال» (الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة). وتقييم شعر السلاموني، هو أمر مختلف عليه، ولا غبار على ذلك، رغم ترجمة بعضه إلى الإنكليزية والألمانية والفرنسية وتدريس ديوانه الأول في أحد أقسام الجامعة الأميركية في القاهرة، واختيار موسوعة ألمانيا إياه ضمن «أهم الشعراء في الوطن العربي». كل هذا في واقع الأمر يُعد كوماً واحداً. أما كتابته في «علم» يقول إنه من ابتكاره، فذلك كوم آخر، فمصطلح «محو الأمية البصرية»، ابتكره جون ديبيز منذ العام 1969، visually literacy وكتب في تعريفه: «محو الأمية البصرية يتم عبر مجموعة من المهارات المرتبطة بحاسة البصر والتي تمكن تنميتها لدى المتعلم (المستقل) من طريق الرؤية».
ما يستحق التقدير الذي قصدته في البداية هو التجربة الكفاحية»: نجار سواقي أتى من ريف المنوفية (شمال القاهرة) بعد أن بدأ تعلم القراءة والكتابة عند بلوغه السابعة والعشرين من عمره. هو اختار الشعر، ميداناً للكتابة، بعد أن تعلَّم القراءة، وقررت وزارة الثقافة المصرية استحقاقه «منحة تفرغ»، شهرية، حتى لا يشغله أي عمل آخر عن الكتابة.
تلك المُثابرة فقط هي ما قصدته بالتقدير، بعيداً من الحكم القيمي على ما تم إنتاجه بالطبع. أما أن تجود قريحته في نهاية المطاف بـ «علم جديد»، فهنا لا بد من وقفة، خصوصاً أن الترويج لذلك حدث بواسطة أكبر دار نشر في العالم العربي. كيف يتأتى لشاعر – إنجازه الشعري أصلاً محل خلاف – وضع نظرية علمية جديدة، ويجهز لها كي تُصبح منهجاً يُدرس في أكاديمية، وهو لم يحصل على أي تعليم جامعي من الأساس؟ وما علاقة أستاذ اللغة الإيطالية حسين محمود، بعلم الخيال، لتسند إليه مهمة «تقييم الكتاب»، وكتابة مقدمة له؟ حدث ذلك، رغم اتهام السلاموني بـ «السطو»، عبر محتوى كتابه المشوَّش والذي لا يزيد على 2000 كلمة، على أفكار وردَت في كتاب للباحث الجزائري معاشو قرور، عنوانه «الأمية البصرية – إشكالية تلقي الحداثة في الفن التشكيلي العربي» (دار «ميم» ووزارة الثقافة الجزائرية – 2013). فالسلاموني تحدث كثيراً عن «منجزه» هذا لغير وسيلة إعلامية، قبل أن يدفع به للنشر، زاعماً أنه بدأ كتابة تلك الكلمات منذ العام 2004!
وفي هذا السياق تم اتهامه أيضاً بـ «الـتماهي» مع بعض كتب الدكتور شاكر عبد الحميد، الأستاذ في أكاديمية الفنون المصرية، وزير الثقافة المصري السابق، مثل «الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي» (عالم المعرفة – الكويت)، «المفردات التشكيلية… رموز ودلالات» (الهيئة العامة لقصور الثقافة – القاهرة)، «عصر الصورة… الإيجابيات والسلبيات» (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت)، «الفنون البصرية وعبقرية الإدراك» (دار العين ومكتبة الأسرة – القاهرة). «كتاب» السلاموني ليس فيه ذِكرٌ لأي من هذه المراجع أو غيرها، لكنه – للأمانة – سبق أن تحدث في برنامج تلفزيوني عن أنه قرأ كتاب «عصر الصورة» لعبد الحميد، وتأثر به. ومع ذلك تظل فكرة السطو أو المُشابهة، مستبعدة، لأنه لا تصح مقارنة مادة علمية، ببعض السطور المرتبكة، المتُراصة من دون معنى أو هدف. يعرض الأكاديمي المرموق شاكر عبدالحميد، للعصر الحديث الذي هيمَنَت عليه «فلسفة الصورة»، من خلال تحليلها ورصد مستوياتها الفكرية والفنية، مُنطلقاً من مقولة أرسطو: «لا تُفكر الروح أبداً من دون صورة…»، والتي سيُحولها السلاموني إلى كلمات تراصت في شكل يوحي للوهلة الأولى بأنها «قصيدة»: «الصورة إنسان/ روح وعقل وجسد ولسان/ روح الصورة هي قرين روح الفنان» صـ51. هل ثمة معنى ما يُطال من وراء هذه الكلمات؟
تنطلق دراسة الباحث الجزائري معاشو قرور، تحديداً، من الخطاب البصري العربي في الفن التشكيلي، وإشكالية تلقي مفهوم الحداثة فيه، من خلال التأويل والتحليل، مؤكداً في النهاية أهمية التمسك بفكرة (الهوية) في مواجهة تحديات الحداثة. وفي إحدى مقالات الباحث نفسه في هذا الشأن، يقول: «يجب استباق النزعة الذرية في مجابهتها لشمولية النزعة الكلية»، وأنهى السلاموني كتابه بالقول: «حين تكتمل الدائرة يحدث الانفجار العظيم»، بمعنى أن «نظريته»، ستعيد تشكيل الأكوان، على غرار ذلك الانفجار الذي يرجح علماء أنه السر الأصلي للوجود كما نعرفه.
أكرر: الأمر يتخطى فكرة أن يكون السلاموني استوعب ما كتبه الباحث الجزائري، أو ما كتبه شاكر عبد الحميد، الحاصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن أحد كتبه في هذا المضمار. لكنه انشغل، في لا وعيه، بمصطلح «الأمية» بالذات، لأنه قاسى طويلاً من «الأمية الأبجدية»، التي لم يتخلص منها تماماً بعد، وفقاً للأخطاء الإملائية الفادحة في كتابه الذي تحمست أكبر دار نشر عربية لإصداره، حتى من دون تصحيح لغوي، لأسباب لا علاقة لها بالموضوعية أو بمعايير النشر عموماً والنشر العلمي بخاصة.
هو يقول إن كتابته هذه «مكتملة»، على الأقل من بعد العام 2004، ومن ثم فقد حاول طوال السنوات الماضية، أن ينشرها ورقياً، إلى أن تحمست الهيئة المصرية العامة للكتاب للأمر، في ظل رئاسة الأكاديمي هيثم الحاج علي، وتحمس عميد كلية اللغات والترجمة في جامعة بدر حسين محمود لتقديمها، «لعل مستقبل البشرية يصبح بها أفضل» صـ13. ومع ذلك يبقى السؤال: ما الداعي لنشر فقرات لا يجمعها منطق، علماً أنها بالكاد تملأ صفحة في جريدة لا تحترم عقل القارئ؟!
(الحياة)




