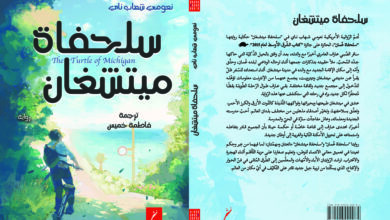(…) ولا يزال حضور الروائية العربية في المشهد الثقافي موضع تساؤل وجدل ؟!

بديعة زيدان
تختلف الروائيات العربيات، كما الروائيين، والنقاد من الجنسين، حول زخم حضور الروائيات العربيات في المشهد الثقافي العربي، وما إذا كان حضورهن يبهت بالمجمل إذا ما قارناه بحضور الروائيين العرب.
وبعيداً عما يسمى “أدب المرأة” أو “الأدب النسوي”، هناك من يرى أن لا أسماء نسوية لامعة في المشهد الروائي العربي إلا ما ندر، في حين هناك من يرفض هذا الطرح، ليقدم كل ما يراه تحليلاً أو تفسيراً لرأيه المنحاز لهذه المجموعة أو تلك .. “أيام الثقافة” تفتح الملف الجدلي بسؤال افتراضي لروائيات ونقاد من عدة دول عربية، مفاده “لماذا لا تحقق الروائية العربية حضوراً لافتاً كما يحقق الروائي العربي .. هل هي أسباب مجتمعية أم إبداعية أم غير ذلك؟”.
استيعاب للحرية .. وبعض الوقت
البداية مع الناقد والأكاديمي الفلسطيني د. إبراهيم أبو هشهش، الذي استهل مداخلته في هذا الملف الجدلي بالقول أظن أن الأمر لا يزال رهناً بالزمن، فتاريخ تحرر المرأة العربية حديث نسبيا، وسوف تستغرق المرأة بعض الوقت حتى يستوعب المجتمع وجودها الإنساني الفاعل، مضيفاً: تتوقف قراءة إبداعاتها الأدبية عموما والسردية خصوصا عن محاولات التأويل الذاتي، أي بوصفها اعترافات ذاتية تحاكم عليها الكاتبة بصفتها الشخصية، وفي أحسن الأحوال تجري قراءتها قراءة سسيوثقافية، في حين لا تتعرض كتابات الرجل عموما لمثل هذه المعايير، فهي تقرأ عادة بوصفها أعمالا إبداعية تنطبق عليها معايير الجمال الأدبي والابتكار والتجاوز…إلخ.
ويرى أبو هشهش في حديثه لـ”أيام الثقافة”، أن “بعض النقاد يميلون إلى النظر إلى السرد عادة على أنه فعل أنثوي، لأنه متحرر من القيود التي قيدت الشعر الذي كان ميدان الرجل تاريخيا، وأظن أن المرأة التي أبدعت أعظم عمل سردي في الأدب العالمي، أي ألف ليلة وليلة، وأبدعت في كل ثقافات العالم هذه الحكايات الشعبية الخالدة، سوف تحقق ذاتها في مجال الرواية، وستكون الرواية ميدانها الإبداعي الأساسي، ولكن عليها أولا أن تستوعب حريتها استيعابا كليا، وأن ينتقل القراء إلى استقبال أعمالها بوصفها نتاجات أدبية في المقام الأول، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى المزيد من السعي الثقافي، لأن الرواية ليست فعلا تلقائيا، بل معمار مركب من مكونات متعددة إنسانية وثقافية وفلسفية وسسيولوجية ولغوية، وليس كل من يكتبها الآن، رجالا أو نساء، في الواقع، مؤهلين لكتابتها، وأخشى أن هذا الإقبال المتسرع على إنتاجها، من غير امتلاك الأدوات اللازمة، سوف يصيبها بوهن جمالي مبكر يدخلها في أزمة سريعة بدت بوادرها تظهر مؤخرا في عدد هائل من الإصدارات قليلة القيمة.
زاوية مغايرة
وعلى غير العادة في الترتيب الأبجدي للمشاركين، أكسر القاعدة بترتيب النقاد أبجدياً في البداية، لتقديم مساحة نظرية تمهد للروائيات الحديث في الملف الجدلي هذا، وفق الترتيب الأبجدي لهن أيضاً.
وهنا يقول الناقد المصري د. محمد الشحات لـ”أيام الثقافة”: ينطوي السؤال على افتراض مسبق، وربما يقينيّ، يرى في إبداع الروائية العربية تراجعا ملحوظا قياسا إلى إبداع الروائي العربي، ولعل السؤال يرتكن إلى المعيار الكمّي أو الإحصائي المرتبط بالجوائز العربية والفعاليات الثقافية والأكاديمية، بدلا من اعتماده على المعيار الكيفي أو المؤشر الثقافي أو المعرفي. لكنني أنظر إلى هذا الموضوع من زاوية مغايرة تماما، خصوصا في سياق الكتابة الحديثة؛ إذ لا يمكن الزعم ببساطة أن هناك أدبًا رجوليًّا خالصًا وآخر نسائيًّا نقيًّا، أو أدبًا ذكوريًّا وآخر أنثويًّا، أو أدبًا خشنًا وآخر ناعمًا، إلى غير ذلك من مسمّيات يغلب عليها الطابع الصحافي البرّاق أو السطحي في بعض الأحيان. وكما أن الرجل هو الأقدر على تشييد سرديّته أو دراميته أو شعريته التي تنطلق من هموم بني جنسه، فإن المرأة ذاتها هي الأقدر على التعبير عن مشكلاتها الخاصة والقادرة على إطلاق صرخاتها، والبوح “روائيا” أو “دراميا” أو “شعريا” بما لم يستطع الرجل تمثيله جماليا، أو كتابته في نصوص أدبية.
وأضاف الشحات: بالرجوع إلى مدونة تاريخ الأدب العربي، نرى أن المرأة العربية عموما، والشامية على وجه الخصوص، قد لعبت دورا بارزا في نشأة الرواية العربية، في أزمنتها الباكرة، خصوصا لدى كل من أليس بطرس البستاني (1870-1926) ولبيبة هاشم (1880-1947) وزينب فواز (1860-1914)، جنبا إلى جنب رائدة هذا الاتجاه النسوي عائشة التيمورية (1840-1902)، حيث قامت الترجمة، في هذا السياق، بدور كبير في إنطاق المسكوت عنه من حياة المجتمع العربي آنذاك، في فضاء مديني صاعد يقوم على احترام خصوصية المرأة وتعزيز حركة الطباعة وانتشار الصحف والمجلات وترجمة نصوص الآخر الإبداعية؛ الأمر الذي جعل من حركة ترجمة فنون القص الحديثة على صفحات الجرائد والمجلات، آنذاك، بمثابة لازمة مفصلية من لوازم التحديث الذي انشغلت بها المدينة وقامت عليه.
وتابع: على سبيل المثال، لا الحصر، لم يتخلّف الأدب النسائي الخليجي، في أغلب تجلياته، عن إبداع النساء العربيات في المناطق الأخرى. فإذا كانت ظاهرة الإبداع النسائي العربي قد بدأت مع الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، باستثناء بعض المناطق، فإن إبداع المرأة الخليجية قد بدأ في الستينيات تقريبا بشكل متواتر، وهناك أسماء خليجية كثيرة شقّت طريقها منذ ذلك الوقت، حيث أسهم النفط في إتاحة الفرصة أمام المرأة الخليجية كي تشارك مشاركة حياتية أعمق في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية. فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن أن نذكر من البحرين: فوزية رشيد (“الحصار”، “تحولات الفارس الغريب في البلاد العاربة”، “القلق السري”)، ومن الكويت: ليلى العثمان (“المرأة والقطة”، “سمية تخرج من البحر”، “العصعص”، “صمت الفراشات”، “خذها لا أريدها”، “حلم الليلة الأولى”)، وفوزية شويش السالم (“مزون وردة الصحراء”، “حجر على حجر”، “رجيم الكلام”)، ومَيْس العثمان (“غرفة السماء”، “عرائس الصوف”، “عقيدة ورقص”)، وبثينة العيسى (“سعار”، “عروس المطر”، “تحت أقدام الأمهات”، “عائشة تنزل إلى العالم السفلي”)، ومن السعودية: رجاء عالم (“ستر”، “خاتم”، “أربعة-صفر”، “سيدي وحدانة”، “طريق الحرير”، “مسرى يا رقيب”، “طوق الحمام”)، ومن الإمارات: باسمة يونس (“ملائكة وشياطين”)، وميسون صقر (“ريحانة”، في فمي لؤلؤة”)، ومن سلطنة عمان: بدرية الشحّي (“الطواف حيث الجمر”، “فيزياء1”)، وجوخة الحارثي (“منامات”، “سيدات القمر”)، وغالية آل سعيد (“صابرة وأصيلة”، “جنون اليأس”، “سنين مبعثرة”، “أيام في الجنة”)، وفاطمة الشيدي (“حفلة الموت”)، وهدى الجهوري (“الأشياء ليست في أماكنها”)، ومن قطر: مريم آل سعد (“تداعي الفصول”)، دلال خليفة (“أسطوة الإنسان والبحيرة”، “أشجار البراري البعيدة”، “من البحَّار القديم إليك”، “دنيانا”). ولعلّ قطاعاً كبيرا من قطاعات الكتابة الروائية النسائية في الخليج يقوم على استبطان الماضي وتوظيف التراث، الأسطوري أو الفولكلوري أو حتى الديني، دون القدرة، في بعض الأحيان، على الولوج إلى الأزمات العصرية والمعاصرة، أو مساءلتها بالدرجة نفسها من قوة الطرح والتناول. وهي، إجمالا، سمة مرافقة للكتابة العربية لدى الجنسين ذكورا وإناثا: الحديث عن المعاصر من خلال الإسقاط على الماضي أو التماهي معه وسبر أغواره العميقة وجذوره الممتدة، كأننا بالفعل في زمن دائري يكرّر ذاته؛ حتى يكاد المعاصر يشبه التاريخي في جوهره وإن اختلف في مظهره أو قشرته الخارجية. ورغم ذلك، فإن هاجس الخروج من إطار الحيز الضيق الى الإطار المفتوح يبدو هاجسا بالنسبة إلى أغلب الروائيات العربيات وأيضا الخليجيات.
“ولا تخلو أمثال هذه الآثار السردية من جعل المرأة بؤرةً للحكي ومرتكزًا للخطاب السردي، ومن ثم فإنه يتم التركيز على المرأة بوصفها مضطهدة، منتهَكة الحقوق، في معظم الأحيان، ويتجلّى ذلك في التربية القاسية أو الانتهاك الجسدي أو الابتزاز العاطفيّ أو “العنف الرمزيّ” (بالمعنى الذي كان يستخدمه بيير بورديو: 1930- 2002) ، وبوصفها ضحيّة العادات والتقاليد الجائرة، ولا سيما قيام هذه الأعمال الروائية بطرق مختلفة تنهض كلها على فضح النفاق الاجتماعيّ، الذي يولّد تناقضات كثيرة من شأنها أن تُحْدِث صدعا في كيان الأسرة وأن تشقّ لحمة المجتمع”.
وختم الشحات: باختصار، يمكننا توسيع مدار السؤال الأول، بما يتجاوز الأدب العربي كله، قائلين: لماذا لا يحقق الروائي العربي حضورا لافتا في المشهد الثقافي العالمي كما يحقق الروائي الغربي؟ هل هي أسباب مجتمعية أم إبداعية أم غير ذلك؟.. والإجابة واضحة بما لا يدع مجالا للشك: هي أسباب مجتمعية (سياسية واقتصادية وثقافية)، تتصل بقضايا الحريات الكبرى والوجود الإنساني وقضايا الهويّة العربية الضائعة في عالم ما بعد الاستعمار”.
المرأة حاضرة
وبدأت الروائية العراقية أنعام كجه جي، بالرد على السؤال بجملة أسئلة: ما هو الحضور اللافت؟ .. الظهور في الصحافة؟ .. المشاركة في الملتقيات الأدبية؟ .. تحقيق مبيعات طيبة؟ .. لفت انتباه النقاد؟ .. الترجمات؟ .. الحصول على جوائز؟
قبل أن تضيف باقتضاب وتكثيف: أظن أن الروائية العربية حاضرة بقوة في المشهد الأدبي خلال السنوات العشرة الماضية، على الأقل. وبقدر ما تجتهد تنال ما تستحق.
واختتمت لـ”أيام الثقافة”: شخصيّا، لا أميل كثيرّا إلى التقسيمات الجنسية، لا في الأدب ولا في غيره.
الروائي العربي أيضاً
وقالت الروائية الفلسطينية ليانة بدر: ربما علينا أن لا نسأل السؤال بصيغة كهذه .. من قال أصلاً أن الروائي العربي يحقق حضوراً لافتاً ؟ .. هل القصد هو موجات الترحاب والتصفيق التي تلي نيل الروايات لجوائز ما ؟ .. ومن قال أن الجوائز هي المعيار الحقيقي لتقييم الحضور أو عدمه.
وأضافت لـ”أيام الثقافة”: هنالك روايات عربية أسست للروايات الأخرى ولم يسأل عنها وعن أصحابها أحد، مثلاً أين ” يوميات الإنسان السبعة ” لعبد الحكيم قاسم الآن؟ أين ” فساد الأمكنة ” لصبري موسى، وأين ” الباب المفتوح ” للطيفة الزيات، وأين روايات محمد البساطي واللبناني يوسف حبشي الأشقر والسوري هاني الراهب ؟ .. هناك أسماء كثيرة لا يسعني تعدادها في هذه العجالة.
وتابعت: أين ذهبت روايات صنع الله ابراهيم التي رسمت فكراً لمعارضة الانهيار السائد في المجتمعات العربية والتي ألهمت جيلا كاملا، ولماذا لا يقوم أحد بالالتفات الى نتاجه الآن أو تكريمه ! المسألة نسبية على أية حال.
“هنالك ظاهرة الجوائز التي خلقت وهجاً زائفاً حول حضور الروائيين والروائيات وتلك حالة مؤقتة تنتهي بنهاية الاحتفالات لأن المشكلة أصعب وأكثر تعقيداً . فما أن يتم احتفال إزاحة الستار حتى ينسى الجمهور ما جرى ولا يتذكره إلا نفر محدود ربما قرؤوا الكتب أو لم يقرؤوها”، شددت بدر، قبل أن تختم: المشكلة الأساسية أن ثقافة القراءة اختفت نهائياً من العالم العربي، وبالتالي فإن أكثر رواية توزيعاً لا تصل الا لبضعة آلاف بين عشرات الملايين .. والمشكلة الثانية أن الرقابات العربية والقيود على تنقل الكتب والضرائب الباهظة حدت من انتشار الكتاب أصلاً، والثالثة أن معظم أصحاب دور النشر أميون ويعنيهم الربح التجاري، وهم لا يقومون بالعمل الجدي على انتشار الكتب ما لم يكن من ورائها ربح ما، عداك عن قنص حقوق الكتاب وتبديدها تحت أعذار زائفة.
المشكلة في الانتشار
الروائية الفلسطينية ليلى الأطرش قالت بدورها: لا اعتقد بأن الروائية لا تحقق حضورا لافتاً عربيا أو عالميا بالنسبة للروائي العربي .. كلاهما لم يحقق الحضور العالمي للأسف.
وتساءلت: بعيدا عن نجيب محفوظ كم يمكننا أن نطلق لقب كاتب عالمي على روائي عربي؟ وإذا كانت الترجمة إلى اللغات العالمية هي المقياس فكثير من الكاتبات العربيات ترجمن إلى عدة لغات، وهناك أسماء كثيرة استطاعت ومنذ ظهورها أن تكون اسما عالميا، مثل نوال السعداوي وآسيا جبّار وفاطمة المرنيسي، صحيح أن الأخيرتين كتبتا بالفرنسية لكنهما عربيتان.
وأضافت: أعتقد أن المشكلة للروائي والروائية العربية هي أن الترجمة لا تحقق الانتشار المطلوب، بمعنى الطبعات الشعبية الرخيصة.. كم من كتابنا من الجنسين يمكن مقارنته بانتشار باولو كويللو أو إليزابيت ألليندي في العالم العربي ناهيك عن العالم.. إذن المشكلة في الانتشار ولا يمكن الاعتماد على مقياس الترجمة وحده رغم أهميته، ليكون الكاتب عالميا. أما على الصعيد العربي فإذا كان المقياس هو الجوائز العربية، فهو مؤشر غير دقيق عن حضور الروائيات لأن بعض هذه الجوائز تخضع لشروط ليس الإبداع أساساً فيها.
وشددت الأطرش: أعتقد أن الروائية العربية حظيت منذ نهاية التسعينيات بتقدير وتكريم في المحافل الأدبية العربية، بدأت بسوسة التونسية حيث بادرت بملتقى المبدعات العربيات تبعتها اسفي المغربية ثم لبنان. ولا يمكن حصر عدد المؤتمرات والندوات وحفلات التوقيع التي أقامتها المحافل الأدبية العربية احتفاء بالروائيات. كما لا يمكن إغفال دور الجامعات في إقامة الندوات والتعريف بالروائيات وتوجيه طلاب الدراسات العليا لتقديم رسائلهم عن منجز الروائيات، المشكلة التي يواجهها الروائيون والروائيات هي سهولة النشر، حتى أغرقت الأسواق بكثير من المحاولات التي ليس فيها من الأدب إلا جرأة صاحبها على الباطل بادعائه أنه روائي. وفي ضعف النقد ودوره في كشف الغث وتقدير السمين، فمعظم النقد العربي للأسف يعاني من أمراض الثقافة العربية، الشللية والمحاباة وتكريس أسماء بعينها بل وقلة المتابعة للجديد، مع فقدان بعض الملاحق الثقافية لدورها النقدي وتصحيح المسار.
مجتمعات متخلفة وكيد فاشلين
وتساءلت الروائية السورية لينا هويان الحسن: كيف سيسمح للروائية ان تثبت حضورها بذات السهولة المتوفرة أمام قلم “الروائي” في مجتمعات غارقة بالتخلف والأمية إلى ما فوق الأذنين؟!
وأضافت لـ”أيام الثقافة”: عندما سلكت طريق الأدب الوعرة لم أعتقد أنني سألاقي ما لاقيته من عقبات وكمائن وألغام ومتفجرات كما توقعت. غير مسموح للمرأة أن تكون كاتبة كما للروائي، يكفي أن ندس بعض “الأيروتيك” في نصوصنا حتى نتهم بشتى الاتهامات المشينة، روايتي “ألماس ونساء”، مثلا، اتهمت أنها رواية تروج للعهر بسبب مناوشتي للعلاقات الحميمة بين الرجل والمرأة، والمشين بالأمر أن الأقلام التي تزعمت الهجمات على كتاباتي هي أقلام نسائية؟!
وعادت الحسن لتتساءل: من يفسر لي هذا الاستلاب والحمق؟! أما نازك خانم فقد حظيت بنقمة فظيعة من قبل النساء قبل الرجال، لم نزل “نحبو” في عالم الأدب .. على الروائية أن تكون جاهزة لسماع شتى الأقاويل عنها وعن أدبها، فالاتهامات جاهزة من الجميع، نحن مجتمعات تخاف من الأدب، من الكلمة .. على الروائية أن تتهيأ لأن تكون بنفسها جيشاً جراراً لتستطيع أن تواجه “النقاد”، لأن “النقد” هو الوسيلة المتبعة لاغتيال الأدباء كما يمكن لبعض الصغار أن يتوهموا.
ولفتت: شخصياً تعرضت لهجمات “بعوضية” من أقلام الصحافيات المختبئات وراء لافتة “النقد”، أي على كل كاتبة تسجل حضورا ًلافتاً أن تتهيأ للأقلام الناقمة والغيورة والتي فشلت بإثبات حضورها إلا عبر المقالات المفبركة .. سأضرب لك مثالاً، لقد تعرضت لهجمات متكررة من قبل كاتب روائي فشل باقتناص القراء فراح يصب جام غضبه على رواياتي.
وعادت الحسن لتتساءل: كيف يقبل المشرفون على الصفحات الأدبية نشر مقالات كيدية؟ .. كل الروائيين الذين فشلت رواياتهم بالوصول إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر نعتوا روايتي “ألماس ونساء” بشتى الأوصاف النابعة من الكيد والغيرة.، كن ذلك كان بمثابة “بهارات” لازمة لشحذ همتي، لأكتب المزيد.
وختمت بالتأكيد: على الروائية المصرة أن تكمل طريقها أن لا تلتفت لما قد يُكتب عنها، عليها أن تنظر إلى الأمام وتكترث فقط لعدد القراء.. حالما تُكتب مقالة “لئيمة” عن أحد نصوصي تقوم أسراب البعوض والذباب “بمشاركتها” على “السوشيال ميديا”، وذلك يدل على حجم الوجع الذي يسببه حضور النص .. إنه المؤشر الذي يدل على حقيقة الحضور.
خارج النص الأدبي
وشدت الروائية المصرية منصورة عز الدين في بداية حديثها لـ”أيام الثقافة”: لا يستهويني كثيراً الحديث عن أدب للمرأة بمعزل عن المشهد الأدبي العام، وبالتالي أحاول قدر الإمكان تفادي الكلام عن أوضاع المرأة الكاتبة أو خصوصية تجربتها، كما أتفادى الحديث عن جماعة ما أو فئة ما ككل مرتبط بسمات وخصائص بعينها، لأن الأساس في الإبداع هو الفردية والاختلاف. لذا يصعب عليّ مناقشة مكانة المرأة الكاتبة في المجمل، كما أعترض على الفرضية القائلة أنها لم تحظ بنفس مكانة الرجال، فالمكانة أو الشهرة أو التلقي أشياء خارج النص الأدبي نفسه.
وأضافت: لو تكلمنا عن نصوص وكاتبات بعينهن سنجد أن الكاتبات العربيات بينهن من نجحن في فرض أسمائهن وإبداعاتهن بقوة، إذ لا يمكن الحديث عن أدب عربي معاصر دون الالتفات لتجربة هدى بركات مثلاً أو رضوى عاشور أو إيمان مرسال وهذه مجرد أمثلة.
وأكدت عز الدين: الفكرة الأساسية هنا، هي أن الاهتمام الإعلامي، في عالمنا العربي، ليس من شروطه الجودة الأدبية بالضرورة، ففي الغالب تحصد الأعمال الخفيفة أو المتوسطة اهتماماً ورواجاً أكبر بمراحل من الأعمال الجادة المركبة، وهذا أمر يؤثر بالسلب على الكتاب الجيدين رجالاً ونساءً. لكن من ناحية أخرى، هناك بعض الظواهر المرتبطة بما يُطلق عليه “أدب المرأة”، منها: أحياناً ما تتسم الكتابة النقدية عنها بنوع من الوصاية الأبوية غير المبررة ولا المفهومة. وقد تحدث مجاملات مرتبطة بتلك الوصاية انطلاقاً من التعاطف مع ما تكتبه المرأة باعتبارها مهمشة تاريخياً. وعلى العكس من ذلك، قد نلمس تحاملاً على كتابة المرأة في المجمل، وميلاً لوسمها بسمات نمطية مفترضة دون الحكم على النص من داخله.
وختمت: عن نفسي مللت من الأسئلة المكرورة حول النسوية مثلاً، ومن تحليل أي نص انطلاقاً من جنس كاتبته بغض النظر عن أفكار النص ورؤى شخصياته. ليس هناك مثلاً من يسأل كاتبا عن السبب في أن معظم شخصيات روايته رجال، أو سبب اختياره أن يكون راوية امرأة ! لا أقول إن الجميع يفعل هذا، لكنها ظاهرة مسيطرة، كما مللت من إصرار بعض النقاد والكتاب على التعامل مع الكاتبات كأنهن ينتمين إلى “غيتو” ضيق داخل مجرى الكتابة العام.. هذه الظواهر على اختلافها، قد تسهم في تحجيم حضور الكاتبات العربيات.
النساء أنفسهن
ووفقاً لما تراه الروائية السورية مها الحسن، في ردها على سؤال “أيام الثقافة”، فإن “السبب الأساسي برأيها يعود إلى نظرة مجتمعاتنا الشرقية الدونية إلى المرأة، حيث يعتقد السواد الأعظم في العالم العربي، أن المرأة “جناح قاصر”، لا يرقى إلى سوية الرجال ومهارتهم.
ولهذا، قالت الحسن، “تنسب للنساء أعمال محددة نمطية تتلخص في المطبخ والزينة وتربية الأولاد، وتُنسب للرجال الأعمال الأكثر قيمة وأهمية، ومسؤولية. وهذه المعاناة المفروضة على الكاتبة، لا تقتصر فقط على الأدب، بل تتجاوزها لاختصاصات أُخرى، خاصة في السياسة، حيث تطالب النساء بضراوة بالكوتا، كتوجّه ديمقراطي، وهو برأيي أقل بكثير من مستوى المساواة”.
وأضافت: المسألة تتعلق بالثقافة التي نتلقاها منذ التربية، لنأخذ مثالاً من داخل العائلة الواحدة، وأنا أتحدث بالعموم، وأدرك وجود بعض الاستثناءات، لنفرض أننا في نفس العائلة، لدينا ابنان، صبي وبنت، على أبواب الثانوية العامة، ستتركز كل الأحلام على الصبي، ليخرج طبيباً أو محامياً أو، أو، أو… بينما شهادة البنت ليست في نفس الأهمية، لأنها في الآخر، ستذهب إلى المطبخ والحمل والولادة، كما أنها ستذهب إلى بيت الزوج، وينصبُ نجاحها في خانة الزوج، أما الصبي فهو حامل اسم العائلة.. لهذا تجتهد مجتمعاتنا في إعلاء قيمة الصبي، وتصعد هذه النظرة التقليدية التي تشتغل عليها الأم أكثر من الأب أحياناً، لتشمل مستويات أعلى من أداء المرأة: في الكتابة والسياسة والقضاء.
وختمت: أرى أن أكثر خصوم المرأة في هذا المجال، وأقلّ المعترفين بها، هن النساء أنفسهن. وضمن هذا الاستقصاء، حول عدم حضور نص الكاتبة، أكثر من حضور نص الكاتب، فإن الكاتبات أنفسهن، برأيي، يمارسن هذا التمييز ضد نوعهن، وضد بنات جنسهن، أكثر من الكتّاب الذكور، لعمق إحساسهن لا بدونية نظيراتهن فقط، بل بدونيتهن هن أنفسهن، وبتفوق الرجل عليهن خارج الكتابة، وداخلها.
مشروع حياة
وبدأت الروائية هدى حمد من سلطنة عُمان، بالقول: لا أدري حقا إن كانت هنالك إحصائيات وأرقام تشير إلى أن المرأة أقل حظاً من الرجل أم أن ذلك مجرد توقع وتخمين. بل يتبدى لي وليس على سبيل المبالغة، أن المرأة تلقى من يهلل ويكبر لها أحياناً أكثر من الرجل، ولأسباب خارجة عن إمكانيات النص! ولكن لو حصل حقا وكانت المرأة أقل حظاً.. فأظن أن المسألة رهن أسباب مختلفة.
وحول الأسباب، قالت حمد: عدد النساء اللواتي يكتبن أولا قليل جداً قياساً بعدد الرجال، كما أن النساء اللواتي يكتب لهن الاستمرارية ضمن مشروع منتظم ومتصاعد ناحية النضج والفهم وتطور الوعي بالكتابة هن الأكثر ندرة.. سيكون لدى المرأة الكثير من الأعذار غالبا: العمل، الزوج، المجتمع، الأبناء، بينما الكتابة هي عمل أناني يتطلب الإخلاص التام لكي يثمر.
وأضافت: وفي الحقيقة.. لا أدري مدى قدرة الأسباب سابقة الذكر على وأد الكتابة حقاً .. الأمر بالتأكيد يختلف من امرأة إلى أخرى ومن بيئة إلى أخرى، ولكن من وجهة نظري لو كان الشغف حقيقياً وعميقاً لما أمكن وأده وحصاره وقتله.. بالتأكيد علي أن اعترف أن المجتمعات العربية إلى الآن لا تجد كتابة المرأة أكثر من ترف فائض على الحاجة، والأمر ينطبق على الرجل أيضاً وإن كان بدرجة أخف وطأة، ومن جهة أُخرى .. النقد لا يجد أكثر من منهج “النسوية” ليوقع المرأة الكاتبة في فخاخه، وكأن مناهج النقد الأخرى ليست على مقاسه.. إلا أن السؤال الأهم : إلى أي حد المرأة مستعدة لإشباع أنانية الكتابة! الأمر معقد بعض الشيء ويتطلب الدراسة وحضور الأرقام.. ولكن أيضا لماذا صمدت أسماء روائيات عربيات وغابت أخرى. من خدم هذه الأسماء ومن أقصى الأخرى!! ثم ماذا نريد للكاتبة… أن تكون ضمن مجموعة “البيست سيلر”، الأكثر مبيعاً، لكي نقول أنها نجحت مثلاً، أم نريدها أن تكتب عملاً يزدهر في كل قراءة -وإن كان أقل جماهيرية !!
وختمت حمد الملف بقولها: لا يمكننا النظر للأمر من الخارج ..ينبغي التوغل عميقاً قبل أن نلقي أحكاماً عابرة .. من وجهة نظري: الكاتبة التي تمتلك الموهبة أولاً، وتنظر للكتابة كمشروع لحياتها ثانياً، وليس كتسلية جانبية .. الكاتبة التي توازي دوماً بين كفتي الحياة والكتابة فلا يستقيم أحدهما دون الآخر، من المؤكد أنها ستصل يوماً ما إلى ضفة المتلقي الذي يعي إمكانياتها.
(الأيام الفلسطينية)