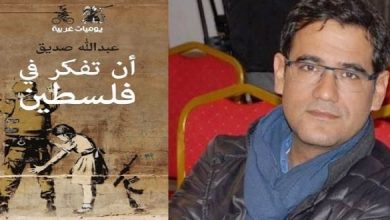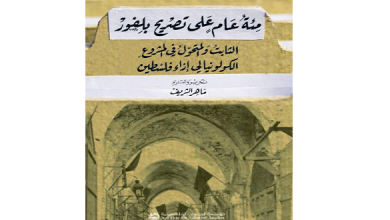جغرافية المتاهة في: «ثلج مريب على جبهة الحطاب» لرشيد المومني

محمد العرابي
ألم الكتابة؛ مكابدةٌ توشك أن تكون الوحيدة التي تترسَّب في نفس قارئ ديوان الشاعر رشيد المومني: «ثلجٌ مريبٌ على جبهة الحطاب» (دار النهضة العربية بيروت 2009)، لا الواقع هنا ولا الفكر يمكن التعويل عليه. الأثر باختلافه عن الكلام وعن الفهم، باختلافه عن الصوت والإنشاد، ميزة عصور شعرية عربية طويلة، هو المفهوم الذي في إمكانه إضاءة كثافة نص منفلت من كل عقال، ليس نتيجة قصور في استعدادات القارئ وآلياته التأويلية، كما يمكن أن يسود الانطباع للوهلة الأولى، بل لأن شعرية رشيد المومني في هذا الديوان تنزع إلى شطب ذاتها باستمرار، بما يقوِّض كل فعل للقراءة مطمئن لقناعاته أو للمترسِّخ منها على الأقل. وبذلك تستمد هذه الشعرية شرطها الأساس من إمكانية تحلُّل جميع المدلولات التي تستقي وجودها من التركيب أو من نحو مستقرٍّ للخيال. رهان هذه الشعرية أن يتفشَّى المحوُ كالوباء في عقول الجميع وفي بداهاتهم، أي «أن يصيبَ داءُ المحو شمسَ القطيع، في لوحة غير مكتملة»، أن ينبثق من بياض المحو، من اللاشيء تقريبا، أثرٌ يكون «بلَوْن لُؤم الحقيقة»، وفي مكان آخر بلون «لؤم الشمس»:
«صوتُ البياض/ أمسَى بلون لؤم الحقيقة/ أرهفَ من خيال الظل/ ثم لا شيء/ سوى أثرٍ / بعد محو».
مداخل عديدة تستند إلى مفهوم الأثر يمكنها أن تسعفنا في تعقُّب ملامح هذه الشعرية، كهذه الشمس التي تلقي على الكون بخيوطها الضوئية الكاشفة/المُعمية في آن، ليخلَّفَ لنا لونٌ محايدٌ «البياض». النظر إليه، للوهلة الأولى، يمكِّننا من التعرُّف على مظاهر الأشياء والموضوعات المقذوفة خارجا عنا، لكن التحديق في هذا البياض، وعلى الأصح، الإصغاء لألوانه وطبقاته العميقة الحافَّة، يُنبئنا بأن كلَّ ما زودنا به الخارج موسومٌ بالختل والمراوغة، ما يدعونا إلى إعادة قراءة هذه الأشياء، وهذه الوقائع آخذين باعتبارنا اللُّؤم الملازم لكل حقيقة. هكذا، يوكل للمحو أمر إنهاء شمس القطيع، الشمس المكتملة التي لا يكدِّر صفاءها شيء والمطمئنة إلى فكِّ بداهات الأشياء والحقائق، لتحلَّ محلها شمسٌ ملتوية ماكرة تخفي أكثر مما تبرز، في فضاء غير مكتمل، برزخي بين الضوء والعتمة، أرهف من خيال الظل، بما يجعل من نجمة النهار أضواءً تُعشي أبصار الإنسان الصاعد من مغارة أفلاطون إلى سطوع الحقيقة. وبذلك فهي تقرِّب شمس رشيد المومني من شمس الشاعر الفرنسي بول فاليري في قصيدته الشهيرة: «مسوَّدة أُفْعُوَان» المنشورة سنة 1921 حيث تُتَّهم هذه الشمس، بأنها، من شدة سطوعها تحجُب القلوبَ عن معرفة «أَنَّ الكَوْنَ لَيْسَ سِوَى خَلَلٍ فِي صَفَاءِ اللَّا- كَيْنُونَة» حين يُسمِّيها بـ»سُلْطَانَ الظِّلَالِ المَجْبُولَةِ مِنْ لَهَب».
وفي بيان العتبة نقرأ: «ثلجٌ مريبٌ على جبهة الحطاب»، شعارٌ مربكٌ طرفاه الماء والنار، الثلج والحطب. الثلج ماء أحاله البرد نُدَفاً بيضاء تكسو وجه الأرض، تُهوِّم على جبهة الحطاب. وهو ثلج غير مقيم، آيلٌ للذوبان. يعزِّز هذا المنحى مادة «حطب» الموجودة في جذر كلمة «الحطاب»، بل أكثر من ذلك: «ليس ثمةَ / غيرُ حطبٍ مُشتعلٍ / يتربَّص بالهبوب / وصمتٍ / تضجُّ ظلالُه / بألسِنةِ المجوس».
كيف نفهم هنا إذن هذا الصمت الصاخبة ظلاله، وهي تلهج بألسنة نيرانها المجوسية من دون هذا الاشتقاق من الشمس، التي رأينا أنها تصبغ دلالات غير مألوفة على موادَّ كالحقيقة، والبياض، والصمت، والأثر، بل وعلى الشمس نفسها التي لا تضاهيها سوى هبة السماء السخية بثلجها المشتعل: «أغدقت علينا السماء/ كل ما في أفرانها السخية/ من بَرَد الحِمم».
فعل الريبة ليس بدون دلالة في سياق هذه الشعرية القائمة على المحو، فاسم الفاعل «مريب» مفتاح آخر يضيء كامل الديوان. فهذه البؤرة من عدم الاطمئنان إلى شيء، من مفاقمة الشكوك ومحو الأثر السابق ترجئ دوما مجيء المعنى ورسوخ الفهم وتلقي بالحيرة في روع القارئ. فعل الجملة المأخوذ منها العنوان «خيَّم»: «يُخيِّم ثلجٌ مُريبٌ على جبهة الحطاب»، يلقي بظلال كثيفة على هذه الريبة ويجعلها تتسامى في المحو والإرجاء. لنجد أنفسنا، بحسب توصيف الشاعر رشيد المومني نفسه إزاء «جغرافية ملتبسة ومنفلتة لا يمكن أن نسميها بغير جغرافية المتاهة. عتبة مغرية بالعبور لأنها تهبنا فرحة السفر إلى المجهول، وفي الوقت نفسه غير آمنة ما دامت تهدد بفقدان المرئي واحتمال مكابدة رحلة اللاعودة». (ضوء الأيقونة ولهيب الحرف، قراءة في التجربة التشكيلية لرشيد المومني). تواتر كلمة متاهة التي يفتتح بها رشيد المومني مؤلَّفه يعطي لهذه الكلمة امتياز رسم الملامح التي سيكون عليها الديوان. ولتقريب هذه الجغرافيا السديمية وانتزاعها من نص الكون لتبدو في شكل أثر يتناوس بين التشكُّل والامِّحاء، فقد قَرَن الشاعر المتاهة بالهشاشة (ليس اعتباطا أن تحمل القصيدة الأولى من الديوان عنوان «تقشير الهشاشة»)، أي بأكثر الصفات رهافة وقابلية للتحول حتى لتغدو ديمومتها في هذا التحول بالذات. نقرأ في مستهل الديوان: «في الطابق العاشر/ من صمْتِ المتاهة/ أعْني/ داخلَ لُبِّ الهشاشة بالذات / خوَّضْتُ بالكفِّ / ماءَ وَرْدٍ/ دَوْزَنتْهُ الجنَّة لي/ واختصرتُ العَرْصةَ / في فاكهةٍ».
للمتاهة طبقات يلفُّها صمت، الصمت الذي رأينا أنه يشبه «صوتَ البياض» الـ»أرهف من خيال الظل». والصمت في الكتابة هو حتما البياض، أي تلك «المساحة المحرَّرة ذهنيا» بتعبير مالارميه، ولكونه كذلك، أي مساحة حُبلى بكل الإيقاعات الداخلية يجعل الشاعر المتاهة تتوزَّع بين الرغبة والألم، وتجد في كلمة الهشاشة إبدالها. من معاني الهشاشة في لسان العرب: الرخاوة واللِّين وسرعة العطب، ولكن أيضا الفرح والاشتهاء، وهو ما يؤهل الهشاشة تبعا لذلك لأن تحمل الآثار جميعها: من كل ما يهدِّد الوجود إلى انبثاقه في ذروة الامتلاء. هكذا فداخل هذا الكون المهدد بالبياض والصمت، بالفناء والاندثار تتوهج الكينونة بماء الورد الموقع بأنامل السماء لتدرك الذات رغبتها وتطفئ شهوتها بالفاكهة فقط عوضا عن العرْصَة، وبالبذرة بدلا من الغابات.
الخوضُ في الطبقات اللامرئية للمتاهة: «عند المتاهة / كذَب التاريخ على الماء»، «نُقطة بيضاء تماما/ تطوف حولها الهشاشة»، «على صدري/ وفي لبِّ هذه الهشاشة دائما / المتاهة تحلم بالنقطة»، يدفعُ الشاعرَ إلى التساؤل حول المدَيات القصوى التي قد تصل إليها تجربته الداخلية: «إذن ما مآل المتاهة / في عمق هذه الهشاشة؟»، لندرك بأن الأمر كلَّه كان يُخاض في عمق تجربة الكتابة: «في عمق الهشاشة /غير بعيد عن دار المجاز»، حيث الكتابة تمحو كل الآثار بقوة المجاز وحدها، بقوة المجازات الليلية التي تخلق بلا نهاية شموسا تفضح كذب التاريخ، واطمئنانه للكلام المتناغم مع ذاته لندخل ثانية «غابةً»، متاهةً جديدة، تلوح من بين أشجارها الملتفة وانفراجاتها المؤقتة طرائد كتابة بكر، لكن من دون ادعاء هذه المرة لمعرفتها المسبقة بأنها تحمل معها لوثة ولؤم الحقيقة:
« تطلُّ من مجازات الليالي/ كي تُدَوْزِنَ ما أهدتْهُ الجنة لِي/ حينما كذَب التاريخُ عليَّ/ وحرَّف عُشَّ الكلام/ إلى غابة تتصايحُ فيها فرائس الريح/ بحثاً عن حروف.
أي بحثا عن كتابة ستغدو هي بدورها، عما قريب، في شعرية رشيد المومني، آثارا منذورة للمحو.
(القدس العربي)