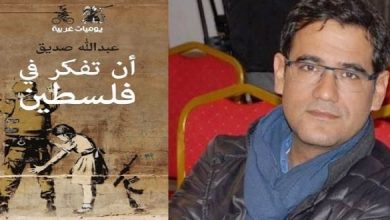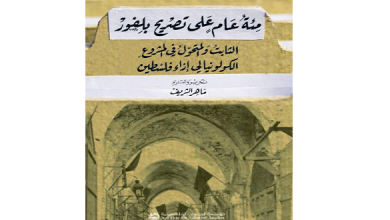كتاب «القص والماليخوليا» لعادل خضر: بحث في المواضيع الضائعة

سلمى العطي
صدر عن الدار التونسية للكتاب مؤلف عادل خضر ”القص والماليخوليا في الحكايات والمواضيع الضائعة (مقالات في التأويل القصصي) ضمن سلسة وشوم التي يُديرها صاحب الكتاب وهي سلسلة أدبية سيميائية تهتم بالسيميائيات والأدب والميديولوجيا والتصميم.
اختار المؤلف أن يفتتح كتابه بمقولة لجون فرانسوا هاميل يقول فيها ”منذ آلاف السنين بدأ التقليد السردي الغربي يُعيد مع كل قص تمثيل هذا المشهد التأسيسي الذي ابتعدت فيه الآلهة حاملة معها الأبدية، مخلفة للبشر زمنا يُمزقهم دون هوادة. فإن كان القص بطبعه ماليخوليا فلأنه ما برِح يُعيد عبور هذا الخسران الأصلي وهو يحاكي”. يمثل هذا القول شهادة بأن الماليخوليا ظاهرة متأصلة في القص منذ زمن تليد. فما هي الماليخوليا؟ وما طرائق حضورها في القص؟
إذا تأملنا تراثنا العربي سنجد أن القدامى اعتبروها مرضا يستوجب العلاج. وهذا ما يُفسر حضورها في كتب الطب فقد درسها مثلا إسحاق بن عمران في مؤلفه ”مقالة في الماليخوليا”، مبينا أن من أعراضها الهلوسة والهذيان والاكتئاب. وتناولها أيضا ابن سينا في ”القانون في الطب” مُبرزا تعلقها بالفقدان والخسران كفقد المحبوب. ورصدنا في السجل الطبي العربي تواضعا على اعتبار الماليخوليا ناتجة عن ”الخسران” الذي يُعد مفهوما مركزيا في الدراسات المهتمة بهذه الظاهرة، ولذلك استهل المؤلِف كتابه برصد العلاقة بين الخسران وحكايات الأشياء الضائعة. فقد اتفقت الرؤى القديمة والحديثة للماليخوليا على قيامها على عنصرين ثابتين هما، حسب المؤلف، ”انسحاب موضوعها” و”انطواء الأنا على نفسه” أي العزلة. فهي إذن ظاهرة نفسية بالأساس تظهر علاماتها على الجسد فتسقمه وتهلكه. وهذا ما يفسر اهتمام علماء النفس بها كجاك لاكان وسيغموند فرويد، الذي خصص لها مقالة بعنوان ”الحداد والماليخوليا” بين فيها أن الماليخوليا تُشبه الحداد، في كونها ردة فعل على خسران الموضوع المحبوب، لكن ما يُميز الحداد عن الماليخوليا أن الموضوع لم يمت بعد، لكنه ضاع بوصفه موضوعا محبوبا.
ويُقدم المؤلف في هذا السياق مثال فسخ الخطوبة. وقد توصل فرويد أثناء معالجته لهذه الظاهرة إلى أن المريض نفسه لا يقدر على تحديد ما فقده من الموضوع الضائع، وهو ما دفعه إلى اعتبار أن الماليخوليا في نهاية الأمر مرتبطة بخسران موضوع غير محدد وضياعه. وتضمن الأدب، باعتباره تعبيرا عن هموم الذات، حكايات ماليخولية، مدارها المواضيع والأشياء الضائعة، وعبّر عنها بالقص في خطاب أدبي فني. فبين القص والماليخوليا وشائج قربى، وعلاقة جدلية متجددة تجدد الشعور نفسه. فالماليخوليا تخلق القص و”تصنعه” فيكون موضوع الحكاية، والقص ضرب من الأدب يعبر عن الموضوع الضائع بفعل الحكي، ففن القص بطبعه ماليخولي شاهد على الضائع، وهو ما توصل إليه عادل خضر في اعتباره فن القص ”ممارسة ماليخولية”، لأن له علاقة بمفاهيم الحداد. ويفسر هذا الارتباط قائلا ”هذا التحول من الحضور إلى الغياب هو جوهر عمل الحداد، حيث يضحى الغائب في مرتبة الفقيد، بحيث تغدو القصة ضربا من الانفصال عن هذا الذي ولّى ولن يعود إلا بتجديد ذكراه، ولكن يمكن لعمل الحداد أن ينقلب في حال فشله إلى ضرب من الجنون أو الذهان، يسمى الماليخوليا”.
وتظهر العلاقة بين القــــص والماليخوليا في أربعة مستويات مثلت أبواب الكتاب وهي: الماليخوليا بماهي تجريد لموضوعها الضائع، الماليخوليا بما هي سد لموضوعها الضائع، الماليخوليا بما هي تمديد لموضوعها الضائع، والماليخوليا بما هي تدمير لموضوعها الضائع.
يبحث المؤلف في كل مستوى من هذه المستويات عن طرائق تناول القص العربي للماليخوليا، وكيفيات تعبيره عن الموضوع الضائع، انطلاقا من حكايات من النثر العربي القديم مثل «نوادر الجاحظ»، و»الفرج بعد الشدة» للقاضي التنوخي و»الروض العاطر في نزهة الخاطر» للشيخ النفزاوي و»ثمرات الأوراق» لابن حجة الحموي والحكايات الشعبية العربية فضلا عن نماذج من القص الحديث كقصة «خليفة الأقرع» للقاص التونسي بشير خريف.
يدعونا هذا الكتاب إلى البحث في البُنى العميقة التي تحرك آليات القص، اعتمد فيه صاحبه عادل خضر المطرقة النيتشوية ليحطم التصورات السائدة للماليخوليا باعتبارها مجرد سقم يظهر في المستوى التاريخي الواقعي، يعبر عنها الأدب باعتبارها ظاهرة إنسانية من جملة الظواهر الأخرى، لنكتشف مع المؤلف أنها عنصر مؤثر في الخطاب الأدبي الرمزي التخييلي، باعتبارها محركا للقص. فلئن اعتبر بول ريكور أن القص حارس الزمن من النسيان، فإن المؤلف يؤصل الماليخوليا في ”الفضاء الأدبي” بعبارة موريس بلانشو، مثبتا أن القص حارس للضائع والمنفلت والزائل بالشهادة والتكرار وحكي الماليخوليا ومُحاكاتها. فليست الماليخوليا ”ترف الأرواح الفقيرة” وحسب كما سماها الأديب الفرنسي هنري دي مونثيرلان، بل هي في وجه من وجوهها ترف القصاصين والرواة… ولعل هذا ما يُبرر إعلان محمود المسعدي أن الأدب في جوهره ”مأساة أو لا يكون”.
إن هذا الكتاب محاولة لكشف الحُجب عن المواضيع الضائعة التي لا تنمحي بل تبقى راسخة ثابتة، رغم صولات الزمن، ‘فهي شبيهة ”بالوُشوم”، وهو الاسم الذي اختاره صاحب الكتاب للسلسلة التي نُشر ضمنها هذا البحث.
وتكمن مزية القص في استعادة الضائع في إطار الحبكة القصصية، أو المحاكاة، ليُبعث من جديد، كعنقاء من رمادها، فإذا بالمواضيع الضائعة تتشكل في صور شتى في الحكي، ضرب المؤلف منها مثل الكفن والرسالة الآتية في المنام، والمُداس الذي كلما ألقي بعيدا عاد… فما القص إلا وسيلة يرجع بها العائد بالحكاية، ليعود كما يقول عادل خضر كعودة المكبوت ”لا في شكل أليف باعث عن القلق، بل في شكل كارثة”.
(القدس العربي)