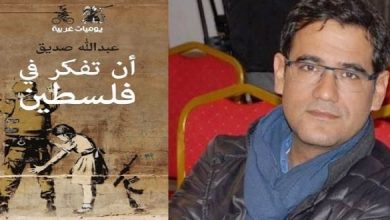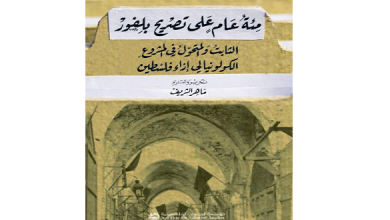رواية «لاجئ من أربيل إلى أمستردام»: بوابات الحلم وجدران الواقع

أحمد مولود الطيار
«إني أفقد حياتي ببطء يا والدي، يا إخوتي.. أوروبا لا تشبه أوروبا التي سمعنا عنها. أوروبا شائكة وقاحلة. لا شيء يحيا في أوروبا بكثافة مثلما يحيا الرفض، ولا شيء يموت أسرع من اللجوء. يا أبي.. صباح خليل ولدك يموت ببطء. أنقذني».
لم تكن تلك الاستغاثة الأخيرة، إذ تلتها استغاثة أخرى من قلب محروق «أريد أن يوقدوني.. أريد أن يشعلوا أطرافي.. أن يغيثوني.. يا أمي.. يا أمي».
بعد رحلة هروب وتشرد ولجوء دامت أكثر من عامين في تركيا و»كامبات» ألمانيا والسويد وهولندا؛ أنفق خلالها صباح خليل كل ما ورثه عن أبيه، وهو مبلغ قدره خمسة عشر ألف دولار أمريكي، ليجد نفسه أخيراً مرمياً في شوارع أمستردام يتوسل أحد المارة الهولنديين كي يطعمه قطعة بيتزا ويعطيه علبة كولا. جلس في المطعم، وبدل أن ينعم بدفء المكان ويسكت معدته الجائعة؛ بكى وبكى.
رواية «لاجئ من أربيل إلى أمستردام» للكاتب السوري ومعتقل الرأي السابق طالب إبراهيم؛ صادرة عن دار الفارابي في بيروت عام 2017، هي رواية العبور (من الشرق الحزين إلى الغرب الأشقر)، رواية الحلم الذي يصطدم بجدران الواقع، حيث (بوابات الحلم) لم تكن تريد التوقف عند (عتبات القلق).
ففي كامبات هولندا المنخفضة ينخفض الحلم ويتلاشى، ويغدو الرجوع إلى صدر أمٍّ حلمٌ مشتهى.
يلتقط طالب إبراهيم في روايته أدق تفاصيل حياة لاجئين من جنسيات مختلفة. اجتمعوا كلّهم في هولندا الصغيرة. جاءوا من العراق والصومال وسوريا والجزائر وكردستان وميانمار ومجاهل إفريقيا والشيشان والتيبت، من كل بلاد الجوع والفقر والذل والديكتاتوريات. هرب كل واحد بطريقته إلى أوروبا، وهو يحلم بالمال والحرية والجنس وحياة أفضل. الكلّ كان يبحث عن ضالته وما يريد.
صباح خليل الشخصية المحورية في الرواية، هو أيضاً غادر كردستان، كان يريد العبور حيث «لن تتلوث قدماه بالوحل بعد اليوم. ولن توقف حماسته الجنسية غلاظة العصي التي كانت تقف في زوايا البيوت». ومِثله حسين العراقي الذي قال إنه «لم يكن ليترك بلاده لو أن العراق كان بلداً». ومثل كاندي الإفريقية التي رفضتها هولندا مرتين، الأولى عندما لم تمنحها حق الإقامة على أراضيها، والثانية عندما أجبرها عشيقها الهولندي على إجهاض طفلهما وحلمها بالحصول على الإقامة لو ولِد وجاء إلى الحياة. ومثلهم كثير، السوري الذي كان معتقلاً ولا يودّ العودة ثانية إلى المعتقل، والليبي الذي قتل النظام أخويه وطُلب من أبيه أن يوقّع على ورقة تقول إنهما ماتا في حادث، والفلسطيني الذي هرب من غزة وأصبح متحوّلاً جنسياً، كلّهم الآن في هولندا.
يشكل موضوع اللجوء وتفاصيله ومحطاته المضنية الأساس في الرواية، وإلى جانب تلك الفكرة النمطية؛ فإن الوصول إلى أوروبا هو نهاية الآلام، وبداية تحقق الحلم والعيش في الجنة الموعودة.
لا تتطابق الصورة الواقعية لأوروبا مع تلك المرسومة في ذهن اللاجئ، حين يكتشف أنّ ما كان يحلم به لم يكن إلا سراباً، فحجم المشكلات التي يصادفها تثقل كاهل أي كان، وتجعل اللاجئين يفكرون بالعودة من أين جاءوا، فهناك صخب الحياة ولمّات السهر والعلاقات الأسرية وصدر الأم الدافئ، وكل ذلك يشكل البوصلة التي يتوجه سمتها إلى ذاك الوطن الذي غادروه.
يقول الكردي صباح الذي ليس له من اسمه نصيب «تعني حياة اللجوء أن تفقد حياتك ببطء. أن تفقد القدرة على توجيه حواسك عضواً عضواً. تفقد الشعور بانتمائك إلى عائلة بعيدة في وطنك الأم. ثم تفقد شعورك بالأصدقاء. ثم تتغلب مشاعر الاستمرار في روتين الطعام في ساعات معينة والنوم في أخرى على مشاعر الحب، ثم تعتاد فقدان كل شيء». يقرر صباح العودة. لكن كيف؟ وإلى أين؟
سِفر اللجوء وحلم الحصول على إقامة في أوروبا وكل تلك التفاصيل اليومية لحياة اللاجئين التي يغرقنا بها إبراهيم؛ انطوت وحملت في ثناياها رمزيات كثيرة، فأفصحت عن الكثير، وتركت للقارئ الكثير أيضاً. ما لم يقله إبراهيم مباشرة تركه للقارئ ليعيد بنفسه إكمال الرواية، وليضع روايته هو، سواء استند إلى معطى حملته الرواية ذاتها، أم قسرها ليخرج بروايته الخاصة. إبراهيم ترك لقارئه مساحات وفراغات كثيرة، مفتوحة على جراحنا التي جزءٌ منها كان بأيدينا، لوثناها واعتملت أكثر، وجزء آخر كبير لا نزال لا نعترف به، ومعرّض لأن يصاب بالغنغرينا، ليأتي – للأسف – زمن البتر والقطع.
صحيح أن صباح خليل هو الراوي والشخصية الرئيسة في «لاجئ من أربيل إلى امستردام»، إنّما هناك شخصية أخرى تحتل حيزاً مهماً في الرواية لا يكاد أحد يهتم بها، وهي محطات القطارات التي لا تقول شيئاً، إنما تُفصح عن كل الاتجاهات، وتبعث بركابها إلى منحنيات وطرق مجهولة، فركابها المضطهدون القادمون من أعراق وأديان مختلفة؛ يجمعهم قاسم مشترك واحد وكبير، وهو أنهم ضحايا.
ذلك القاسم المشترك الكبير لم يوحدهم، إنما نراهم يتصارعون ويتقاتلون ويصرفون كل طاقاتهم ضد بعضهم بعضا. معارك بين صوماليين وعراقيين، بين عراقيين وأفغان، بين صوماليين وجزائريين، بين أفارقة وأفارقة، وليس من أفق معلوم لانتهاء تلك الصراعات المزيفة.
يقول صباح: «كنت أريد أن أصدق أن عراقياً هرب من القتل في العراق وقدّم لجوءً في هولندا أقدم على قتل صومالي هرب من الموت في الصومال ليموت في هولندا على يد لاجئ آخر».
ترافق هذا مع ما بات يعرف بمعركة (البصقة)، عندما قام لاجئ عراقي بالبصق في وجه لاجئ صومالي، ثم فُتحت الجبهات إثر هدف لم يحتسب، سجله الفريق العراقي ضد الفريق الصومالي في مباراة كرة قدم.. هو إذن صراع الضحية مع الضحية.
أما ثيمة الرواية الرئيسة فنقرأها عبر حدثين مفصليين فيها. صباح خليل الكردي الذي يجوب «كامبات» أوروبا بحثاً عن وطن مرتجى ينتهي به المطاف مشرداً في شوارع أمستردام، مع قرار بالعودة مرغماً إلى كردستان اتخذه بعدما حدث له في السويد، عندما حاولت عجوز مسنّة كانت تؤويه في منزلها اغواءه لإرضاء نزوتها. أما الثيمة الثانية – التي احتلت أحداثاً قليلة في الرواية لكن الرابط بينهما واضح جداً من خلال السياق – مارغريت الفلسطيني الذي هرب من غزة، ولا يُعرف إن كان ذكراً أم أنثى. فهو يدّعي أنه أنثى، ويحلم بالحصول على الإقامة في أراضي المملكة المنخفضة، مدركاً أنه لو عاد إلى فلسطين سوف يُقتل، لهذا يُصر على أنّه لن يعود، وفي حال أُجبر على ذلك سينتحر.
مارغريت المتحوّل ربطته علاقة غير طبيعية أقرانه اللاجئين في الكامب، ولا يخبرنا الروائي لاحقا في روايته عن مصير هذا الفلسطيني المتحوّل.
«لاجئ من أربيل إلى أمستردام».. رواية المضطهدين الذين جمعتهم أوروبا، وجمعهم الألم والأمل، وفرقتهم الصراعات وأشياء أخرى.
(القدس العربي)