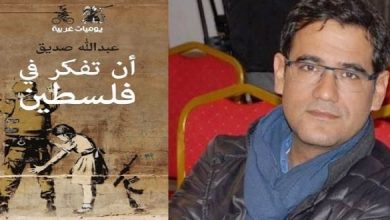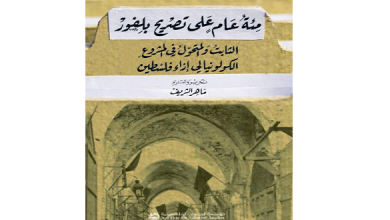قصائد تستحضر حمص في حبّها وموتها

مازن أكثم سليمان
تقوم تجربة عبدالكريم عُمرين في ديوانه «حمص للحُبِّ وقتٌ وللموتِ وقتٌ» (دار أرواد)، على أساس تجربة الحرب المريرة في مدينته (حمص)، ومعايشة ذاته الشاعرة لمعنى الحصار الخانِق في حيّ الوعر، بكلّ ما تحمله هذه التجربة من عذابات ومعاناة تراجيدية قد تصِلُ بالشاعر إلى تفضيل مشهد الموت- نسبياً- على مشهد تفريغ البلاد من أهلِها: «رأيتُ الكثيرَ مِنَ الأشلاء والقتلى/ فَغَضِبْت/ رأيتُ آلافَ الحَقَائِبِ تَرْحَل/ فَبَكَيْت».
يُطلق عُمرين المُستوى السردي في نصوصه إلى أقصى الحُدود، مُحوِّلاً عوالمَ مُعظَم هذه النصوص إلى ما يُشبه الوثائق الانعكاسيّة الغارقة في مُباشَرَةٍ صريحةٍ تُؤرشِفُ الخرابَ والآلامَ والذلَّ والموت في مُناخات سوداويّة وقائعيّة لا يُمكِنُ أنْ يغوصَ فيها المُتلقِّي من دون أنْ يُستدرَجَ بعُنفٍ إلى تلكَ الذروة الانفعالية الإنسانية التي تكادُ أنْ تُنافِسَ انفجار طلقةٍ في الرّأس أو قنبلةٍ في حديقة المنزل. هذا ما نراه في قصائد كثيرة منها قصيدة «أرملة مُبلِّط الأرصفة» يقول الشاعر: «أرملة مُبلِّط الأرصفة/ الذي ماتَ جرّاء شظيّة/ تبحثُ عن ساق صناعيّة/ لولدها المبتور القدم»…
يكمن التَّحدّي الوجوديّ – الجماليّ الذي يمارسه الشاعر في مواجهة شناعة الحرب في تحرير مُعظَم نصوصِهِ من وطأة القيود التَّجنيسيّة، لمصلحة أولويّة بسط ليبيدو غريزي دفاعي في العوالم الكتابية، بحيث تحضرُ في الجانب المضموني تفاصيل المعيش اليومي الشخصي والعام بما ينطوي عليه ذلك من قسوةٍ وعذاب ودم وجوع ومرض. هكذا تغيب في المُستوى الفنّي تقنيّات شعريّة كثيرة لمصلحة تقشف بلاغي عارم، وسرد لا يخلو من الكوميديا السوداء أحياناً، فضلاً عن سيادة المناخات التراجيديّة الخانقة في أغلب النصوص. يقول الشاعر في قصيدة «الوالد المفجوع»: «الوالِدُ المفجوع/يبحَثُ عن أشْلاءِ ابنه/ أمامَ بائع الخبز./ الأمُّ الثكلى وجَدَتْ/ يده فقط قابضةً على بقيّة رغيف/ والوالِدُ وَجَدَ قدَمَهُ/ بفرْدَةِ حذاءٍ أحمَر»… وهكذا، تحتفظ هذه العوالم الكتابية بواقعية مرعبة، وبنبرة حادة تختزل الراهن المأسويّ، في ظل مناخات فنية تكرّسها الذات الشعرية الافتراضية. وربما كان الشاعر يعوض غياب طبقات المَجاز والتكثيف والرمز وغيرها من تقنيات الشعر، عبر حضور المشهدية المحتفية بجماليات القبح، بما تنطوي عليه من خذلان كاسح وانكسار مرير. قال الشاعر في قصيدة «هند وأمل»: «من باب مركز النزوح بحمص خرجتا/ هند المريضة تستند إلى أختها أمل/ كنا رهط من الرجال نجلس على شرفة واطئة/ رجال كادوا أن ينسوا رجولتهم/ يراقبون بكسل فتاتين عانستين قزمتين/ فتاتان قصيرتان جدّاً تتشبثان بأمل يابس/…/ أمل الصغرى شكت من أمراض هند/ وسخرت من حلم أختها بالزواج/…/ تصوروا يا رجال، أقصر منّي/ بثلاث سنتيمترات/ وأكبر منّي بثلاث سنوات/ وتعشق جندي الحاجز الأهبَل (…)/ شدَّتْ قليلاً من قامتها بصعوبة/ وابتسمت ابتسامة ذابلة واهنة وقالت:/ -جندي الحاجز قال لي: الله يبعَث لك ابن الحلال./ منذُ نزَحْنا من حمص القديمة لم أسمَعْ كلاماً جميلاً./…/ -ألسْتُ إنسانة تستحقُّ الحياة والزواج؟!».
إنَّ انحياز كثير من النصوص إلى جنس القصة القصيرة جلي جدّاً، وهذا التشابك النصي بين آليّات السرد وشعرية القبح قد يحتاج إلى قراءةٍ تأصيليّة مُعمقة ومتصلة عضويّاً بأسئلة الشعر الفنية والتجنيسيّة، وإنْ كان يمكن – دَفعاً للالتباس- أن يصدر هذا العمل تحت مسمى «الكتابة»، وهي المشروع الذي نظّر له حداثيّون عرب كثيرون بوصفه يُمثل مرحلةً إبداعيّةً مُجاوزةً لقصيدة النثر!
ولكن، في كل الأحوال، يلتقط القارئ عدداً لا بأس به من النّصوص الذكيّة التي تمكّن فيها الشاعر من إنقاذ المستوى الشعري – نوعيّاً- وتحجيم طغيان الذات الشاعرة الوقائعيّة في سرديّاتها التي أسرتها سلطة أحداث الحرب والحصار اليوميّ، ومثل هذه النصوص تحاول أن تقدم معادلات تخييليّة تعيد إنتاج العالم الوقائعيّ المعيش فنياً. ويظهر هذا الجانب بوضوح في تلك المواضع التي تبسط مسافة التوتر فيها باتكائها على مفارقة شعرية تغدر بأفق توقع المتلقي، وهو الأمر الذي نتلمسه مثلاً في قصيدة «ومشينا في ركام حمص»، حيث يصفُ الشاعر مرافقة أنثى له وهو يمشي معها ويصف الخراب والدمار وأصوات الرشاشات في شوارع حمص، إلى أنْ توقفهما دوريّة راجلة، وتُحقق معهما، سائلةً الشاعر من تكون هذه المرأة التي ترافقه، ليأتي الجواب في القفلة مباغتاً وفاتحاً الدّلالة على آفاقٍ ثرّة: «الجندي القصير المُنتفخ الأوداج/ سألني بنزقٍ/ عمّا نفعل وسط الرّكام/ قلت: نبحث عن شالٍ أخضر/ فقدناه هنا، بل أضعناه»…
لعلَّ محاولة الشاعر الإيحاء بمقاومة قبح الحرب والموت عبر استجلاب مشاعر الحب وأفعاله، وهو الأمر الذي تُوحي به عتبة عنوان الديوان، تصطدم في نصوصٍ كثيرة بانكسارٍ نفسيّ ووجوديّ حالك، وإن كان يحاول الإفلات في مراتٍ مُتعددة من هذا المصير المتربص بعوالمه الكتابيّة، لتتعايش في غير موضع من الكتاب روح الأمل القاسي وروح الحزن الشفيف، تاركاً أساليب الوجود في نصوصه الموجعة هذه بمنزلة شهادة مكتوبة بالدم والرعب والألم. يقول عبدالكريم عُمرين في قصيدتِهِ/ الوصيّة «يا أنتُم إذا ما مِتْنا وعُدْتُم»: «يا أنتُم/ إذا ما مِتْنا وعُدْتُم/ انثروا الورودَ فوق قُبورِنا/الورد يَليقُ بنا/ والحياةُ تَليقُ بكُم/ ضَعوا ورودَكُم وانصرِفوا/ وفكروا بسوريّة أجمَل، وأعدَل/ ازرعوا الحبّ والعزيمة في كلِّ ذرَّةِ تُراب./ هذي وصيتُنا لكُم/ أرجوكُم».
(الحياة)