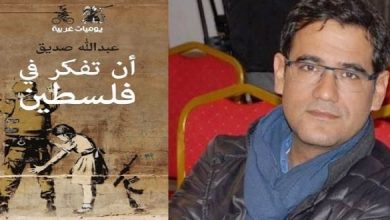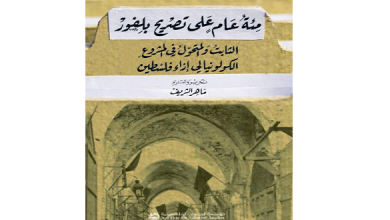معاينة الأرواح في رواية «الأعتاب» للعماني محمد قراطاس

محمد المهري
«إذا سلك المريد الهول في أول قدم فلا يبالي؛ فإنه لن يلقاه بعد ذلك إلا الراحة» (اللمع في التصوف ص207).
لا تزال البيئة الصوفية في ظفار المعين الثر أو المنجم الذي يستوجب العودة إليه لخلق مشاريع إبداعية مميزة؛ لما تزخر به تلك البيئة من معان وإشارات نعتبرها المادة الخام التي يُشكلّها ُصّناع الكتابة.
تلك الإشارات التي اتقنها الشاعر والروائي محمد قراطاس في سرد روايته «الأعتاب» بحرفنة الشاعر الذي يجيد وضع الكلمة في فضائها خلال 250 صفحة نشرتها دار الساقي 2016.
كنا نظن أن المناخ الصوفي في بداية القراءة أو الطلب أنه الحلقة الأضعف التي تضمحل أمام أي تيار دخيل، سواء أكان يساريا، أم ليبراليا، ومع مرور الزمن وجدت أن الفكر الصوفي كان كفيلا بالصمود والتحدي في أصعب الظروف، بل إعادة الأمور إلى نصابها شريطة أن تكون القلوب في حالة الصفاء، والأمثلة في الباب كثيرة كما يقولون.
حين طالعت رواية «الأعتاب» أعادت ما كنت أعتقده من أن البدائل المطروحة حين الخروج من الأفكار المستوردة قد يكون الخلو بالنفس ومناجاة الخالق، للقرب والمعرفة على بصيرة، وهذا ما وجده مستهيل العفّار بطل الرواية بعد أن قاتل لأربعة أعوام في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير ظفار والخليج العربي، ذات التوجه اليساري، خاصة حين انكشف له بعض من أوجه الثورة المغايرة لأحلامهم التي قاتلوا من أجلها وقدموا الدماء والدموع.
القول بأن الأفكار تميل إلى التطرف حين تمتلك أدوات القوة.. كان حاضرا في بعض صفوف الثوار الذين مارسوا إجراما في حق شعب قدم لهم الأرض وما عليها؛ لكي يحصدوا الحرية والعدالة، وهو الحلم ذاته الذي كان ينشده العفّار حين ينبزه أقرانه (بابن جديحة البحر) هنا كانت العدالة البشرية مؤقته وملغمة، بل كانت أسيرة ألفاظ ترن في جنبات الوديان الظفارية وشاهق قممها مطرزة بأناشيد الأطفال العذبة، كيما تصبح الحرية حقيقة ملموسة. كل تلك الأحلام تهاوت أمام المؤمنين بالكفاح المسلح عبر مراحل ومشاهد حضرها العفّار. «وجوه الرجال قبل إعدامهم.. بكاء الثكالى، نظرات الأيتام» وأشدّها ذلك المنظر على الصخرة وعليها دم العم محمد حينها قال: «وجدت كل فكرة آمنت بها وكل إنسانية حاولت الانتصار لها تسيل على تلك الصخرة الصماء وتتيبس على الطين تحتها. حينها نظرت إلى السماء فرأيتها تسقط قطعا وتخلف ثقوبا من الجحيم.. ثم وضعت بندقيتي على الصخرة، وتخليت عنها وهي التي طالما قاتلت بها لأجل العم محمد ولأجل أمثاله من البسطاء واتجهت إلى المدينة ولم أنظر خلفي» .
هنا يبدأ البحث الحقيقي عن الحياة وليس الروتين الذي يمر به الإنسان الظفاري قبل الثورة، ذلك أن الحياة في زمن الثورة مغايرة لما اعتادته البيئة الظفارية في جنوب عمان بكل قطاعتها (الرعوية/الزراعية/البحرية) إذ كانت الجبهة قد غيرت الكثير من المفاهيم أقلها رتابة الجداول اليومية، «فمستهيل رغم رحيله عن الثورة فإنها لم ترحل عن روحه التي لا تطيق هذا الهدوء الطاغية». وهذا ما دعا العفّار للبحث عن حياة حركية تضارع تلك التي عاشها لأربعة أعوام شريطة أن تضمن له الطمأنينة الروحية، وتعمل على القضاء على تلك الصور المرعبة التي تمر بذاكرته، يضاف إلى ذلك إسكات الأفواه التي تعودت على أن تنتقصه بابن (جديحة البحر).
بداية الطريق
على الرغم من كثرة الأسئلة التي تتدافع في مخيلة العفّار، وتلك الزيارة النورانية الأولى التي قام بها والده في المنام، وما توحي هذه المؤشرات من تلمس للطريق إلا أنها لم تك مؤثرة بقدر ذلك السؤال الذي طرحه على الخال عمر فجاءة:
هل وجدت اللّه يا خال في مسيرتك هذه؟
كانت الإجابة غامضة تحيل السائل إلى متاهة لا يجيدها، إلا أن الشيخ عمر ختم اللقاء بعبارة تكاد تكون هي الفكرة استهلكت معظم الرواية.
«يا بني اتجه إلى نهاية الطريق هناك تبدأ رحلتك».
إذن في النهاية تكمن البداية – أي عند النهاية ستُكْشَفُ الأسرار التي دفعته للانضمام لصفوف الثورة والخروج منها، بل ذلك السؤال القلق الذي يبحث له عن جواب:
من أين أتى أو كيف؟
كل هذا البحث لا بد له من رحلة (يا بني اتجه) على أن السفر هو المرحلة الأصعب؛ إذ لا يعلم وجهته، بل لا يعلم وسيلته، «حتى تصل يجب عليك أن تسير في الأرض بلا حذر. أن تسافر بدون دليل»، هنا تبدأ مرحلة أخرى، وهي مرحلة الاستعداد للسفر في فضاء مغاير: هو السير إلى الله (الجنائب) وحتى يملأ ذلك الخواء الروحي الذي أحدثه الفكر المادي البحت؛ فإنه سيأخذ بأركان السير إلى الله عز وجل ( العزلة / الصمت/ السهر/ الجوع/ الأوراد)..
يا بني عُدْ إليه ثم قم بزيارتي.. كانت هذه العبارة مفتاح السير إليه تعالى – الصوفية كانوا يطلقون عليها باب الأبواب (التوبة) – وتصحيح ما كان يقوم به للقربى حتى يغتسل مما ظهر على يديه من الدماء «تذكر مستهيل والده يقول: «أربعون يوما وليلة من الذكر والاستغفار والتعبد كفيلة بتطهير الإنسان من الذنوب الظاهرة والصدقة يعبر بها إلى دائرة الرحمة».
مقام القرب
يقول السهرودي: «إن العبد إذا أخلص لله وأحسن نيته وقعد في الخلوة أربعين يوما أو أكثر؛ فمنهم من يباشر باطنه صفو اليقين ويرفع الحجاب عن قلبه ويصير كما قال قائلهم: رأى قلبي ربي» (عوارف المعارف ص159).
أخذ مستهيل بالدخول في الأربعين.. صلاة وذكرا وتبتلا. وكلما ازداد تعمقا في العبادة بدأت روحه بالاقتراب من هيئة الماء، كان اسم الله يترك تأثيرا عجيبا على قلبه، لم يفهم مستهيل هذا التأثير، لكنه موقن بأن نهرا باردا من المحبة يتدفق بين جنبيه، يكاد يشعر برذاذ ضفافه في أعلى ضلوعه. وحين زاد الأربعين مثلها إلى أن بلغت الثمانين يوما، تجلت له الأمور، بل تجردت له الحقائق من لبسة المثال فكان بمثابة الكشف والإخبار من الله تعالى له، تحقق ذلك حين طلب من أخيه المكوث في البيت وعدم الذهاب إلى المزرعة، وحين سألته أمه عن السبب قال لها إنها ستمطر اليوم.
هنا أصبحت المنامات تجليا يراها حقيقة ماثلة أمام عينه أو ما يسمى بالزيارة النورانية «إن ملأت رئتيك بيقينه سيملأ وجدانك الزمان والمكان وتصدقك الخواطر والزيارات النورانية». وإذا أردنا إحصاء المنامات أو الزيارات النورانية بعد الخلوة التي دامت ثمانين يوما فإنها بلغت (14) زيارة نورانية، تارة يكون هو المنقذ، وأخرى تكون الزيارة بمثابة حبل النجاة للبطل، تتخلل هذه المنامات قصص شيقة لأرواح تروي لمستهيل ما مرّ بها من أحداث، وبعض هذه المنامات هي بشرى بقرب اللقاء بجده، ودلالة لنهاية الرحلة.
ومن الملاحظ أن الرواية كلها تقوم على الكشف أو الرؤيا المنامية، وهي ما جعلت الرواية تدخل في زياراتها عالم الدراما المشوق، فما أن تأتي الغفوة من مستهيل حتى تشرئب له نفس القارئ لينتقل إلى مشهد مغاير، وما زاد عنصر التشويق في السرد تلك المدن والموانئ التي مر بها (مسقط، مقديشو، مومباسا، كيب تاون، لواندا، فريتان، سيراليون، فوس، باريس، مرسيليا، طنجة، السويس، بورت سودان، الخرطوم، دارفور، الفاشر، جبل مرّة) التي تحمل كل منها قصة درامية تجذب المطالع لمواصلة القراءة، عنصر التشويق أو الجذب أو الغواية تقنية أجادها قراطاس في البداية، حين جعل طعم الحديث عن الثورة في أول مفاتيحه الشاعرية للرواية «عاد مساء خلع ثيابه وأفرغ من جيبه (ثورة)» وقوله: «الصحراء أنثى ثائرة لا تعرف الحب، ولكنها تلده دون قصد». على أن مساحة الحديث عن الجبهة الشعبية لتحرير ظفار والخليج العربي بكل أحداثها الجسام ورؤيتها التقدمية، لم يتعد السبع صفحات من مجمل صفحات الرواية البالغ عددها (251) صفحة، ولعل المؤلف أراد لها أن تكون طعما للقارئ؛ لما للثورة في النفوس من تقدير أقلها عند من لا يعرف تفاصيلها، ثورة كانت ولا تزال محل سخط تارة، وتبجيل تارة أخرى. وما يدعو للغرابة أنه، أي البطل، يسرد في نهاية الرواية السبب الذي جعل من الحلم كابوسا لا يفارقه وكأن الرحلة النورانية طهورا لما سايره من أخطاء خلال أربعة أعوام.
تلح على القارئ رتابة المنامات ووجهها الذي يتكرر في كل حادثة، الأمر الذي يقترب من جادة الملل، وهو ما دفع قراطاس في لحظة نابهة أن يسلب الكرامة من بطله حين قُتل العجوز إسحاق «لم يفهم لماذا يأتيه خاطر ينجي إنسانا ذا قلب قاس كالقبطان بيتر، ولا يأتيه لإنقاذ حياة العم إسحاق صاحب الروح الطيبة؟»؛ ليدلل أن المنامات لم تكن تحدث في كل الأمور، مبعدا عن القارئ صورة النوافذ المكررة بذاتها. يضاف إلى التكرر الصارخ ذلك الكم من الشخصيات الذي يصل حد الرتابة.
على الرغم من الاتكاء على الموروث الصوفي في الرواية، إلا أنها تخلو من العمق الصوفي بكل أبعاده، ذلك أن المؤلف أبعد نفسه عن القضايا الجوهرية التي نوقشت أو طرحت عند المتصوفة، وعذري له أنه لم ينبت في تلك البيئات التي تعمقت في التصوف، وإن البيـئة العمانية الجنوبية على وجه الخصوص لا تصل بتصوفها مرحلة المريد.
تقنيات متناثرة
ـ العنوان:
من التقنيات الحديثة في الرواية الوقوف على العنوان، أو ما يسمى بالعتبات الأولى للمنجز النصي. وبالرجوع إلى أصل العنوان «الأعتاب» في اللغة فإنه يحمل معاني عدة إلا أن الرواية تقترب من معنى «العَتَبُ: الدَّرَج. وعَتَّبَ عَتَبةً: اتخذها. وعَتَبُ الدَّرَجِ: مَراقِـيها وكلُّ مِرْقاةٍ منها عَتَبةٌ. وعَتَبُ الجبالِ والـحُزون: مَراقِـيها. وتقول: عَتِّبْ لي عَتَبةً في هذا الموضع إِذا أَردت أَنْ تَرْقى به إلى موضع تَصعَدُ فيه». وحال العفّار في تقلبه من المادية البحتة إلى الصوفية النورانية، أعتاب وليس عتبة واحدة، وهو ما يطلق عليه المتصوفة بالمقامات «والمقامات هي مراحل الطريق إلى الله التي يقطعها السالك في رحلته نتيجة مجاهدته لنفسه».
ـ الأغاني الشعبية والأساطير:
لا شك أن أي رواية في كثير من أمرها مرآة للبيئة التي بعثت منها، يظهر ذلك باستيحاء ثقافتها الشعبية، سواء أكانت غنائية، أم أسطورية؛ حتى تسترعي انتباه القارئ، وتدفعه إلى ارتياد أرض طالما سمع عنها الكثير، جنوب عمان أرض الثورة واللبان، أرض الأنبياء والأولياء، وعلى الرغم مما تزخر به هذه البيئة من أغان وأساطير، إلا أن قراطاس كان زاهدا في هذين العنصرين المهمين (الأغاني الشعبية/الأساطير) فلم ترد أغنية شعبية إلا مرتين، «أتاه صوت رجل يبكي ولده الذي قتل. كان صوته بالدبرارت، وهو إنشاد لسكان الريف… الصوت يقول:
لمن أذهب بعزائك يا ولدي؟
لم تعد بي قوة على تنهيدات صدري
وعلى نواح أمك فوق كل قمة نمرّ بها.
لمن أذهب بعزائك يا ولدي؟
أما الأسطورة فقد نالت من الشح ما نالته الأغنية الشعبية، فلم يطرق حقل الأسطورة إلا في حديثه عن بخيت الشاعر، الذي لجأ إلى بـئر عين البليد التي تحقق أماني من فاجأها وهي تنظر للسماء، إلا أنهم وجدوا جثته طافية في بئر عين البليد.
في الختام …تظل رواية «الأعتاب» علامة بارزة في الرواية العمانية؛ لما تحمل من أوجه متبــاينة تلزمك بتعدد القراءات والرؤى، ويظــــل قراطاس الروائي مميزا بتغريبته الصوفية بكل أحوالها، وما يعرض لبطله دون كسب منه من المعاني الإلهية والأحوال الربانية التي ترد على قلبه من غير تعمد منه ولا اجتلاب ولا اكتساب.
(القدس العربي)