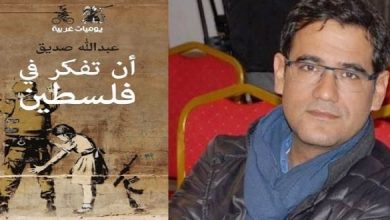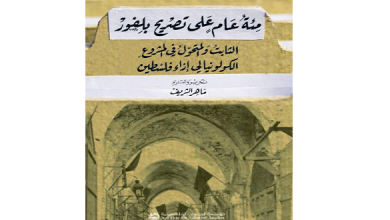علي بن مبارك يرى أنه لا حوار دون حرية، ولا تقريب بين الجماعات الدينية دون تحرّر

محمد الحمامصي
تشكل قضية العلاقة بين المذاهب الإسلامية سنية أو شيعية “أم الفتن” إذا جاز التعبير، وهي قضية الساعة وسط ما يجري في العالم العربي والإسلامي من نزاعات وصراعات وحروب، وما يترتب عليها من دماء ومآسٍ وكوارث إنسانية واقتصادية وثقافية، يأتي جراء هذه العلاقة التي لم تتوافق على الحوار والتقارب لنزع فتيل الفتن التي تحملها تأويلات وتفسيرات كل مذهب متناقضة مع المذاهب الأخرى، وما تخرجه من أفكار تستند إليها جماعات وتيارات متطرفة وعنيفة، وأن كل ما يجري على موائد الحوار بين المؤسسات الدينية هنا وهناك على امتداد العالمين العربي والإسلامي يذهب أدراج الريح نتيجة تقصير واضح وجلي من قبل هذه المؤسسات والإرادات السياسية الحاكمة في وصول نتائج هذا الحوار والتقارب إلى جموع المسلمين.
هذا الكتاب “الحوار التقريبي بين المذاهب الإسلامية.. التجارب والإشكاليات والآفاق” للباحث علي بن مبارك، يرى أنه على الرغم من إنّ الحوار الإسلامي التقريبي حاصل بالقوّة وبالفعل، باعتباره منشود ملايين من المؤمنين ممّن قاسوا الفرقة، والصّراع المذهبي، والخوف الدّائم، إلا أن المفارقة أنّ تعدّد وجوه الحوار الإسلامي التقريبي لم تعكس تواصلاً حقيقياً بين المسلمين، وكشفت عن أزمة عاشها الحوار، كما تجلّى في أدبيات التّقريب، فأغلب المنتمين إلى دار الإسلام مازالوا يؤمنون بوجود فرقة ناجية تحتكر الحقيقة والخلاص، دون بقية المجموعات الإسلامية، ويعتقدون أنّ الحقّ واحد، يُستدلُّ عليه بالبرهان والدّليل، وعلى الآخر الاقتناع بما تحيل عليه قرائن الأدلّة.
ووجد الخطاب التّقريبي نفسه في أزمة نسقية خطرة، فهو، من جهة، يدعو إلى الحوار والاعتراف بالآخر، والتحرّر من كلّ وصاية على العقيدة وصاحبها، ولكنّه، من جهة ثانية، يحتفظ ببذور الفرقة والخلاف، ولا غرابة في أن يدعو الخطاب التّقريبي إلى التعدّد، والتنوّع، والاختلاف، وينزع، في الآن ذاته، نحو التنميط، وتوحيد التمثّلات، ورفض كلّ تجديد يمسّ التقليد، كما أرساه أربابه منذ قرون خلت.
يسعى بن مبارك في كتابه الصادر عن مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” للإجابة عن سؤال إشكاليّ محوري نصّه: كيف تمثّل التّقريبيون مشغل التّقريب، ومطلب الحوار، وما تعلّق بهما من قضايا ومحاور؟ ويقول “تنطلق هذه الإشكالية من فرضية تقول: إنّ التّقريب بين المذاهب الإسلامية كان فضاءً مناسباً للتحاور، وتبادل وجهات النّظر بين أطراف إسلامية متعدّدة، لم يكن من اليسير جمعها في سياق حواري واحد، وبُنيت هذه الفرضية على ما أوحى به التّقريب من أبعاد تواصلية تقوم، أساساً، على تقريب البعيد، وتقارب ما تباعد من أنساق دينية وذاكرات، ولا يمكن أن نتحدّث عن حوار خارج سياق تواصلي يشتمل على الأفراد، والجماعات، والمؤسّسات، والأنساق، وحتى يتسنّى لنا تمثّل الإشكالية المطروحة، والإجابة عن رهاناتها المعرفية، استعنّا بمجموعة من الإشكاليات الفرعية؛ فتساءلنا عدّة مرّات: ما المقصود بالتّقريب بين المذاهب الإسلامية؟ ما أهدافه وخلفياته؟ وما أهمّ تجارب التّقريب المعاصرة؟ وإلى أي مدى يمكن الحديث عن حوار إسلامي – إسلامي من خلال تجارب التّقريب بين المذاهب الإسلامية؟ وإلى أي حدّ كان التّقريب فضاءً مناسباً للحوار؟ ولكن كيف نفهم الحوار في بعده الإسلامي – الإسلامي؟ وما طبيعة الموضوعات التي أثارها؟ ومن هم المعنيون به؟ وما الصّعوبات التي اعترضت سبيله؟ وكيف نظر التّقريبيون إلى آفاق الحوار ومستقبله؟”.
ويلفت بن مبارك إلى أنه لم يكن من اليسير الإجابة عن إشكاليّة البحث، وما تعلّق بها من إشكاليات فرعية، فالحديث عن تمثّلات التّقريبيين يتطلّب إلماماً بكلّ تجارب التّقريب بين المذاهب الإسلامية المعاصرة، من كتب، ودوريات، وأعمال ندوات، ومؤتمرات، وبرامج إعلامية، وغيرها من أشكال التّقريب. ويكشف “لئن صرّحت المنظّمة الإسلامية للتربية والثقافة العلوم (الإسيسكو) بأنّها تتبنّى قضايا التّقريب، فإنّها لم تعمل على جمع ما أُنجز في إطار حركة التّقريب المعاصرة؛ بل وجدنا صعوبة في تحصيل ما نشرته المنظّمة ذاتها من أعمال ندوات عُنيت بالتّقريب ومشاغله، ولعلّ ما زاد في صعوبة جمع المدوّنة كثرة التجارب التقريبية وتعدّدها؛ إذ ظهرت عدّة تجارب تقريبية في أوروبا، والقارّة الأميركية، وشبه القارّة الهندية، والدّول الإسلامية الآسيوية، والقارّة الإفريقية، ولم يكن من الممكن متابعة أعمال هذه التجارب، وذلك لعدّة اعتبارات؛ فأعمال هذه التجارب التّقريبية صدرت في لغات كثيرة لا نتقنها، ولا نجد اهتماماً من قِبل المنظّمات الإسلامية الرّسمية بترجمتها، أو تقديمها، وأغلب هذه الأعمال لا توزّع خارج نطاقها الجغرافي الذي نشأت فيه، وتبقى، أحياناً، سجينة رفوف المؤسّسة التي احتضنتها”.
ويضيف بن مبارك “حاولنا أن نعاين خطاب التقريب، وأن نقارن بين تجاربه المختلفة داخل المنظومة الدّينية الواحدة وخارجها، ولم تقتصر المعاينة على تحصيل النّصوص التقريبية التأسيسية، أو مشاهدة مؤتمرات تقريبية، أو متابعة مناظرات مذهبية متاحة على الفضائيات، أو من خلال شبكة “الإنترنت”؛ بل حاولنا أن نعاين ظاهرة التقريب بين المذاهب الإسلامية من خلال معاشرتها، والمشاركة في بعض ملتقياتها وندواتها، ومتابعة مداخلاتها العلمية، وما أحدثته من ردود وتعليقات، وما أفرزته من مناقشات ومطارحات، واستأنسنا، في معاينتنا، بإجراء محاورات مع عشرات من التقريبيين ممّن التقيناهم، ولعلّنا ننشر، لاحقاً، نصوص محاوراتهم.
وقد كان الحوار معهم مفيداً، كشف لنا عن أمور خطيرة ساعدتنا على تطوير العمل، وثبت أركانه؛ واجتهدنا في الاقتراب من الظّاهرة الدينية التي ندرسها، فولجناها، ودخلنا إلى عوالمها وأسرارها، واقتربنا من الظّاهرة حتّى يخالنا القارئ جزءاً منها، ومعنيين بها، نحاور روّاد الفكرة، ونعيش معهم أحلامهم، وآمالهم، ومخاوفهم، ونجلس بين أيديهم، نتعلّم، ونتمثّل، وبقدر ما كنّا نقترب من الظّاهرة كنّا نبتعد عنها، فاتّخذنا دونها مسافة لعلّنا نتحرّر من أسر خلفيّاتها، ونتفطّن إلى مغالطاتها وتناقضاتها”.
ويوضح: عَدَّ روّاد التقريب تقريبَهم “فكرةً”، وكذلك تعاملنا معها، ولكن ليس من اليسير دراسة الأفكار، وتاريخها، وما تفرزه من خطابات وتصوّرات، فأشكال التقريب كثيرة لا يمكن حصرها في نماذج مضبوطة، أو أدبيات مخصوصة، والحوار، في بعده التقريبي، يخترق جلّ القطاعات، ويمسّ الأفراد، والجماعات، والمؤسّسات، والحكومات. وبالإضافة إلى ذلك، الخطاب التقريبي خطاب متحرّك متغير، من حيث بنيته، ومقاصده، وأهدافه التي يرمي إليها؛ ولذلك تميّز الخطاب التقريبي باضطرابه وتناقضه، ويعكس هذا التناقض أزمة يمكن أن نكتشف معالمها من خلال مجموعة من الثنائيات لم يكن من اليسير تجاوزها، وتذليل الصّعوبات المتعلّقة بها؛ ولعلّ أخطر هذه الثنائيات ما تعلّق منها بفهم مسألة الأصالة في علاقتها بالحداثة، وما ينتج عنه من رغبة في التقليد، أو التجديد”.
ويؤكد بن مبارك أنّ كلّ طرف من أطراف الحوار التقريبي وجد له في تراثه القديم خير نصير لآرائه ومواقفه، وعَدَّه شمعة تنير دروب التقريب، وتدفع الحوار نحو آفاقه المنشودة، ولكنّ نصوص القدامى احتوت، أيضاً، على ما يثير الفتن والتباغض، وما يعرقل كلّ تقريب، ويحول دون الحوار والتواصل، فهي نصوص حبلى بمقالات الإقصاء والتمييز المذهبي، وتحتلّ مكانةً أساسيةً في المخيال الدّيني، وتوجّه التقليد، تصريحاً وتلميحاً، نحو التعصّب والصّدام؛ إذ لا يمكن تجاهلها، أو تجاوزها. وإن صرّحت الخطابات التقريبية بعكس ذلك، فهي، عند أغلب التقريبيين، نصوص موقّرة لا يمكن تجاوزها، أو التشكيك فيها، وإن أكّدوا، في مواضع مختلفة، أنّها نقلت أخباراً تثير الصّراع المذهبي، وتؤجّج الخلاف. وجد الخطاب التقريبي نفسه في حيرة من أمره، فكيف له أن يتّبع نصوص القدامى، ويحافظ على هيبتها وحجّيتها، والحال أنّها تحتوي من النّصوص ما يعرقل كلّ تقريب، ويفسد كلّ حوار؟
وحول قضية تنقية التراث يقول “لئن دعا نخبة من التقريبين إلى تنقية كتب التراث، وحذف ما يكدّر صفو النّفوس، وإعادة تحقيقها ونشرها وفق منهج تقريبي جديد، فإنّ دعوتهم ظلّت خافتة؛ لأنّها لم تقترح حلولاً جذرية نسقية تخرج التقريب، خطاباً وممارسةً، من أزمته؛ فالحلول الجزئية التلفيقية لا تفيد في هذا السّياق الثقافي التواصلي المخصوص، وآية ذلك أنّ الحوار في مجال الأنساق الدينية يتطلّب جرأةً، ووضوحاً، وشجاعةً، واعترافاً غير مشروط بالآخر، وتمثّلاته الفكرية والعقدية، ولن يتحقّق هذا المنشود الحواري إلا متى كانت الحلول المقترحة تأصيلية واقعية بعيدة عن المجاملات والمزايدات.
وما أحوجنا، اليوم، إلى حوار دون أقنعة، وتواصل دون تردّد، ولن يتحقّق ذلك إلا متى آمن المسلمون بأهمية الحوار، ومشروعية الاختلاف، وضرورة التواصل والتعاون فيما بينهم، فأغلب شعوب العالم بنت لها أنساقاً تواصلية تيسّر التعاون على الأصعدة كلّها، ولم يستطع المسلمون، في المقابل، توحيد صفّهم، وتحقيق التقارب فيما بينهم.
ويؤكد بن مبارك أن تردّد التقريبيون في الانتصار للمعاصرة، بما هي وعي بالموجود، واستشراف للمنشود؛ ولذلك لم يكن البناء الاستراتيجي التقريبي بناءً محكماً، وفشلت الاستراتيجيات التقريبية المقترحة من قبل الإيسيسكو، والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، في تقديم خطّة عملية واقعية يستحيل بها التقريب سلوكاً، ويتحوّل بموجبها الحوار إلى ثقافة وممارسة تشتمل على الأسرة، والمجتمع، والتعليم، والإعلام، والسّياسة، والإبداع، وغيرها من مجالات الحياة المتعدّدة، لقد أوهمت استراتيجيات التقريب قرّاءها بأنّها تُعنى بالمستقبل وتحدّياته، ولكنّها اكتفت باسترجاع الماضي، واستحضار سياقاته.
ويشير إلى أنه لاحظ من خلال موضوعات الحوار التقريبي “أنّ الخطاب التقريبي لم يستطع أن يتجاوز ما حفّ بالدّين من انزياحات كثيرة، ليس من اليسير ضبطها في هذا السّياق البحثي الضيق؛ فنصّ التأسيس حفّت به نصوص كثيرة تشرحه، وتبين أحكامه، أو إعرابه، أو إعجازه، واستحالت النّصوص الحافّة به؛ الفقهية، والتفسيرية، والكلامية، نصوصاً يقينية، جعل منها التقليد حقائق لا يمكن ردّها، أو نقدها. واعتقد المسلمون، طوال عصور الاتباع والتقليد، أنّ ما تركه كبار العلماء، من اجتهادات فقهية، وتفاسير قرآنية، يُطابق الحقيقة، الحقيقة كلّها، ولا بدّ من تصديقها، والأخذ بها، ومحاربة من ينتقدها، ونتج عن هذا التعصّب لآراء الرّجال رفضٌ للاختلاف والتنوّع.
وينبه بن مبارك إلى أن ما زاد في تراجع الأداء التقريبي الإبداعي ارتباط الحوار التقريبي، وما تعلّق به من أدبيات تقريبية، بمجال جغرافي ضيّق لا يعكس حقيقة المشهد الثقافي الإسلامي، فالمشاركون في تشكيل معالم الخطاب التقريبي، بتجاربه كلّها، لا يمثّلون غير عدد قليل من الدول الإسلامية، ولا يعكسون، بحال، هموم المسلم المعاصر، ومشاغل الثّقافة الإسلامية، فندوات الإيسيسكو، على سبيل المثال، وما اقترحته من أنشطة تقريبية على مستوى الهيئة الاستشارية العليا للتقريب، اقتصرت في أنشطتها على بعض الوجوه العربية والإيرانية، وكأنّ الحوار التقريبي حوار عربي فارسي، أساساً. لكنّ المسلمين ليسوا عرباً، أو فرساً، فحسب؛ بل ينتمي أغلبهم إلى أعراق أخرى، ويحملون هموماً مغايرة، وينظرون إلى الحوار من منظور مختلف قد يكون من المفيد، تقريبياً، تبينه، والاطّلاع عليه.
وإذا كانت الإيسيسكو، وهي لسان حال المسلمين كلّهم، تنظر إلى التقريب هذه النظرة الجغرافية الضيقة، فما بالك ببقية التجارب التقريبية المعاصرة، التي عكست سياسات محلّية، وأهدافاً لا تتجاوز، أحياناً، حدود الوطن. ولا نبالغ إذا قلنا: إنّ قضية الحوار التقريبي بين المسلمين شغلت بال شريحة كبيرة من المسلمين في أرجاء العالم الإسلامي كلّه.
ويقول “فَهِمَ التقريبيون أنّ التقريب يتطلّب حدّاً أدنى من القيم الإنسانية المشتركة، فتحدّثوا عن الحرية والمواطنة، واحترام الاختلاف والتعدّد. وعلى الرغم من وفرة النّصوص التقريبية، التي بشّرت بالحرية، وتحدّثت عنها، كان حديثها محتشماً غامضاً في بعض الأحيان، فالحرية تعني، في مفهومها الإنساني الحداثي، أن تكون مسؤولاً عن اختيارك، وأن تتّخذ لك من الأفكار، والشعائر، والمعتقدات، ما شئت، بشرط أن لا تضرّ بحقوق الآخرين، وتعني الحرية، في سياقها التقريبي، أن يعتقد المسلم بما شاء، وكيفما شاء، وأن يمارس شعائره الدّينية وفق النّسق الفقهي العقدي الذي اختاره، وأن يتمتّع برحمة الله وخلاصه دون تمييز أو تخصيص، فحلم الله يشمل الجميع، والطرق كلّها تؤدّي إليه، وما الاختلاف إلا سنّة من سننه. وعلى هذا الأساس، يجوز الاختلاف في تمثّل النصّ، وفهمه، وإفهامه، واستنباط الأحكام الفقهية منه، كما يجوز الاختلاف في بناء الأنساق الدّينية بحسب الخلفيات الحضارية، والأعراف، والخصائص النفسية والاجتماعية للمؤمنين، فمن الطبيعي أن يختلف النّاس، وأن تتباين مواقفهم ومعتقداتهم، ومن المفيد أن تتعدّد الأنساق، وتتنوّع، في كنف من الحرية والمسؤولية”.
ويخلص بن مبارك إلى أن “إنّ الحرية ليست مجرّد شعار يرفعه الرّافعون؛ بل هي شكل من أشكال الوعي والانتماء؛ وعي بمشروعية الاختلاف، وانتماء إلى مشروع ثقافي متعدّد الوجوه، متغير المعالم.
ولا تقتصر الحرية على الوعي، فهي، أيضاً، سلوك وممارسة، يستحضرها الإنسان في مراحل حياته كلّها، ويعتمدها نبراساً في أنشطته الفردية، والجماعية، والمؤسّساتية، كلّها، فالحرية ليست حُلياً نتزين بها، أو واجهة نتوارى خلفها، أو نتكسّب بها؛ ولذلك عكس حديث التقريب المتعلّق بالحرية اضطراباً وغموضاً، فأهل التقريب، على مختلف مدارسهم وتجاربهم، بشّروا بالحرية المذهبية، وامتدحوها، ولكنّهم، في الآن ذاته، تخوّفوا منها، وحاولوا تقعيدها، وتقنينها، وضبط وجوهها المحمودة والمذمومة.
ويؤكد “لا حوار دون حرية، ولا تقريب بين الجماعات الدينية دون تحرّر. وأصبح من الضروري، اليوم، اعتناق مذهب الحرية، والإيمان بمبادئه وتعاليمه، فلعلّنا، من خلال مدخل الحرية، وما يتعلّق به من نزعة تحرّرية، نذلّل ما تراكم من صعوبات تواصلية حالت، لقرون من الزمن، دون تحقيق الحوار التقريبي المنشود، ولعلّنا، أيضاً، نفتح ما غُلّق من أبواب، ونحقّق ما راود أجيالاً من المسلمين من أحلام وأمنيات، فعسى الله يرحمنا، وما ذلك على الله بعزيز”.
(ميدل ايست أونلاين)