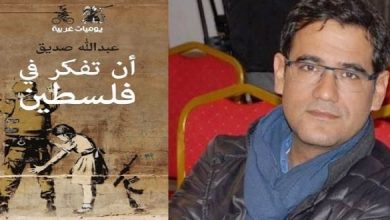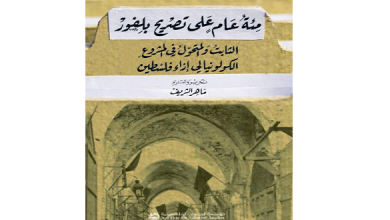الحوار أسلوبا للعيش

المهدي مستقيم
الحوار كما يقول سوريو، هو «الشكل الفلسفي الممتاز»، بيد أن الأفكار أكثر ما تكون فلسفية، عندما يستطيع من يفكر فيها من الداخل أن يبحث عن وجهها الخارجي. إذ يحد الحوار بما هو فعل مستمر في الزمن – أو بما هو فعل لا يعرف انقطاعات وتوقفات- من سطوة النهايات المغلقة، وعنف الإجابات الجاهزة، وسقم المسلمات المطلقة، إنه فعل حيوي لا يكف عن تحويل الأجوبة إلى أسئلة جديدة، تنتفض أمام مناورات آباء الكهنوت الذين يسعون إلى تأبيد قدسيَّتهم الساحقة، بتكريس ثقافة الخنوع والعبودية، والإذعان والتصديق، والسكون والتقليد، فـ»بديهي أنه لا حوار دون حرية، أعني الحرية التي يتجاوب فيها الفرد مع المجتمع، وتحكم العلاقة بين المبدع والمتلقي، وأشكال الخطاب بين المفكِر والمفكَر، الحرية التي تنتقل من خارج الفرد إلى داخله، والتي تختفي معها كل القيود السياسية والاجتماعية والفكرية والإبداعية.»(جابر عصفور- «هوامش على دفتر التنوير»).
من هذا المنطلق يسعى المفكر المغربي علي بنمخلوف في مصنفه الأخير «الحوار أسلوبا للعيش»- الصادر حديثا عن منشورات ألبان ميشال الفرنسية 2016 – إلى الإسهام في إضاءة هذا الوعي، إيمانا منه بأن الحوار يأخذ عن طريق الكلام شكلا حضاريّا، ويبتعد عن ضروب الاستعراض، وعرض المذاهب، ناهيك عن كونه يتخطى كل أشكال الصراع الأيديولوجي ذي اللبوس الجدلي. ولعل الكلام الملغّز والمشفّر، هو ما يجعل طريق الفهم مفتوحة أمام مداخل متعددة، فنحن نتحاور لكي نغذي شكوكنا، لا لكي نزيد من وطأة يقينياتنا، كما أن التركيز على قيمة الحوار، بما هو تبادل للكلام لا ينتقص من شأن فعل الكتابة، بقدر ما يزيده حيوية وانتعاشا. على أن الخطاب لا يتحدد في كونه مجموع منظم لما ننتجه من قول، ولا في الطريقة التي ننتجه بها، وإنما في ما لا نقوله اي في ما نخفيه، بل ويتمظهر في أفعالنا وسلوكاتنا، إنه مجموع المعاني المقيَّدة والمقيِّدة التي تنتشر عن طريق العلاقات الاجتماعية.
ويدل استحضار علي بنمخلوف لأطروحة ميشال فوكو حول موضوع الخطاب، على أهميتها وجريان مفعولها، ودلالتها القوية، إن إنتاج الخطاب «في كل مجتمع، هو في الوقت نفسه إنتاج مراقب، ومنتقى، ومنظم ومعاد توزيعه من خلال عدد من الإجراءات التي يكون دورها هو الحد من سلطاته ومخاطره، والتحكم في حدوثه المحتمل، وإخفاء ماديته الثقيلة والرهيبة. إننا نعرف طبعا، في مجتمع كمجتمعنا، اجراء الاستبعاد.
أكثر هذه الإجراءات بداهة، وأكثرها تداولا كذلك هي المنع. إننا نعرف جيدا أنه ليس لدينا الحق في أن نقول كل شيء، وأننا لا يمكن أن نتحدث عن كل شيء في كل ظرف، ونعرف آخيرا ألا أحد يمكنه أن يتحدث عن أي شيء كان. هناك الموضوع الذي لا يجوز الحديث عنه وهناك الطقوس الخاصة بكل ظرف، وحق الامتياز أو الخصوصية الممنوح للذات المتحدثة: تلك هي لعبة الأنواع الثلاثة، من إجراءات المنع التي تتقاطع وتتعاضد أو يعوض بعضها بعضا، مشكّلة سياجا معقدا يتعدل باستمرار. أشير فقط إلى أن المناطق التي أحكم السياج حولها، وتتضاعف حولها الخانات السوداء في أيامنا هذه هي مناطق الجنس والسياسة: وكأن الخطاب، بدل أن يكون هذا العنصر الشفاف أو المحايد الذي يجرّد فيه الجنس من سلاحه، وتكتسب فيه السياسة طابعا سليما، هو أحد المواقع التي تمارس فيها هذه المناطق بعض سلطتها الرهيبة بشكل أفضل. يبدو أن الخطاب في ظاهره شيء بسيط، لكن أشكال المنع التي تلحقه تكشف باكرا وبسرعة عن ارتباطه بالرغبة والسلطة. وما المستغرب في ذلك مادام الخطاب ـ وقد أوضح لنا التحليل النفسي ذلك- ليس فقط هو ما يظهر (أو يخفي الرغبة، لكنه أيضا هو موضوع الرغبة. وما دام الخطاب- والتاريخ ما فتئ يعلمنا ذلك – ليس فقط هو ما يترجم الصراعات أو أنظمة السيطرة، لكنه هو ما نصارع به، وهو السلطة التي نحاول الاستيلاء عليها».
ويسعى الخطاب، حسب بنمخلوف، إلى جعل الآخر قريبا من القول، إنه يعامل الآخر وكأنه ماثل أمامه، إذ نتخيل ونحن نقرأ رسالة أن صاحبها يقرأ كلماتها، وأنه ثمة ابتسامة ترافق هذه القراءة، وهذه عملية يمكننا أن نباشرها دون معرفة الآخر الذي يخاطبنا، بيد أن القراءة هي حوار مع أشخاص ينتمون إلى الماضي، كما أوضح ذلك ديكارت في كتابه البديع «مقالة في المنهج».
يهدف مصنف علي بنمخلوف، إلى تقديم بعض النظريات العامة، التي تمت صياغتها حول موضوع الحوار، مستنطقا النماذج التي عرضها مونتاني، ونخص بالذكر كتابه: «فن التحاور»، ومن أجل ذلك يدعونا بنمخلوف إلى مشاركته رحلة طويلة ومشوقة، سنقف من خلالها على نماذج من الأدب والفلسفة تركت بصمتها في تاريخ التجربة الإنسانية المشتركة، فمن مناخ القرن التاسع عشر الأنغلوساكسوني، حيث لويس كارول وجاك غودي وجيمس أ. ج، سيعرج بنا بنمخلوف إلى أجواء القرون الوسطى وبالضبط بغداد القرن العاشر، حيث التوحيدي والفارابي، ليستقر بنا بعد ذلك على ضفة الأسئلة السيميائية التأويلية، وما يرافقها من أطروحات ذات لبوس ألسني تداولي، وفي ارتباط مع هذه القضايا السيميائية يقدم لنا بنمخلوف، الحوار كشكل من أشكال التعلم يضم عناصر فيها من اللعب والمرح ما يسهل عملية تخزينها في الذاكرة، فبدون هذا اللعب سيتهدد التلميذ الناشئ خطر الوقوع في شراك الملل والرتابة والسأم، الذي وسم حالة «أليس» في بداية حكاية لويس كارول الرائعة: «مغـــامرات أليس في بلاد العجائب».
«أليس» التي كانت تجلس مع أختها الكبرى في حديقة البيت، هاته الأخيرة التي كانت تحدثها عن العالم من خلال كتاب من كتب التاريخ، ولكن «أليس» لم تكن تصغي لها، لأن الكتاب افتقر إلى الرسوم والصور التوضيحية والمحاورات والنقاش، ويحث عوض ذلك على الحفظ واستظهار القواعد النحوية بشكل ميكانيكي، هذا ما جعل «أليس» تفكر في عالمها الخاص، وتحلق بعقلها الصغير وخيالها المجنح بعيدا عن أرض الواقع.
والحوار بما هو مغامرة بطلتها العبارة، لا يحيي الكلمات وينعشها فقط، بل ولا يبحث كما هو حال فلوبير وبروست عن الحياة خلف وداخل الكلمات، وإنما عن طريقها وبها يحد من خطر الصمت، ويتيح إمكانات إنقاذ الآخر، ويرسخ بالتالي الوظيفة الحيوية للحوار والتحاور، التي من خلالها لا نتبادل الكلمات فقط، وإنما الأجساد أيضا. يتغيى بنمخلوف من خلال مصنفه هذا إذن، إبراز مدى فاعلية وحركية الكلمات.
ترى هل تفسد الكتابة الحوار؟
كلا فالكتابة خزان، إنها أرشيف شاهد على أهمية الكلام، فمراسلات فلوبير وآثار مونتاني ومذكرات سان سيمون ومغامرات أليس في بلاد العجائب للويس كارول، وغيرها كثير، تبرز غنى الأساليب والترنيمات والإيقاعات، ونَفَسْ الكلمات ومختلف الأصوات المنبعثة، وأثرها في تحقيق وإنعاش عمليات الفهم. إذ يجتمع كل هؤلاء الكتاب والفلاسفة، حسب علي بنمخلوف ضمن دائرة الكتابة الشفوية، فكتاباتهم تنقلنا مباشرة إلى عالم الحوار، كل بطريقته الخاصة يلح على شكل وصوت شخصياته، ويسلط الضوء على تعدد أشكال تعبيراتها ونطقها.
يرفض علي بنمخلوف آراء المتصوفة الملتفين حول حلقة المعنى الواحد الأوحد، الذين يحملون على الاعتقاد أن الكلمة حمالة معنى وحيد، وأنه من خلال الكلمات فقط ينبجس هذا المعنى، إنهم يروجون لأسطورة عظمى ذات محور صلد يصعب اختراقه، بيد أن لعبة الألفاظ المتجانسة ذات المعاني المتباينة (HOMONYMIE) التي وظفها لويس كارول، تظهر على شكل إرادة قوية تسعى إلى وضع حد لطباع المعنى السريالية التي تقدمها الكتابة ذات البعد الواحد والوحيد.
ويختتم علي بنمخلوف مصنفه بسؤال ذي طابع بيداغوجي: هل من الضروري المرور عبر الحكاية والرسوم المتحركة، والأطفال مثل «أليس» وشخصيات حتى نأخذ الحوار على محمل الجد، أي من أجل مزج التركيبات الشعرية بالواقعية؟
إجابة منه على هذا السؤال يرى بنمخلوف أن التجريد الرياضي والتخييل الشعري، عنصران متعارضان ومتباعدان لا يمكن إلا للحوار أن يسلط عليهما الضوء ويضعهما جنبا لجنب، بيد أن التفكير الصارم المتشابك التعقيد، يمكن ترجمته إلى صيغ تبادلية، فيها من الأخذ والرد في الكلام، والفكاهة والمرح، بما يسهل إمكانات تخزينها وحفظها في الذاكرة.
(القدس العربي)