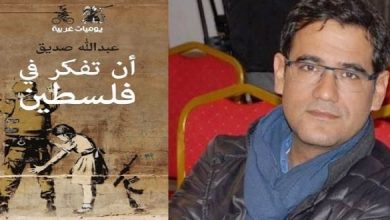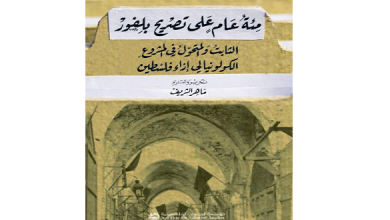«الحمام لا يطير في بريدة» للسعودي يوسف المحيميد: من الحكاية إلى الخطاب

زهور كرام
تلتقي الشعوب والمجتمعات في الحكايات، وتختلف في بنائها. المجتمعات التي تتأخر في بناء حكاياتها، يتعطل وعيها الضمني عن التجلي. كل المجتمعات تلتقي في مضمون الحكايات ونوعها، مع اختلافات جزئية قد لا تُؤثر في محتوى الحكايات، غير أن الاختلاف يحدث في شكل بناء الحكاية، أو بتعبير الدرس الأدبي في خطابها. وعندما نُفكر في الرواية، باعتبارها جنسا تعبيريا وتشخيصيا لعوالم الحكايات، فإن التفكير لا يستقر في الحكاية، بل يُغادرها باتجاه تنظيمها/ خطابها. كلما اشتغل زمن الخطاب، وأقام مسافة كبيرة بينه وبين زمن الحكاية، مع القدرة على تنويع مجالات المسافة وتطويعها، والتحرك فيها بشكل يجعل زمن الحكاية يخفت تدريجيا، إلى حد التلاشي، استطاع زمن الخطاب الانغراس في تربة المجتمع. لهذا، تعتبر أبنية الخطابات الروائية من بين المداخل الثقافية لإنتاج وعي بمسار مجتمع.
يطرح خطاب رواية «الحمام لا يطير في بريدة» (2009) للكاتب السعودي يوسف المحيميد، الاقتراب من تركيبة المجتمع من خلال ثلاثة أجيال ( فهد، الوالد، الجد)، يُنتج الجوار بين تصوراتها روائيا عدة دلالات، مُؤهلة لإنتاج وعي بما كان، وما حدث، وكيف حدث.
يعتبر زمن الخطاب في الرواية من أهم عناصر قوة التبليغ الروائية للحكاية. ويظهر ذلك، من طبيعة زمن القصة الذي تحدد في أربع ساعات، بدأت بصعود الشخصية المحورية في الرواية «فهد سليمان السفيلاوي» القطار من محطة ليفربول في لندن، وانتهت بمحطة مدينة «غريت بارموت». غير أن محاولة «فهد» الاتصال هاتفيا بصديقه «سعيد» في الرياض، حملت له أغنية قديمة لخالد عبد الرحمن، التي أيقظت ذاكرته، وأرجعته بسرعة إلى هناك، إلى الرياض وبريدة، إلى الحياة في السعودية، فتعطل فضاء القصة/ لندن، وزمنها، واستيقظ الفضاء الخارجي، بكل آلامه وانتكاساته وأحزانه. تشكل منطق السرد من عملية توليد الحدث من سابقه، ودعمه من لاحقه. كل حدث لا يحضر باكتفاء ذاتي، أو تعبير عن خبر حكائي، ولكنه ينمو من خلال استدعاء السرد لحدث آخر. لا يستقيم الحدث إلا بحضور حدث آخر يُولد دلالته. يخضع الحكي لترتيب السرد الذي يُولد الأحداث من بعضها، ويجعل قانون وجود كل حدث مُرتبطا بحدث آخر، ليس باعتباره فعلا اجتماعيا ضمن نسق التعاقدات الاجتماعية، كما تُعلن عن ذلك الحكاية، وإنما باعتباره تأويلا للفعل الاجتماعي عبر نظام الخطاب الروائي. وعليه، فإن علاقة الجوار التي تتم بين الأحداث تُشكل منطق التأويل، وتضع أحداث الحكاية/الحكايات أمام عري زمن الخطاب. يُحقق منطق الجوار علاقة حوار بين فكرتين أو ظاهرتين، أو يقرأ الحدث الأول بالثاني، حين يُعري الثاني الأول، ويفضح تناقضه.
تجلى هذا المنطق في علاقات جوار كثيرة، مثل جوار حدث قانون فرض زي موحد لعمل السعوديات، وحكاية ظاهرة البويا يقول السارد «(…) لم تكن وحدها في الأكاديمية، بل أن ثمة خمس بنات، أو «بويات» كما يسمونهن، يلبسن الجينز والقميص الفضفاض، وحذاء رياضيا، ونظارات شمسية، ويتجولن في الساحة يعاكسن البنات». إن تجاور هذين الحدثين أو الحكايتين، يجعل الحدث الأول يفقد قيمته القانونية، عندما يُفرغه من شرعيته. كما يأتي الحدث الثاني وظيفيا.
يُعري تجاور الأحداث علاقة التناقض التي تُميز سلوك وخطاب الشخصيات النصية، هكذا، يُجاوِرُ حدث طلب عم فهد الزواج من والدته «سها» بعد وفاة والده «سليمان»، حدث رفض أخ سليمان زواجه من سها الأردنية، ومحاربته هذا الزواج، واعتباره خروجا عن قانون العائلة، يطلــــبها للزواج بعد وفــــاة سليمــــان، «(…) حدث ما لم يكن متوقعا حين جاء أخوه، إمام المسجد، بعد خمسة عشر عاما، لينكح زوجته، وهو الذي أرسل تهديدا له، حين علم بزواجه من أجنبية».
كما يتحقق الحوار الفكري بين تصورات من خلال منطق الجوار بين الرؤى حول السلفية، وباقي الخطابات الدينية التي تتجاور في الرواية من خلال ملفوظات منتجيها، فيحدث الاصطدام بين الخطابات أكثر من الشخصيات، كما يبتكر السرد في رواية المحيميد صيغا لمواجهة الخطابات الدينية، بطرق لامباشرة، عندما يخترق خطاباتها بابتكار خطابات بديلة، يتجاوز بها السرد الحدث الأول الذي تُنتجه الخطابات الدينية، مثلما حدث مع واقعة فضاء المسرح، عندما يدخل فهد وصديقه «سعيد» المسرح لمشاهدة مسرحية «وسطي بلا وسطية»، تتم مهاجمة المسرحية واختراقها. تتعثر المسرحية عند عتبات الحكاية، فيبتكر السرد مسرحية تكتب الأولى، وتتجاوزها حين تسخر منها، وتُقيم الحدود معها. نلتقي بمسرحية فوق مسرحية، السرد يكتب مسرحية على مسرحية ليجيب عن سؤال موقع الاعتدال والوسطية في الإسلام في الواقع، وإمكانية تحقيق رهان الاعتدال وإكراهاته. كما أن منطق الجوار يتخذ شكل علاقة الشخصية بالفضاء، وتبادل دور التأثير الإيجابي/السلبي. فالفضاء الرتيب في الحكاية، يتحرك سرديا من خلال السيارة التي تتحول- بدورها- إلى موقع لرؤية الشخصية. من داخل السيارة تُحرك الشخصية الأمكنة، وتُخرجها من عتباتها، وفي الوقت نفسه، تُحقق الشخصية انتصارا على الحكاية، حين يجعلها السرد صاحبة رؤية.
لا يتجلى الخطاب الجديد للشخصيات في علاقة مع الفضاء بشكل مباشر، ولا تضع الرواية الشخصيات عارية من التعاقدات الاجتماعية، كما لا تفضح صحوها، وتُقدمها للرقيب صوتا صارخا، إنما اللعبة السردية تشتغل بمرونة، تُعادل وضعية الصوت المُراقب. من طبيعة نظام السرد، واعتماد منطق الجوار باعتباره علامة دالة، وبناء الفضاء بصيغ الوصف وحركة الشخصيات، والحضور المهيمن للسيارة التي تحولت إلى موقع للرؤية، فإن تركيبة هذا النظام أنتجت صوتا يُحاور السلطة، ولا يهاجمها، ويُجادل وظيفتها ولا يُلغيها، ويُناقش تناقضاتها من خلال مكوناتها ولا يُحاربها.
كما أن الحمام الذي أعلنت الحكاية أنه لا يطير في مكان بريدة، هو الذي حرَك السرد، ومنح الحياة للحكاية بإدخالها في ترتيب جديد، بموجب منطق جوار الأحداث، فبزغ الطيران، ليس باعتباره فعلا قائما، إنما حضر سرديا بصيغتين تجعل أفق الرواية منفتحا على تعدد الخيار. حضر مرة باعتباره احتمالا ممكنا، لذا جاء مع تلاشي السرد، ونهاية الحكاية، وأخذ صورة أغنية سيلين ديون «أممممــــم… أمممـــــــم.. أنال جناحين لأطير» بينما طفل يشبهه يدير بسبابته ثلاث ريشات في مقدمة طائرة التحكم عن بعد، ثم يضعها على مدرج، وحين تصدح ديون بصوتها النقي « أنا حي» تنطلق الطائرة من النافذة بهوس». أما الصيغة الثانية، أو الاختيار الثاني فجاء على شكل مقطع صغير نهاية الرواية يحمل عنوان «الجزء الأخير بياض بلا نهاية». يلتحق البياض بلانهاية بالأغنية لتتعمَق الرؤية الروائية لدى يوسف المحيميد في انفتاح حكايات المجتمع على خيارات عديدة للمحاورة.
ينفتح السرد على حكاية «الحمام الذي لا يطير في بريدة» من خلال ثلاثة أجيال. يجعل جيل الوسائط التكنولوجية، ويمثلها «فهد» محطة للتعرف على تاريخ الذهنيات والتصورات التي تُعرقل طيران الحمام. لا يستقيم الفضاء الخارجي إلا بانخراط الحكي في الأجيال الثلاثة، الجد والوالد والابن. وبين هذه الأجيال، يتم حكي الدين، باعتباره فهما من قبل مستعمليه، والسياسة من خلال الأمكنة والشخصيات وازدواجية الخطابات. يمنح السرد جيل الوسائط التكنولوجية أهمية في تصريف الرؤية الروائية، أو ما يُصطلح عليه بالوعي الضمني الروائي، دون أن يُقصي الأجيال السابقة، بل يشتغل بوجودها باعتبارها ذوات مُستمرة، إما بالإيجاب مثل والدة «فهد» أو بالسلبي كما يمــــثل ذلك العم وابنه.
تأسيسا على هذا الطرح، فإن الرواية تُصبح ضرورة وحاجة لإقامة التوازن الممكن بين واقع الفعل الإنساني ضمن شروط بنيات مجتمع، وإمكانية إنتاج وعي ممكن بهذا الواقع.
(القدس العربي)