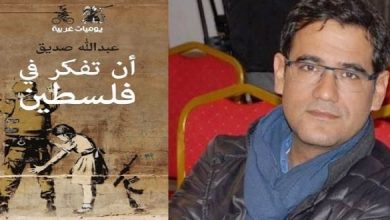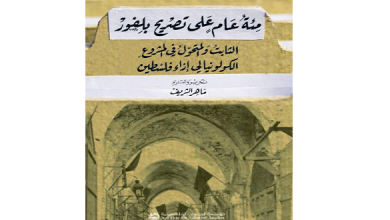المتخيل وسلطة الواقع في «رماد بطعم الحداد» لمصطفى يعلى

عبد السلام دخان
يتخذ تلقي العمل القصصي الموسوم بـ«رماد بطعم الحداد» للأكاديمي مصطفى يعلى الصادر حديثا في طبعته الأولى عن مطبعة الأمنية في الرباط (المغرب)، طابعا إشكاليا يرتبط بمكونات وسمات هذا العمل، وبالأبعاد النصية والتداولية للعمل القصصي، التي تقتضي استحضار البعد المعرفي والوظيفي والنقدي المساهم في تشكيل عوالم ومعالم «رماد بطعم الحداد»، ذلك أن اجتراح أي مقاربة تقتضي الاقتراب الحذر من السند الأول لهذا العمل القصصي، ونقصد بذلك اللغة القصصية كفعالية أدبية منفتحة على مرجعيات متعددة، وعلى المتخيل السوسيونصي بما يكشف طبيعة الوعي الجمالي المؤطر للبنيات التركيبية ولسياقات إنتاج الدلالة.
إن الإخلاص لجنس القصة القصيرة هو سمة بارزة في هذا العمل السردي الذي يكشف انتماءه الأجناسي من أول قصة توحي بأننا بصدد نصوص قريبة من الميثاق السردي الذي تحدث عنه فيليب لوجون، وبموجب هذا السياق هل كان المبدع مصطفى يعلى يكتب عن واقع سبق عيشه، أم أننا بصدد وقائع تخييلية لها سند مرجعي في السجل الواقعي؟
تكشف قصة «حالة مستعصية» في المجموعة القصصية تعدد جوانب السجل الواقعي، وينتج عن هذا الحضور جهد مضاعف حتى لا يقع المتلقي في فخاخ الإبدال الدلالي. فتساوق الحدث الأساس النابع من الجملة الافتتاحية «ارتشف الرشفة الأخيرة من القهوة المرة»مع الهواجس النفسية من خلال الشعور بالخيبة، وكشف بعض التعالقات الاجتماعية، يؤكد طبيعة الوعي القصصي المشكل لمكونات وسمات هذا المتن القصصي، وهو الوعي الذي مكننا من رصد بعض الظواهر الاجتماعية التي يمكن وصفها بالتقليدية مثل، لعب الورق، وتبادل النكت، ونمط العيش في الحي القديم. بيد أن المقول السياسي يمر عبر باب موارب يمكن تحديده بشكل أساس في سمة الغربة. وتقودنا مقولة فرانز كافكا «إن من يقرأ يفهم دوما أكثر مما ينبغي، أو أقل»، إلى تلمس مستويات الإبدال الدلالي في قصة «اعتذار مؤجل إلى زمن آخر» حيث تشير الدلالة الخطية إلى ظاهرة لعب الأطفال في الأزقة، وما ينتج عن ذلك من جلبة تحرم الساكنة من لحظات الهدوء المطلوبة، خاصة ساعة الظهيرة، وتشير في الآن نفسه إلى هيمنة الفضاء، سواء ارتبط الأمر بحارة السعادة أو بالأمكنة الأخرى المشار إليها تصريحا أو تلميحا. غير أن الحوار بين جيلين يشكل بؤرة هذا النص القصصي المتسم بالثراء الدلالي والجمالي. ويكشف هذا النص- على نحو خاص – قدرة الكاتب على استعادة الحيوات من خلال ما يصطلح عليه بول ريكور بفن الذاكرة، ليس كأحداث وقعت في الماضي، ولكن كتمثلات تعيد تشكيل الفضاء وإنتاج الأحداث في المناطق الصامتة في ذاكرة المبدع، لذلك فإن اللجوء إلى هذه الحفريات هو إجراء يتوخى إنتاج المعنى، عبر امتداد الحبكة السردية ارتباطا بما يسميه بول ريكور بالاندماج السردي بين مكونات العمل السردي (البنية- الظرف- الحديث).
وعبر هذا المنظور يمكننا تلمس خطوات الراوي وهو يجول بين الأمكنة في ما يشبه البحث المضني عن الطفل الذي يسكننا، واسترجاعا لأحداث موشومة في الذاكرة. مراحل التعليم الأولى، وحفظ جدول الضرب. غير أن الكاتب وبمكر يعمل على توقيف نمو المحكي السردي لصالح دينامية الزمن النفسي، ليضعنا في الأخير أمام نهاية غير متوقعة تفضي إلى تلمس ظواهر اجتماعية مختلة اصطلح عليها أنداك بـ»الحريك» في دلالة على الهجرة السرية.
ومن أجل الدخول إلى سراديب الذات وسبر أغوارها يقدم لنا القاص مصطفى يعلى نصا قصصيا شيقا موسوما بـ»رماد بطعم الحداد» العنوان الأساس للعمل القصصي، حيث الشعور بالحداد يظهر منذ أول صفحة يفوح منها عطر المرأة الفاتنة. القصة تكشف حوارا بين شاب حاصل على شهادة عليا في الآداب يصفها بالمعطوبة، وشابة حاصلة على دكتوراه في الهندسة الإعلامية، وهي من عائلة ميسورة صاحبة نفوذ سياسي، في تلميح إلى العلاقة المختلة بين الطبقات المكونة للمجتمع. لكن وجه الإمتاع في هذا النص يكمن في التصريح بفقدان السند السياسي، والبحث المضني عن الحبيبة التي اختفت بعد حديث ملتبس، وربما لايزال هذا الشاب يبحث عنها إلى الآن.
الامتداد الدلالي فسيح في هذا العمل القصصي المتسم بتعدد طرائق الاشتغال بوعي دقيق بمتطلبات الفن القصصي، وهو ما يسمح به المسح الأفقي لقضايا هذا العمل. ويمكننا هذا السند من رصد ملمح جديد في قصة» سكتة قلبية» من خلال العلاقة الملتبسة بالزمن منظوراً إليها بعين السارد، عبر وسيط الساعة التي ورثها عن أبيه، وأبوه ورثها من جده. الساعة ستصاب بالعطب في كشف دلالي لتحول القيم وأنماط السلوك الإنساني.
التحول نفسه سيمكننا رصده في قصة « ابتسامة غامضة جدا» حيث العلائق الجديدة الناتجة عن دخول محمولات الثقافة الإلكترونية إلى فن العيش، وإلى البيوت الموصدة قبلا، وما ينجم عن هذا الحضور الجديد للوسائط الإلكترونية من تحول في العلاقات عبر ما يمكن تسميته بـ»الرومانسية الرقمية».
تطويع الواقع، وتنصيبه كخلفية لتشكل العوالم السردية سمة مهيمنة في هذا العمل القصصي، يمكن الإشارة هنا إلى نص قصصي يكشف مرجعياته الفنية والجمالية، وإبدالاته انطلاقا من الحكاية الأساس المشكلة لهوية هذه القصة وانطلاقا من ملامح التجريب القصصي، من خلال توريط المتلقي في الحدث وفي إنتاج الدلالة. فضلا عن توظيف الراوي العليم، والرؤية مع، وتعدد المنظور السردي، والانفتاح على الحواس بدل الموضوعات، واستثمار الموروث الفكري الإنساني من خلال استحضار أسماء أعلام مثل سقراط، وقس بن ساعدة، ولقمان الحكيم. فضلا عن السخرية المبطنة في جل النصوص المشكلة للمتن السردي للأديب مصطفى يعلى الذي يرجئ الدلالة إلى حين، لأنه يتعمد بالإضمارات الثاوية في العمل القصصي، وبمشهدية التصوير القصصي إلى التلميح لطبيعة استراتيجيته الكتابية ومآلات التخييل. بيد أن المنظور السردي من خلال العلاقة بين السارد والشخصيات وحوافز الحكي يحقق درجات من أدبية النص، بالمعنى الذي تحدث عنه رومان جاكبسون في قدرته على المزاوجة بين شروط النص الجمالية والانفتاح على روافد متعددة، منها ما هو واقعي أوأسطوري أو من الموروث الشفاهي.
وقدرته على التقاط العابر والهـــــامشي وتحويله إلى المركز. مع تعمده في أحايين كثيرة توقيف السرد بغية تحقيق معادلة صعبة تعي الزمن وتوظف طاقة التخييل لتنصت لحواس الذات في الآن نفسه.
إن تأمل هذا العمل القصصي يفضي إلى تلمس الإرباكات التي يخلقها الكاتب، سواء على مستوى الدلالة أو الزمن. وإذا كنا لا نستطيع أن نستحضر عملا أدبيا دون أن نقوم بموضعته ارتباطا بمجموعة من المكونات المشكلة لهوية العمل السردي، فإنه يمكن القول إن المجموعة القصصية لمصطفى يعلى تكشف طبيعة مرجعياتها الفنية والجمالية، وارتباطها الوثيق بالمجتمع وبالصور الذهنية المشكلة لوعي الكاتب الجمالي، الأمر الذي يجعل العلاقات الفاعلية بمنظور غريماس تتسم بقدر كبير من الدينامية التي تكشف محمول الوعي الأنطولوجي وقدرته على تأريخ رؤى الذات في تراوحها الجمالي بين ممكنات التخييل، وجماليات المحتمل وسلطة الواقع. وربما هذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نحب القصة القصيرة كفن إبداعي سردي مخصوص.
(القدس العربي)