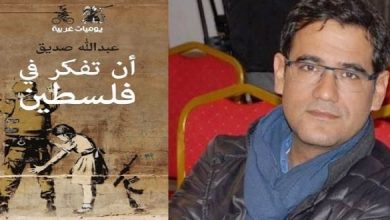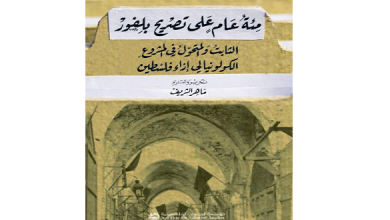نجاة علي تبرز القيم التي تبناها نجيب محفوظ في رواياته

محمد الحمامصي
أكدت الشاعرة د. نجاة علي في دراستها “الراوي في روايات نجيب محفوظ” أنه على الرغم من أن الروح العامة لكتابات نجيب محفوظ تضفي على راويه – للوهلة الأولى – صفة الحياد الظاهري، والتي تنسحب أيضًا على مجال صراع العقائد والأفكار في روايات هذه المراحل التالية مما جعله تقريبًا موضع إجماع دائم على مكانته من أغلب التيارات الفكرية، فإن الدراسة المتعمقة لوضعية السارد ووجهة النظر تُظهر أن هذا الحياد ظاهري “مزعوم”، فرغم أنه يتيح لقارئه أن يتعرف على وجهات النظر المختلفة لأحداث الرواية فإنه ليس محايدًا للنهاية.
وقالت في دراستها التي نالت عنها درجة الدكتوراه وصدرت أخيرا عن كتاب الهلال أن الدراسة تقوم على أساس عدة تساؤلات عن راوي نجيب محفوظ من مثل: ما علاقة الراوي بوجهة النظر؟ وما علاقة الراوي بالخطاب الروائي؟ وما دور الراوي في تشكيل تقنيات السرد عند نجيب محفوظ؟ ما مدى انعكاس شكل الراوي أو موقعه في روايات نجيب محفوظ على بنية الروايات نفسها؟ ما أثر شكل الراوي أو تحولاته على شكل البنية في روايات نجيب محفوظ؟ ما علاقة الراوي بالأيديولوجيات المتنوعة والمتعارضة في روايات نجيب محفوظ؟
ولفتت نجاة علي أن الهدف الرئيسي من موضوع الدراسة هنا هو الكشف عن خصوصية الراوي في روايات نجيب محفوظ من ناحية، واكتشاف جماليات خاصة بفعل الكتابة الروائية لديه من ناحية أخرى .
وقالت “إذا كان الراوي هو العنصر الرئيسي لدراسة بنية السرد الروائي، وهو العنصر المشكل لبقية العناصر السردية الأخرى، وهو المتحكم في شكل البنية وتأليف الخطابات وبناء الشخصيات، واللغة التي تتحدد وفق وجهة نظره، وتبعًا لموقعه فيما يروي، والمسافة التي تفصله عن الكاتب من ناحية وعن الشخصيات من ناحية أخرى، فإن دراسته تصبح وسيلة مهمة لفهم أيديولوجيا النص، وكشف أفكار المؤلف الضمني”.
أوضحت نجاة في دراستها التطبيقية أن خطاب محفوظ الروائي لم يكن منعزلاً أو مفصولاً عن السياق السياسي والاجتماعي، بل كان متفاعلاً معه، بل إن رواياته كانت أشبه بالتأريخ له، وإن لم يسقط في فخ التسجيل الفوتوغرافي للواقع. حيث قام بدور المؤرخ لتحولات المجتمع السياسية والاجتماعية، وعبّر بإنسانية عن همومه وتساؤلاته وتشوهاته أيضًا بكل جرأة، والتي تمثلت في كل مراحله الإبداعية سواء كانت التاريخية أو الواقعية أو الفلسفية، على أنه يصعب الفصل بينها بشكل حدي، كما أنه لا يمكننا في روايات محفوظ كذلك أن نفصل خطاب الراوي عن خطاب الكاتب بشكل قطعي، إذ أحيانًا تتلاشى بينهما الحدود الفاصلة.
وقد اتضح من خلال الدراسة أن خطاب الراوي كان له مستويان: مستوى سطحي ظاهر، ومستوى آخر عميق. وقد تميز خطاب الراوي/الكاتب بالجرأة في خرق التابوهات وبالأخص “التابو الجمالي” وإنطاق المسكوت عنه في الرواية العربية، إذ يبدو راوي محفوظ أشبه بالجرّاح الذي لا يتورع عن التعامل بكل قسوة مع شخصياته، وقد تجلى هذا أيضًا في طرحه لجماليات جديدة على الرواية العربية، وهو ما أسميته في هذه الدراسة «جماليات القبح»، والتي قدمها محفوظ ببلاغته الخاصة. ومن هنا كان محفوظ سباقًا في طرح التشوهات الإنسانية في الرواية العربية وتقديمها كنماذج حية من المجتمع المصري. وقد عكس خطاب الراوي عند محفوظ وعيًا ضديًّا بالعالم قادرًا على رؤية المتناقضات في كل شيء من حوله.
ورأت أن علوَّ صوت المؤلف الضمني الذي يكمن وراء الشخصيات والمواقف والأحداث في روايات نجيب محفوظ، وهو ما يتسق وشيوع الضمير السارد الغائب، وعدم وجود مسافة كبيرة في بعض الأحيان بين الراوي وعالمه.
وأضافت “على الرغم من ذلك أثبتت الدراسة إمكان رصد ملامح المؤلف الضمني في روايات محفوظ من خلال تتبع بعض الشخصيات ومدى تمثل الراوي وجهة نظرها، أو تتبع بعض الحوارات أو التيمات المتواترة، وهي تعكس القيم التي تبناها محفوظ عبر مشروعه الروائي الطويل.
ومن أبرز أهم الملامح المتواترة لصورة المؤلف الضمني في روايات محفوظ ما يلي:
أولا الانحياز إلى عالم الفقراء والمهمشين، وهو ما جعله يعيد لهم الاعتبار عبر تسليط كاميرا السرد عليهم، مع انتفاء فكرة التعاطف الرومانسي في التعامل مع الشخصيات التي مثلت هذه الطبقات المهمشة.
ثانيا: التركيز على الأحياء الشعبية في القاهرة بوصفها أكثر تعبيرًا عن عوالم الفقراء وهم الأغلبية العظمى من الشعب المصري.
ثالثا: الانحياز الواضح لمبدأ العدالة الإنسانية والكراهية لكل أشكال الظلم والقهر في العالم، وهو ما يجعل الراوي في مواضع كثيرة مفتقدًا للحياد وغير قادر على اتخاذ مسافة مما يروي، حيث نشهد تحيزات الراوي “الأخلاقية” وخاصة في تعليقاته وأحكامه وآرائه المضمرة في السرد.
رابعا: الإيمان بقيمة العلم والرغبة في مبادئه، وهو ما يتضح في مواضع كثيرة من روايات محفوظ، وربما هذا الإيمان هو الذي شكَّل البناء الدرامي لرواية “أولاد حارتنا”، فقد أحسسنا بالمغزى الكامن وراء حركة التاريخ، وهي الحركة التي تعتمد على قوانين النسبية والعلة والنتيجة والقوة والمقاومة والعرض والطلب والكم والكيف، وكلها قوانين نهض عليها العلم الحديث.
وأكدت نجاة علي وجود علاقة وثيقة بين التغيير الذي طرأ على طبيعة الراوي في روايات محفوظ وبين تقنيات صياغة المادة القصصية التي ظهر عليها هذا التحول، فالمادة القصصية التي تقدَّم في العمل الروائي لا تقدَّم مجردة أو في صورة موضوعية تقريرية، إنما تخضع لتنظيم خاص منبثق من وجهة النظر الذي ترى من خلاله. والتقنية نفسها تعكس أيديولوجيا الراوي وتوجهاته، إذ ليس هناك تقنية دون أيديولوجيا، فالتقنية نفسها اختيار بين بدائل.
وأضافت “تحولات الراوي الجمالية ارتبطت بتحول جذري في وعي الكاتب بالعالم، حيث انتقل الراوي من أسلوب العليم بكل شيء الواثق من أحكامه والحائز الوحيد لسلطة امتلاك الحقيقة – والذي ظهر على نحو خاص في المرحلة الواقعية من كتابة محفوظ – إلى راوٍ متعدد، تتفكك مركزيته ويفقد الكثير من سلطاته، فليس هناك راوٍ يحتكر سلطة الكلام، أو يمتلك القدرة على معرفة كل شيء، بل هناك رواة عدة يشغل كل واحد منهم حيزًا منفصلاً من المساحة الكلامية للرواية على نحو ما رأينا مثلاً في رواية “ميرامار”.
وفي هذا النمط من الروايات يستخدم السرد بعض التقنيات التي تستهدف كسر التصور الواحد للحقيقة. ثم نشهد الراوي في هيئة الراوي المتشظي، وهو أقرب ما يكون إلى “الذات المفككة” التي تحاول أن تدرك ذاتها من خلال مرايا الآخرين، على نحو ما نرى في رواية “المرايا”.
خلصت نجاة علي في الجزء الخاص بـ “الراوي وشعرية اللغة” إلى أن السمات اللغوية في سرد نجيب محفوظ تظهر على مستويين؛ المستوى الأول: هو مستوى الاستخدام المباشر للغة؛ أي أن المعنى المقصود واضح للقارئ. والمستوى الآخر هو مستوى الاستخدام غير المباشر، ويظهر في اللعب في استخدام اللغة، والمعنى المقصود يكون فيه بعيدًا، ويحتاج إلى إعمال الفكر والتأويل للوصول إليه.
وقالت “لا شك في أن العلاقة بين النص والقارئ تقوم من خلال اللغة، على افتراض قارئ ضمني قادر على التمييز بين الظاهر والخفي في النص؛ فاللغة تعبر عن وعي الكاتب بالعالم وتعكس علاقته به، ومن خلالها يتمكن – عبر اللعب بها واستخدام البلاغة ووسائلها المتعددة مثل الاستعارة والمفارقة اللفظية والكناية، وغيرها – من تشكيل العالم عبر طرق مختلفة. وحدث تطور في وعي الكاتب الذي بدا في أولى روايات محفوظ وعيًا كلاسيكيًّا يتخذ نموذجه الأعلى “القرآن الكريم” – إلى وعي حداثي يجرب في اللغة، ويحاول ترويض تلك البلاغة وتكييفها لتتناسب مع أغراضه. وقد ارتبط على نحو ما ذلك التطور والتطور الخارجي في الواقع، السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري. وهو ما انعكس إلى حد بعيد على لغة الراوي ولغة الشخصيات داخل روايات محفوظ.
ولاحظت أن ثمة علاقة وثيقة الارتباط بين التطورات السياسية والاجتماعية للواقع المصري وبين التغيرات الأسلوبية من ناحية، وتنوع مصدر المادة الموضوعية لأعمال نجيب محفوظ من ناحية أخرى.
وأجملتها إيجازا على النحو التالي:
أولا: ولع الراوي باستخدام اللغة المجازية – بوصفها تقنية جمالية – والتي تغرق كثيرًا في الاستعارات والمجاز والتشبيه والكناية. وهو ما وسّع دائرة التأويل النقدي لرواياته.
ثانيا: قدرة الراوي على ابتكار استعارات جديدة داخل النص الروائي، وهي لا شك تحتاج إلى قدرة خاصة من الكاتب تمكّنه من اكتشاف العلاقات الخفية بين الأشياء، وقد عمد الراوي إلى استخدام بعض التراكيب الحية المنقولة من لغة الحياة اليومية.
ثالثا: عدم انشغال الراوي بالاستعارة في حد ذاتها، باعتبارها شيئًا تزويقيًّا للنص الروائي، بل انحصر انشغاله الأساسي في التأكيد على الاستعارة بوصفها بصيرة تغوص بعمق في المشاعر الإنسانية.
ورابعا: اعتماد الكاتب على “المفارقة” داخل الرواية وفي كثير من الأحيان بغرض مراوغة السلطة أو الرقابة، وعلى وجه الخصوص استخدام “المفارقة الخفية” على نحو ما نرى في رواياته الأليجورية مثلاً – وقد تميز هذا النوع من المفارقة بخاصية التعمد في إخفائها وجعلها غير مرئية، وصاحب المفارقة فيها يتجنب أية إشارة من شأنها أن تكشف مفارقته بشكل مباشر وواضح، سواء أكانت هذه الإشارة في النغمة أم السلوك أم الأسلوب. فهو يحاول أن يمرر ما يريد أن يقوله دون أن يُكتشف.
خامسا: ولع الراوي باللغة القرآنية وتشبعه بجمالياتها والتناص معها يبدو واضحًا في مواضع كثيرة. وهو ما يظهر في استخدام الراوي صيغًا لغوية تعتمد على بعض الألفاظ أو العبارات القرآنية، والتي يعمل الراوي على إعطائها معنى مختلفًا تكتسبه من خلال السياق النصي.
سادسا: حرص الراوي على استخدم مستوى العامية المصرية البسيطة القاهرية في بعض الحوارات.
سابعا: استخدام لغة الصمت الاستراتيجى المتعمد أحيانًا في النص مما يعمق نفسيًّا ودراميًّا بعض اللحظات في البناء الروائي، وهي غالبًا ما تعبر عن الباطن النفسى الدال أكثر مما تعبر عن حقيقة خارجية.
كشفت نجاة علي أن دور المفارقات الزمنية بمختلف أنواعها في روايات محفوظ، ينحصر في:
أولا: الكشف عن سيكولوجية الشخصية كما لاحظنا مثلاً في رواية “ميرامار”.
ثانيا: إضاءة الأحداث المركبة تكون بالإرجاع التكراري الذي ينحصر في دور الكشف أو التفسير أو الاستباق التكراري ذي الطبيعة الإعلانية، والذي يخلق نوعًا من التشويق السردي لدى القارئ.
ثالثا: أن كل المفارقات الزمنية بمختلف أنواعها ومستوياتها، والتي تؤطر الحاضر، تتضافر ومختلف التكرارات والتكرارات المتشابهة التي يؤطرها حاضر تسجيل الحدث زمنيًّا، ويؤكدها تعدد الصيغ التي ليس خطاب الراوى إلا صيغة تتضافر وغيرها للإخبار عن الحدث.
رابعا: أن وجهة نظر الراوي تبدو مسيطرة ومتحكمة إلى حد بعيد في تشكيل المفارقات الزمنية وتحديد مستوياتها، والتي تتسم في كثير من الأحيان بأنها وجهة نظر أخلاقية ترتكز على مجموعة من المبادئ يؤمن بها الراوي ولا يحيد عنها كثيرًا.
خامسا: تطرح الاستباقات الداخلية الموجودة في بعض الروايات نوع المشاكل نفسه الذي تطرحه الاسترجاعات التي من النمط نفسه، ألا وهو مشكلة التداخل، ومشكلة المزاوجة بين الحكاية الأولى والحكاية التي يتولاها المقطع الاستباقي.
وفيما يتعلق بالراوي وتداخل الزمان والمكان، رأت أن استخدم محفوظ الحارة بشكل يجعلها مزدوجة الدلالة، فقد تكون الحارة لديه “حارة حقيقية”، وقد تكون رمزًا للعالم كله يختزل فيها محفوظ كل أسئلته وهواجسه الوجودية. لكن على أية حال، حارة محفوظ ليست ككل الحارات، إنها حارة بملامح متفردة تجري فيها أسطورته الخاصة التي ظل يصوغها على مدى طويل. فالحارة لدى محفوظ لها مستويان أساسيان: المستوى الواقعي: كما يتضح في روايتي “زقاق المدق”، و”خان الخليلي”، وغيرهما وكانت صورة حية للمجتمع المصري وصراعاته وتطوراته المختلفة مع الجديد في الحضارة الحديثة، وتبرز فيه عناية الكاتب بالملامح التفصيلية الدقيقة والواقعية للمكان الذي يقوم بتصويره. المستوى الفلسفي: حيث تصبح الحارة بديلاً عن العالم بأسره وصورة مختزلة للحياة بكل ما فيها من أفكار ومصائر وأقدار وصراعات هائلة كما في رواية “أولاد حارتنا”.
وأوضحت نجاة علي أن ثمة علاقة مطروحة بقوة بين الحارة والعدم أو الحارة والنسيان في رواية “أولاد حارتنا”، وهو ما يقترن بغياب العدالة التي يؤكد عليها الراوي، فهي المكان الذي يشهد كل العهود الماضية والآتية، هي وحدها الشيء الثابت الوحيد في مقابل متغيرات كثيرة تجري عليها من تعاقب لفترات عدل وظلم، ومن صعود لطغاة وانكسارهم وصعود آخرين غيرهم.
ولفتت إلى أن الزمن في الحارة عبارة عن دورات متعاقبة تبدو متكررة ومتشابهة في أحيان كثيرة، تحمل نفس الملامح، ومع بداية كل دورة جديدة نرى ملامحه متجسدة في الحارة، حيث غالبًا ما يفتتح الراوي بداية كل دورة زمنية برسم صورة لتلك التغيرات. وأن للحارة أزمنتها الخاصة، لا تكاد نلمح فيها إشارات كثيرة تحيل إلى “زمن تاريخي” محدد أو “زمن المدينة”.
وأضافت أن استخدام المقهى داخل الروايات بوصفه زمكان التحول، وغالبًا ما يرتبط ذكره بعملية تحول في مسار الحكاية وإشارة إلى حدث جديد يغير مجرى السرد. ويمكن أيضًا أن يُستخدم للإشارة إلى تحولات تاريخية واجتماعية قد طرأت على حياة الناس في مصر.
(ميدل ايست اونلاين)