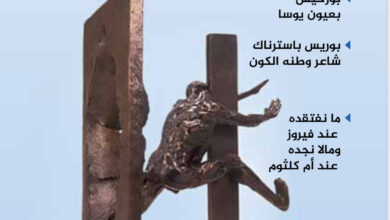خلدون النبواني: دولة البعث إسبارطة عسكرية

الجسرة الثقافية الالكترونية-العرب-
*روز جبران
عرف عن خلدون النبواني موقفه الإنساني المنفتح والمناصر لثورة الإنسان في سوريا، مركزا على أهمية دور المثقف في ذلك، ومؤسسا للطرق المثلى التي يتوجب على المثقفين العرب انتهاجها نصرة لشعوبهم.
وخلدون النبواني مفكر سوري من مواليد 1975، تخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة جماعة دمشق، وواصل في نفس الجامعة تحصيل دبلوم دراسات عليا قسم فلسفة، ثم نال كلا من الماجيستير والدكتوراه فلسفة معاصرة في جامعة السوربون بباريس 1، حيث يشتغل الآن أستاذا وباحثا، وهو رئيس مركز أبحاث دراسات الجمهورية الديمقراطية- باريس، لهُ العديد من المؤلفات والترجمات نذكرُ منها ترجمته لـ”بورادوري، جيوفانا، الفلسفة في زمن الإرهاب ـ حوارات مع يورغين هابرماس وجاك دريدا” و “جوستين غاردر، سر الصبر”. “العرب” كان لها هذا الحوار مع خلدون النبواني.
عن أدوار المثقفين العرب في حلم التغيير، وهم بين مثقف سلطة بائدة تحول إلى مثقف سلطة سائدة، بعد أن شهدت بلاده تحولاً نسبياً في نظامها السياسي، وبين مثقف مهمش فاقد للقدرة على الحركة والتأثير في الجماهير، يشير المفكر خلدون النبواني، آسفا، إلى أن المثقف في مجتمعاتنا مُهمّش، وليس له من تأثير حقيقي على الجماهير.
حيث يعتبر أنه يمكن لفنان تلفزيونيّ أبله ومعدوم الثقافة عندنا، أن يؤثر على شريحة واسعة جدّاً من جمهورنا، الذي لا يمتلك وعيا نقديّا، ولكنه يحفظ عن ظهر قلب المسلسلات والأغاني، دون أن يكون قد سمع باسم واحد فقط لمثقف أو مُفكر أو فيلسوف أو محلل سياسيّ.
ويضيف النبواني قائلا: “هذا جزء من عملية التجهيل المُتّبعة بعناية في السياسات الدكتاتورية للسيطرة على الناس، وإلهائهم وتعبئتهم وتجييشهم، وهذا ما حاول النظام السوري استثماره بقوة منذ بدء الأحداث. فقد التقى الأسد بالفنانين في عدّة مرّات، وحرص على وضعهم أمام الكاميرات وتحت الأضواء صباح مساء، ليجعلهم قدوة للشعب/الجمهور، واهتم بالتركيز مثلاً على أسماء فنية ذات شعبية جماهيرية طاغية، بغض النظر عن درجة ثقافة هؤلاء أو مدى سطحيتهم وفراغهم. طبعاً لم يكن الأسد بحاجة للاجتماع بالمثقفين فهم كما ذكرت لا وزن حقيقيا لهم في المجتمع ولا تأثير يُذكر”.
يؤكد المفكر أنه إن كنا واقعيين قليلاً، ونظرنا في تاريخ الثورات والانعطافات السياسية الحادّة في أي مكان وزمان، سنجد أن الانقسام الثقافي كان يحصل دائماً، وعند أكبر المثقفين والفلاسفة والمفكرين، وهذا أمر قد يكون إيجابياً على نحوٍ ما، فثقافة الاختلاف دليل غنى وتنوع على خلاف ثقافة الإجماع واللون الواحد الدكتاتوري.
ويتابع قوله: “في ألمانيا، مثلاً، عندما وقف أهم مثقفي مدرسة فرانكفورت هوركهايمر وأدورنو وماركوز ضد النازية، كان هناك من يقف معها ويؤدلج لها، مثل الفيلسوف هايدجر أو المفكر القانوني الشهير كارل شميت.
بعد أحداث 11 سبتمبر حيث كان ثلة من أبرز المثقفين الأميركيين يرفضون سياسة جورج بوش الابن وقراراته العسكريّة التأديبية لأفغانستان، ثم العراق مثل ناعوم تشومسكي وإدوارد سعيد، في المقابل كانت هناك مجموعة أخرى من اليسار الحُر قد بررت مثل تلك القرارات البوشية القراقوشيّة، مثل الفيلسوف الشهير ريتشارد رورتي. الأمثلة لا حصر لها، ولكن التاريخ لا يرحم أحداً بعد ذلك.
ويعتقد النبواني أن “المُثقفين” الذين برروا وأدلجوا للنظام، أو أولئك الذين برّروا القتل والعسكرة من طرف المعارضة سيكونون بمنأى عن هذه “المحاكمة التاريخية اللامنتهية”، كما يصفها ميلان كونديرا في رواية “الخلود”.
دور المثقف
عن الدور الطليعي للمثقف في هذه اللحظة التاريخية التي تعيشها المجتمعات العربية، وهو في حالة حصار وشلل وضعف وتشرذم، وفي أفضل أحوالهِ نراه متأثراً بالسياسي ودائراً في فلك المعارضة السياسية، يعتبر خلدون النبواني أن دور الثقافة لا يمكن، ولا يجب أن يكون مواكباً لما هو سياسي وطارئ ويومي ومتغير وعابر. الثقافة عملية تأسيس وتراكم على الهامش، يخترق دور المركز المُسيطر، ويغير فيه، ويقلب موازين قواه ويقوم بالفضح والكشف. كما أن الثقافة تسبق الحدث السياسيّ بالتأسيس له، فإنها تلحق به أيضاً لتُفسّره، فهي كما وصفها هيغل مثل بومة مينيرفا (رمز الحكمة عند الإغريق) لا تفرد جناحيها إلا بعد أن يكون الليل قد أرخى سدوله.
يقول المفكر: “طبعاً لا يجب على المثقف هنا أن يقف مكتوف اليدين، بل عليه أن يُفكر في آليات المستقبل وكيفية إدارته، والتأسيس نظرياً منذ الآن لسياسة قادمة، قد لا تُنجز إلا بعد عقود وربما قرون.
ما إن أُجبِرت الثورة على التسلّح نتيجة تعنت النظام وهمجيته غير المسبوقة في قمعها، حتى تراجع صوت العقل، ولم يعد هناك صدى لأيّ دور ثقافي أمام هدير الطائرات وأصوات المدافع والرصاص. تكشّف المُثقف العربي أيضاً عن خرق عمليّ حقيقي فبعض المُثقفين تولوا ومنذ البداية مناصب سياسيّة قيادية، ولكنهم لم ينجحوا، بل برزت، وهذه ميزة سوريةً في الثقافة عندنا، نزعات فرديّة نرجسية، تُشبه إلى حد كبير ثقافة الدكتاتور الإله”.
ويشير المفكر أيضا إلى ما يحصل في تونس، حيث يعتبر أنه يتربع على سُدّة رئاستها مثقف معارضٌ سابق، وهو برأيه في المكان الخطأ. فليس على المثقف أن يتماهى بالسياسيّ، وإنما أن يُقدم قراءة نقدية للسياسيّ، ويعمل على طرح الحلول والأدوات، وكشف المخاطر والتنبيه لها.
فرصة جديدة
وعن رأيه بمثقفين وفنانين، كانوا، حتى الأمس القريب، يعيشون حول مائدة السلطة، وكانوا على علاقة جيدة معها، وفجأةً نراهم وقد أصبحوا اليوم رموزاً لـ”ثورات شعبية”، واضطلعوا بأدوار “قيادية”، وعن كيفية نيل هؤلاء لثقة شعوبهم، يقول المفكر: “إن الأمر مُركّب.
ففي رأيي، أيّ مُثقف اقترب بفترة ما من السُّلطة، وأكل على موائدها، وكان من أزلامها، هو مثقف مصلحي براغماتي، وما أكثرهم! نعم غيّر البعض مواقفهم وقلبوا مائدة السُّلطة، التي كانوا يقتاتون عليها وعلى فتاتها منذ فترة، على “أصحابها”.
كما حصل وأن قرأ بعضهم مؤشر ميزان القوى قراءة خاطئة (غلطة معلم) وهو كأي شخص مصلحيّ، فقد مال حيث ظن أن كفة القوّة ترجح. والبعض الآخر شعر بالظلم فعلاً، فغيّر من مواقفه، وانقلب عندما تكشّف له مدى عهر وهمجية السُّلطة ولا إنسانيتها”.
يؤكد خلدون النبواني أنه شخصياً مع قبول توبة المُثقف، وتوبة أيّ شخص ومنحه فرصة جديدة، وليس علينا تعليق مشنقة لمواقف ماضية، مع ضرورة محاسبته عليها أدبياً، بإحالة موقفه لمحاكمة التاريخ.
ويدعونا أن نتصور مثلاً أنه لم تُقبل توبة عمر بن الخطاب، الذي كان ضد الإسلام في أول فترة، ثم أصبح أحد أهم أعمدته! أو ألا نغفر لخالد بن الوليد حروبه ضد المسلمين قبل إعلان إسلامه!
الحياة، في اعتقاده، ليست مقصلة إلا في الدكتاتوريات، ولا يجب أن تكون كذلك، ويجب قبول توبة التائب بعد محاسبته وفق قوانين تكفل حقه في التعبير والاختلاف، وإلا فإن محكمة الحياة ستتكفل بكشف مواقف الجميع، وكشف التائب حقّاً عن الحرباء السياسيّة، التي تغير لونها لتناسب المحيط وتغيرات الوسط.
هواجس عميقة
عن الهواجس العميقة للمثقف اليوم، العربي بصورة عامة، والسوري على وجه الخصوص يقول خلدون النبواني: “أظن أن الهاجس الأساسيّ لأي مثقف عربي هو تحرير قلمه من مقصات الرقابة السياسيّة والاجتماعية والدينية، وتحرير لاوعيه من مخابرات الحاكم التي تسكنه.
الثقافة في الدكتاتوريات، كدكتاتورية الأسد مثلاً، مخنوقة ومقتولة، ولا هوامش حقيقة لها، لذا انخرط جُلُّ المثقفين في ثورة الحرية والكرامة، وأظن أن المثقفين التواقين للحرية على اختلافاتهم يريدون الحرية والعدالة الاجتماعية، وفتح الفضاءات التي ظلت مُغلقة لأكثر من نصف قرن”.
وفيما يتعلق بهيمنة السياسة على الثقافة يعتبر المفكر أن هذا موضوع آخر طويل ومُعقّد، ولكنه يراه على أنه نتيجة من نتائج الدكتاتورية حتى ولو كان ضدها. ولتوضيح رأيه يقول: “إن نقد السياسة وتناولها ثقافياّ هو أحد تقاليد الثقافة منذ أن نشأ الشعر والفن والمسرح، ومن بعد ذلك الفلسفة وصولاً إلى استقلال العلوم السياسيّة، لكن أن تبتلع السياسة الإنتاج الثقافيّ وتهيمن عليه وتلونه بلونها، فإن ذلك يُشير إلى مدى ضيق الأفق والخيارات الثقافية في مجتمعاتنا وتخلفنا التاريخيّ والثقافيّ فعلاً”.
ويتابع قائلا: “عندما تزدهر الثقافة، تتحرر من سيطرة هاجس السياسة بوصفه الحقل الوحيد لعملها، فتتطلع إلى الاشتغال على قضايا أخرى. صورة المثقف عندنا هي صورة المثقف السياسيّ الجّاد الوقور، الذي يبحث في القضايا “الكبيرة”.
من لا يشتغل بالسياسة وبالإنتاج السياسيّ، فقط عندنا، لا يؤخذ على محمل الجد من قبل الآخرين، ويعتبرونه عبثيّا أو “خفيف”. هكذا عندنا مثقفون متمرسون بالسياسة فقط، حتى نظن أنهم ضباط ثقافة من رتبة مُجنّد غُر إلى رتبة لواء صواريخ ثقافيّة. الأمر يستحق فعلاً دراسة متأنية لا مجال لها هُنا”.
لم الشمل
عن شتات المثقفين السوريين بعيدا عن إطار جامع، وتمزقهم بين الداخل والخارج يقول خلدون النبواني: “لا يجب النظر، برأيي، إلى الثقافة هنا على طريقة الوحدة العربيّة البعثيّة. الثقافة بأساسها تنوع وتباين واختلاف، وهي ذات ألوان متعدّدة ولا يجب أن تكون بلون واحد.
نعرف تماماً مدى تراجع الثقافة والأدب مثلاً في فترة الاتحاد السوفييتي، الذي فرض على الثقافة لوناً واحداً. ليس علينا بذلك توحيد المُثقفين لا أيديولوجياً ولا فكرياً ولا مدرسياً.
فالتنوع هو دليل حيوية أية ثقافة من هنا جاء نقدي القاسي لهيمنة السياسة على الثقافة عندنا، وحشرها في خندق واحد هو ثقافة السياسة أو سياسة الثقافة وتسييسها”.
يضيف قوله: “ما يجب فعله في هذا الإطار هو تحرير ملكات مثقفينا، التي ظلت مقموعة ومسحوقة تحت ثقل البوط العسكريّ الأسدي. فدولة البعث تُشبه إسبارطة العسكرية، التي تكنّ كل العداء لأثينا الثقافة والفن والمسرح والدولة المدنية.
إعطاء الحرية للمثقف والتأكيد على حقه في الاختلاف، هو من سيجعل الثقافة السورية، على اختلافها، ثقافة نهوض وإبداع وغنى وتنوير ورقي وفن الخ”..
وهكذا يصنع المفكر خلدون النبواني هويته كل يوم، هويته المتجددة المفتوحة على المستقبل واحتمالاته، كيف لا، وهو الذي لا يؤمن بالهوية كجوهر مطلق، فبالنسبة إليه أن الأنا التي حازت هويتها النهائية هي أنا ميتة، بينما الأنا المتجاوزة لنفسها نجاحاً وإخفاقاً هي أنا حيّة تنتصر وتنكسر وتتغير وتصير.
وهو القائل: “أن يخسر المرء قضاياه العادلة بنظري أفضل من أن يخسر نفسه”. بهذا المعنى الجزئي يمكن لي القول إذن: “أنا محامي القضايا العادلة الخاسرة”.