اللغة والكتابة
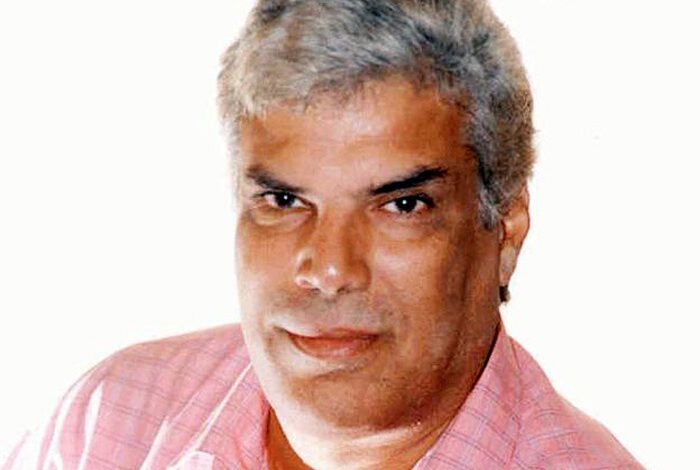
- سرير بروكرست - 2025-05-25
- وزير الثقافة المصري والاحتفاء بالقوة الناعمة - 2024-09-12
- اقتربنا من العام.. هل حققت الصهيونية أهدافها في غزة؟ - 2024-09-05
اللغة هي أداة الكاتب وريشته، لكن من أين تأتي ألوانه؟ سؤال قد تكون الإجابة عليه مفيدة. قديما قالوا إن اللغة تحمل المعنى، أو أن اللغة بيت المعنى. لا أعرف من الذي قالها أو لا أتذكره، وكانت من أكثر ما يقابلني وأنا أقرأ في سن مبكرة، لكن الصدفة جعلتني من المغرمين بمشاهدة الأفلام السينمائية قبل أن يظهر التلفزيون في بلادنا، وكان ذهابي إلى السينما أكثر من ذهابي إلى المدرسة.
في السينما رأيت صورة حولها الحوار والموسيقى، رأيت صورة في المشاهد البعيدة، وكيف تقترب حتى تصبح اللقطة قريبة جدا، تكاد تجثم على روحي بالمعنى الذي أراده المخرج، أو كاتب السيناريو من قبل، وأبدع المخرج في تجسيده. لا أنسى مثلا مشهد الفنان عبد العليم خطاب في فيلم «دعاء الكروان» والمخرج هنري بركات يجعله يظهر من بعيد مثل نقطة ظلام في الصحراء، ثم يزداد ظهوره وهو يقترب حتى يصبح قريبا جدا، ونرى الشر مع تقدمه إلى الأمام يقترب منا أيضا، ويملأ الشاشة معه. بالفعل يقتل هنادي (زهرة العلا) ثم يبحث عن آمنة (فاتن حمامة) ليقتلها. ليس مهما أن رصاصته جاءت في أحمد مظهر كأنما هي عقاب لما فعله. المشهد يلخص لك ما سيأتي ويُلقي به في روحك. ربما لا تدرك ذلك أول مرة، لكنك في كل مشهد بعد ذلك تتوقع اقتراب الشر من هدفه، وكيف يملأ الشاشة كالنذير.
مشاهد كثيرة من الأفلام العربية والأجنبية يمكن أن أقدمها، لكن المهم أني أدركت أن الصورة يمكن اللعب فيها وبها، ففكرت أنه يمكن اللعب في اللغة أيضا لتحمل صورة. يمكن جدا أن تقدم المفعول على الفاعل لتبرز أهميته، ولا تكتفي بأنه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ويمكن جدا أن تؤخر الفعل ولا تكون الجملة حكائية، فعل وفاعل ومفعول.. وجدت أن ذلك حدث في الشعر العربي منذ قديم الزمن، فأكثره لم يكن مجرد عبارات تحمل المعنى فقط، لكن كان يحمل الصورة مع المعنى ويزيد إبرازه. فحين يقول امرؤ القيس «مكرٍ مفرٍ مقبلٍ مدبرٍ معا.. كجلمودِ صخرٍ حطّه السيلُ من علِ» وهو يصف فرسه في القتال، لا تقف عند المعنى المباشر، من قدرة الفرس على الإقبال والإدبار في الحرب، لكن أيضا ترى صورة الحجر وهو ساقط من فوق الجبل، يصطدم بما يظهر منه من نتوءات، فلا تعرف أين سيصل، ولا ماذا سيصيب. إذن يمكن للغة أن لا تحكي ولا تحمل المعنى فقط، لكن تجمّل الصورة وتقربها، هكذا يصبح القلم ريشة في يد الفنان، وأدواته في الرسم هي ما يفعله في اللغة.
الأمر نفسه حين تقارن اللغة بالسينما، فطرق الكاتب في التصوير هو ما تفعله الكاميرا، وهو يقدِّم الأفعال والكلمات ويؤخرها. هذه الطرق للكتابة تجعل الكاتب الأريب بقدر ما يستطيع، أو تمكنه الموهبة، يفكر هل يمكن مثلا، أن تكون جمل وعبارات الشخص الجالس وحيدا على الشاطئ ليلا يتذكر فقدان الحبيب، جملاً قصيرة، أم ممتدة مع الألم والفراغ والظلام، الذي يبدو لا ينتهي.. ويمكن وهو يرى سفنا بعيدة مضيئة وسط الليل، أن تصل عباراته إليها فتطول أكثر؟ وهل إذا ركب شخص قطارا مسرعا وأخذه التفكير، ستكون جمله طويلة، أم قصيرة.. أيهما سيتوافق مع سرعة القطار، التي تهزه بين لحظة وأخرى؟ وهل إذا تحدث شخص وهو يصعد أو ينزل السلم، ستكون جمله قصيرة أم طويلة، أيهما سيتوافق مع قوة أنفاسه وسرعته؟ هكذا تتشكل اللغة خارجة من إطار الحكي، الذي يحمل المعنى، ليكون تكوين الجمل والعبارات إضافة كبيرة للمعنى نفسه. الأمر ينتقل بسلاسة إلى الفصحى والعامية.
كثيرًا ما أجد أمامي على الميديا أسئلة من نوع، أي لغة أجمل في كتابة الرواية أو القصة.. هل هي العامية أم الفصحى؟ ورغم أن السؤال قتل بحثا في تاريخ الأدب الحديث في مصر فهو أحيانا يقفز. في بداية القرن العشرين اعتبر بعض الكتاب أن فكرة الكتابة بالعامية، هي فكرة استعمارية يُقصد بها فقد اللغة العربية، وزاد البعض فجعلها مضادة للغة القرآن. شغل السؤال كثيرا من الكتّاب، حتى قال توفيق الحكيم إنه يعتد بلغة ثالثة بين الفصحى والعامية. بينما طه حسين أكبر نصير للغة العربية كتب مقدمة أول مجموعة قصصية ليوسف إدريس، وهي مجموعة «أرخص ليالي» وتركها بعاميتها، فالأصل في اللغة العربية الفصيحة «أرخص ليالٍ» الذي فعل ذلك هو طه حسين كما قلت، ولا يدهشك الأمر فهو القائل «لغتنا العربية يسرٌ لا عسر، ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها، ولنا أن نضيف إليها ما نحتاج إليه في العصر الحديث». وهو نفسه تجد تكرارا أحيانا في الأفعال عنده، أو تأكيدا لما يقول بأكثر من جملة، ووصل البعض إلى أنه فعل ذلك، لأنه كان يُملّي ما يكتبه، ومن ثم يجعله واضحا لمن يُملي عليه، وبالتالي القارئ، وهو تفسير مقبول.
لا أنسى قصيدة «أراك عصي الدمع» لأبي فراس الحمداني، التي غنتها أم كلثوم وكيف غيرت بيت الشعر التالي لـ»أراك عصيَّ الدمع شيمتك الغدرُ.. أما للهوى نهيٌ عليكَ ولا أمرُ» وهو البيت القائل «بلى أنا مشتاق وعندي لوعة.. لكن مثلي لا يُذاع له سر» جعلته نعم أنا مشتاق إلخ.. نحويا فالإجابة بنعم على سؤال يبدأ بالنفي تعني تأكيد النفي، وليس كما أرادت، لكن كما قرأنا أنه لم يعجبها أن تقول «بلى». لكن مع اللحن والأداء تنسى أن السؤال بدأ بالنفي. لقد فكرت من زمان في حل بين الفصحى والعامية، ووصلت من رؤيتي للسينما، ومن قراءة المسرح، حيث الحركة أيضا، ومن مشاهداتي لمعارض الفن التشكيلي، إلى أن الأصل في ذلك هو الصدق الفني. فإذا أسعفتك الفصحى فأهلا وسهلا، وإذا أسعفتك العامية فأهلا وسهلا. المهم أن تخرج من الحكي الساذج، إذا جعلت ذلك في السرد، وأن يكون الحوار مناسبا للشخصية، فلن تجد راقصة تقول لمساعدها عِمْ صباحا. على العكس إذا كانت مبتذلة ستقول صباح الخير يابن… وإذا كانت عادية ستقول صباح الخير ولا تزيد. الأمر يختلف إذا كان المتحدث شخصية على درجة من العلم والثقافة. الراقصة لن تقول هيتَ لك، إلا على سبيل السخرية والضحك، بينما شخص مثقف يمكن أن يقولها. لا أنسى يوما في الثمانينيات، كنت أجلس فيه في جريدة «الأهرام» مع مصحح لغوي، يراجع قصة لكاتب كبير، كانت فيها أسئلة كثيرة في الحوار تبدأ بالنفي، وكان الإجابة دائما بالايجاب بكلمة «بلى». ورأيته يضحك ويقول لي كم «بلى» في هذه القصة. من يومها إذا كان السؤال في الحوار بالنفي، لا أستخدم، لا بلى ولا نعم. أستخدم جملة. فإذا كان السؤال مثل ألن تفعل ذلك، أقول سوف أفعله، بدلا من «بلى». أو لن أفعله بدلا من نعم. وهكذا تخلصا من ربكة القارئ، وبلغة سهلة أيضا لن تضر اللغة العربية ولا القصة، فالمسألة كلها زيادة كلمة وفي مكانها. كل هذا الحديث لأكرر قول طه حسين لغتنا العربية يسر لا عسر.
المصدر: صحيفة “القدس العربي”




