احتضارُ معتقدات وتَوَلُّدُ معتقدات
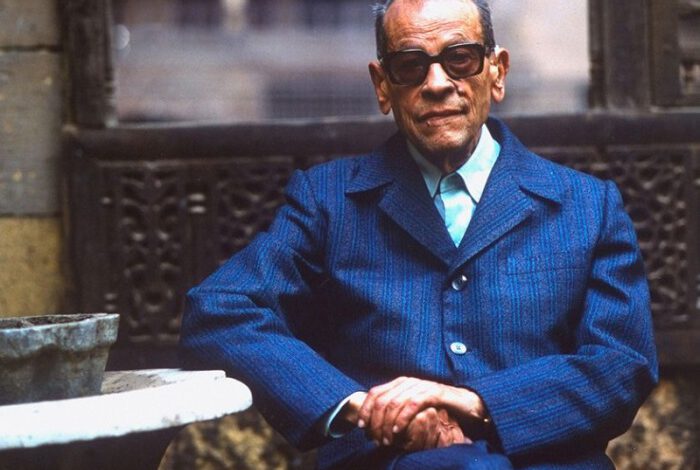
- أنطون تشيكوف.. الأديب الروسي - 2021-08-01
- احتضارُ معتقدات وتَوَلُّدُ معتقدات - 2021-06-11
- ثلاثة من أدبائنا - 2021-04-19
قامت المدنيات القديمة على معتقدات قوية -كما يقول “جوستاف لوبون”- سواءً كانت هذه المعتقدات دينية أو سياسية؛ وبقيت هذه المدنيات قوية الدعائم متينة البنيان، لأن المعتقدات التي تأسست عليها كانت متأصلة في النفوس، وفي مأمن من البحث والنقد اللذين يولدان الشك والريبة، وهذه المعتقدات قد تضمنت أخطاء وخرافات لا يقبلها العقل بحال من الأحوال، وإن اطمأنت إليها المشاعر في أغلب الأحوال، وإذا خالج الشك النفوس في معتقدٍ ما، وكان هذا المعتقد أساسًا لمدنيته، فقد آن الأوان لانهيارهما معًا، ونحن نشاهد -في عصرنا هذا- أن جميع العقائد القديمة التي اطمأنت لها النفوس أجيالًا طويلة أخذت تتزعزع رويدًا رويدًا، وتتزحزح عن مكانتها الأولى شيئًا فشيئًا.
والإنسان بطبعه، وبحكم العاطفة الدينية التي تملأ جوانب نفسه، يتشوف دائمًا لمعتقد يُسلم إليه نفسه وإيمانه، ولهذا نجده يعتنق المذاهب الاجتماعية والآراء السياسية، ويبذل في سبيلها من نفسه ما كان يبذل سلفه القديم في سبيل الله أو قيصر، غير أن رأيًا من هذه الآراء، أو مذهبًا من هذه المذاهب، لم يستقر بعد في النفوس كما استقرت الآراء والمذاهب القديمة، ولم ينطبع بذلك الطابع الديني المقدس الذي يجعل بحث المذهب أو نقده كفرا وخيانة، فعصرنا فترةٌ بين اعتقاداتٍ ومعتنقاتٍ تحتضر وتفني، وبين آراء ومذاهب أخرى لم تستقر استقرارا تامًا وتأخذ مكانتها من النفوس، فهو عصر اضطراب وتردد لا مثيل لهما في التاريخ، واضطراب في الآراء التي تتصارع للحياة والاستقرار والفوز، وتردد بين مذاهب يُناقض بعضها البعض الآخر، ويحاول القوي منها محو الضعيف المتداعي وهكذا فنحن نشاهد أنه لا يظهر كتابٌ يدعو لعقيدة من العقائد حتى يظهر آخر يُسخف هذه العقيدة ويُنحي عليها أشد الإنحاء. ثم لا يلبث أن يؤلَّف ثالثٌ يتوسط الرأيين المتناقضين برأيٍ ثالث وهكذا.
الإنسان بطبعه، وبحكم العاطفة الدينية التي تملأ جوانب نفسه، يتشوف دائمًا لمعتقد يُسلم إليه نفسه وإيمانه
وليس ثمة شك في أن استقرار الحياة وثبات المدنيات وسير الأمور في مجراها الطبيعي، خير من ذلك الاضطراب المروَع، ولكننا مع ذلك لا نبتئس بقرب زوال المعتقدات البالية، ولا ندعو المفكرين إلى الكف عن بحثها ونقدها؛ لتحتفظ بما لها من القدسية والمهابة، ولتضمن لنا حياة هادئة وديعة، وذلك لأننا نعتقد بأن هذا الأضطراب نتيجةٌ لا حيد عنها تُحدثها الطبيعة لتقدم العمران، كما نعتقد أنه مظهر للتقدم العقلي، ومقياس صادق للتطور الذي يطرأ بين حين وآخر، فالعقل يهدم المعتنقات القديمة لأنه أصبح لا يسيغها، أو لأنه ارتقى لدرجة أصبح نقده لهذه المعتنقات فيها ضرورة لازمة لا دخل فيها للاختيار والتدبر، ومثله في ذلك مثل الشيب الذي يعلو الرأس إذا ما كبر الإنسان، وعليه، فمناهضة الحركات التجديدية، إنما هي مناهضة لإحدى سنن الطبيعة التي لا تُناهَض ولا تُغْلَب.
ونحن أيضًا لا نتشاءم من تزعزع الإيمان بالمعتقدات القديمة، ولا نميل إلى التسليم بأن عاقبة ذلك خراب العالم، كما يدّعي كثير من المتشائمين، وكل ما في الأمر إن هو إلا ترميم في الأساس، أو هو بنيانُ أساسٍ جديدٍ متينٍ لا نتسرع في تشييده، بل نترك ذلك للتطور والزمان؛ وهما كفيلان بأن يُحققا لنا ما نحلم به من غير أن نلجأ إلى الثورات التي تفوز بالمرغوب، وتقهر الزمان في الظاهر، بينما هي في الحقيقة والواقع ليست إلا تخريبا واضطرابا لا يُسفران إلا عن تقهقر ورجوع إلى نقطة الابتداء وهي العجالة في وصف ما طرأ من الاضطراب على معتقداتنا تُفسر لنا بعض التفسير ذلك التطور الهائل الذي نلحظه في الآداب.
ففي الزمن الماضي، يومَ كانت الاعتقادات القديمة سائدةً مستحوذةً على المشاعر والنفوس، يتأثر بها الخاصة كما يتأثر بها العامة، كان الأدباء يعبّرون أصدق تعبير عما يتأثرون به من المعتقدات، ويكفيك لتقتنع بذلك أن تُجيل نظرة في تلك المجلدات الضخمة التي كُتبت عقب ظهور الإسلام لتشرح نصوصه الدينية، أو لتجمع أحاديث النبي وتفسرها، بل يكفيك أن تقرأ دواوين بعض الشعراء ممن لم يكن لهم هَمٌّ إلا نظم الحِكَم الدينية أو مدح النبي أو التغزل الإلهي.
والأمر لا يختلف في الدين عنه في الاجتماع والسياسة، فكثيرًا ما أُلِّفت الكتب والقصص لتأييد مذهب أو نصر مبدأ أو بث دعوة، فلما أخذت الاعتقادات القديمة في الفناء، وأخذ العقل يُسلط نوره عليها فيُظهر من عيوبها، ويكشف عن سوءاتها التي عاشت ورسخت في النفوس أجيالًا كحقائق لا مراء فيها ولا جدال، ولما حل الشك محل الإيمان، تأثر الأدباء بذلك التطور، الذين هم من أكبر دعاته ومؤيديه، بما يؤلفون من كتب تحمل القديم، تحاول أن تأتي عليه، وتخلصنا من استعباده ورقه، وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت بين أيدينا مجموعة وافية من الكتب والقصص تبعث قراءتها على الشك في الماضي، بآرائه ومعتقداته، أو تدعو لمذهب جديد كالاشتراكية والعالمية وغيرهما.
والذي يجدر بنا أن نُلاحظه هو أن جميع الأديان الجديدة ترمي إلى اتحاد العالم وإزالة الفروق الوطنية، وهي تتفق في ذلك مع الأديان القديمة مثل المسيحية والإسلام، ولكنها تزيد على ذلك فيدعو بعضها إلى إزالة فوارق الطبقات المادية، ولو أننا أردنا أن نتنبأ بالمذهب الذي سوف يكون له الفوز بين المذاهب لقلنا بأنه مذهب الاشتراكية، وذلك لأنها تستهوي بوعودها أفئدة الساخطين المتذمرين والفقراء، وهم السواد الأعظم من سكان العالم، ولأنها تسد النقص الملموس الناتج عن التقدم العلمي وظهور المخترعات والآلات، ولأنها وَسَطٌ بين نظامين يتأفف منها المتدينون، وهما الشيوعية والفردية، وقد أخذت منهما حسناتهما، ونفضت عنها نقائصهما الظاهرة.
وهنالك أسباب كثيرة أخرى تجعلنا نكان نوقن بأن المستقبل للاشتراكية، ولكن بحثها الأن لا يعنينا، ثم لا يفوتنا أن نذكر أن سعادة الأشتراكية الموعودة دنيويةُ، تُنال في هذه الحياة لا في حياة أخرى، وأنها لذلك قد تعجز لسبب من الأسباب عن إنجاز وعودها تامة كاملة، وعليه فينفضّ من حولها أعظم مؤيديها حماسةً ونشاطًا. ولكنّا لا ننسى كذلك أن الكمال في الدنيا ضربٌ من المستحيلات، وأنه وإن كانت الأشتراكية لن توصَلنا لحالة من النعيم لا مطلب خلفها، إلا أنها تستطيع أن تنتشلنا من حالتنا هذه إلى خيرٍ منها، وليست الاشتراكية نهايةَ ما يُمكن أن يتطور إليه النظام الاجتماعي، وعليه فالتطلع للأحسن سيدفعنا دائمًا للتنقيب عما فيه سعادتنا ورفاهيتنا.
وجملة ما أريد أن أقوله عن هذا الأمر، أنه لو خاب أملنا في الاشتراكية بعض الخيبة، فليس معنى ذلك أننا نرغب في الرجوع إلى حالتنا الأولى السيئة، إنما يجعلنا ذلك نزيد إيمانا بالتطور، الذي هو الخالق الوحيد للاشتراكية وغيرها من الآراء والعقائد.
المصدر: “المجلة الجديدة”، أكتوبر 1930.



