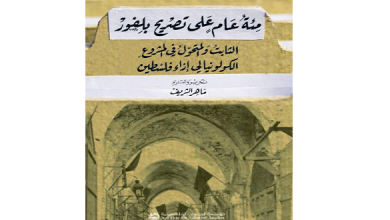عبد الله صديق .. حين فكّر في فلسطين قفزت كلماته لترشق قلوبنا حبّاً!

بديعة زيدان
“لقد عشتُ ما عاشه عبد الله في هذا النص، على الأرض، أكثر من مرّة، إلا أن جماليات الكتاب، ورهافة التقاط التفاصيل، والعيش فيها، جعلني أزور فلسطين مرة أخرى، مرة أرى فيها ما لم أره من قبل، عبر عيون كاتب يستطيع أن يزيد حبك لفلسطين، مهما كانت درجة حبك لها قبل قراءته”، هذا شيء مما قاله الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله عن كتاب “أن تفكر في فلسطين” للشاعر والكاتب المغربي عبد الله صديق، والصادر حديثاً عن منشورات المتوسط في إيطاليا بالتعاون مع دار السويدي للنشر والتوزيع في أبو ظبي.
هو ذلك فعلاً، فأنا الفلسطينية على أرض فلسطين، شعرت بحب يفيض بين سطور الكتاب، ويكاد يندلق من صفحاته هناك على مقربة من ضريح محمود درويش، أو سور القدس الشاهق، أو مقهى “الانشراح”، أو حيث “الكنافة” في نابلس، وبيت الكرمي، وموطئ القدم على أرض فلسطين.
الكتاب رحلة في الرحلة، وأكثر من مجرد يوميات، ففيه من السرد روحه ولغته وتسلسله، وفيه من الشعر مجازاته وصوره واستعاداته، وفيه من المشهدية البصرية ما يقحمك في شاشة الكلمات، علاوة على موسيقى تفيض مشاعر متناقضة ما بين مشهد ومشهد، وجغرافيا وأخرى، حتى يجعل القارئ الفلسطيني أيضاً، وهو ما حدث معي على الأقل، يقلبّ الصفحة تلو الأخرى، بانتظار لا ينقصه اللهفة لتتبع مصائر اللاشخصيات، لمعرفة فلسطين التي نعيشها، ولا نراها كما عبد الله، لأننا جزء من المشهد أو تركيبة يومياته.
في قرابة المائة صفحة، يوزع صديق كتابه على سبعة أيام متسلسلة منذ وصوله إلى مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمّان، وحتى اللحظات الأخيرة له على أرض فلسطين، التي زارها ضيفاً على معرض كتابها الدولي في العام 2016، ويصف أحاسيسه ومشاهداته مطعمة بمرجعيات فلسفية وفكرية وإبداعية بدقة وسلاسة، كما في المشهد التاسع من اليوم الأول على سبيل المثال، والذي جاء بعنوان “يكذبون ويكذبون”، وكان في الجانب الإسرائيلي من المعبر، حين كتب: منتصف الصالة بين حشود العابرين، واقفاً في آخر الطابور، التفتّ ورائي، فرأيت على الجدران بوسترات دعائية ضخمة، عليها ختم وزارة السياحة في “دولة إسرائيل”، أحدها لمسجد الصخرة، وآخر لكنيسة القيامة، وثالث لبيت العدل.
في اللحظة نفسها، وفي مجال التفاتتي نفسه، كانت هناك مجموعة من الأفارقة، بدا لي من هيأتهم أنهم حجّاج مسيحيون، وسائح ياباني مع رفيقته، يتطلعون جميعاً إلى البوسترات. بهاتين القطعتين اكتمل المشهد، الكذبة الملصقة على الجدار، والمكذوب عليهم القادمون من بعيد.
وفي المشهد الرابع عشر من اليوم الأول نفسه، وتحت عنوان “ما فعله المعبر، وأكملته المستوطنة”، كتب صديق: مستوطنة؟! هنا؟! في قلب منطقة يفترض أنها تحت سيطرة سلطة الإدارة الفلسطينية .. عادت الغصّة في حلوقنا، وفسدت من جديد بهجة اللقاء الأول مع الأرض. رحتُ أفتشّ في داخلي عن تلك الشماتة اللذيذة التي أوحتْ لي بها لافتة ربّ الجنود، فلم أجد لها أثراً، وعن تلك الخفّة الطافية على وجه الروح بعد استراحة أريحا، فوجدتها قد تبخّرت، وعن ذلك التجلي الرمزي لانتصار العبور، وقد صار دكّاً، فالملاعين صاروا هنا من جديد، وما فعله بنا المعبر أكملته المستوطنة”.
وفي رام الله، واستمراراً لحالة الدهشة التي تملكته، وتحت عنوان “خرسانة زهور”، في المشهد الحادي والعشرين من اليوم الثاني له، تجاذب وسائق سيارة عمومية فلسطيني أطراف الحديث، فحدثه الأخير بشيء من الأسى عن التحولات التي شهدتها المدينة البلدة التي “كانت تصطبغ بخصائص الريف سلوكات مدينية، لا تلقي البال كثيراً للرقابة الاجتماعية”، قبل أن يعرج ببهجة إلى وصف الأماكن في البلدة القديمة للمدينة التي يقول الكاتب عن مسائها .. “الليل، الليل الذي يصير في هذا المكان مبصراً .. فيُرى فيه غرب الأرض المحتلة وبحرها بالوضوح الذي لا يستطيعه النهار”.
ومع كثير من وصف يوميات المعرض وحيواته وحكاياته مع الوجوه التي ألفها وألفته بدرجات متفاوتة، تستمر المشاهدات خارجه، ومنها ما كان في متحف محمود درويش .. “أكملنا الزيارة سائرين نحو بوابة المتحف، لنجده في انتظارنا على جدارية عند المدخل، باسطاً يمناه يوشك أن يصافح بها زائريه، يستضيفهم في حضرته، يريهم ما يريد مما علق من ابتسامات في ألبوم وجهه العابر للأسفار والأقاليم، يقدّم لهم في فناجين غير مرئية ما يشبه طعم البن المغلي على ما تبقى من نار في جمر المجاز، ثم يدعوهم إلى طاولة نرده، فيرمي في الهواء رمية واحدة،
وقبل أن يرتد إلى الصدفة قرارها، يعدّل هو ربطة عنقه، وينسحب خفيف الوطء نحو ركن مكتبه أين تغفو سترته المطوية على ظهر الكرسي، وحيث قلم من أقلامه الكثيرة يستلقي وحيداً فوق بياض، يمتحن التأويلات، ويمتص الفراغات التي يتركها الضوء الخفيف الهائم في المكان”.
وفي اليوم الرابع للزيارة، وتحديداً في القدس، كثيرة هي المشاهد التي خزنتها ذاكرة الكاتب، ومنها “خلعت نعليّ، وصعدت الدرج الممتد نحو مسجد قبة الصخرة، في اللحظة ذاتها، كان أذان المغرب يرتفع، ومن على مقاعد حجرية، نهضتْ نسوة تتلفعن بالبياض إلى صلاتهن، ومن فضاء غير بعيد، كانت تتعالى أصوات أطفال يتراشقون كرة بأقدامهم، نداءات وضحكات كانت براءتها تتمازج مع نفحات الممتلئ بالإيمان (…)”.
كانت أمسيته الشعرية رفقة آخرين مبرمجة في بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم .. ومن أجوائها استذكر عبد الله صديق “توقف الباص بنا عند مبنى النادي الثقافي لعنبتا، أين سيُقرأ الشعر هذا المساء، عند بوابة المبنى لم يكن هناك أكثر من شخصين أو ثلاثة، ما عنى لنا من ظاهر الأمر أننا قد وصلنا أبكر مما يجب، وما إن دخلنا القاعة حتى وجدنا المفاجأة الكبيرة في انتظارنا، فالقاعة غصّت بجمهور وصل إليها قبل الموعد، واحتل كراسيها التي فاق عددها المائة.
ومن وصل متأخراً ظل واقفاً في الخلف، التفت إلى مرافقنا مدير الثقافة في المحافظة أسأله عن عدد سكان عنبتا، فأفادني بأنهم في حدود الثمانية آلاف. زاد الخبر من وقع المفاجأة. بلدة صغيرة تهدي للشعر هذا الحضور كله، بهذا الوفاء، وهذا السخاء”.
ومع استمرار الحكايات والمشاهد العالقة في الذاكرة، يطل في الكتاب بوح بائن، وحبّ طافح، فصاحبه هو القائل “أنا، أنا القادم من المكان البعيد، الواصل هنا، الواقف الآن على خط المواجهة بين الذاكرة والمخيّلة والجارحة، أطلع اللحظة، على جرح سريّ في أدغال الجروح الشاسعة لهذا التراب”.
وهو القائل أيضاً “كثيرة جداً عاداتي السيئة، لكني لم أسمح يوماً أن تكون من بينها عادة الإسراف في هرق الماء، غير أنني هذه المرّة أطلت المكوث، غير قادر على مقاومة تلك الخفّة الطافحة التي انتابتني وأنا أتابع الحبيبات المنهمرة بالآلاف، كأن هذا الماء لم يكن كأي ماء، وهو يتدفق عليّ قادماً من ينبوع في الأجواف السرّية التي تحبل بها هذه الأرض التي ليست كأي أرض”.
وبالعودة إلى ما قاله الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله فإن قدرة الكاتب “تتمثل في أنه يجعلك تركض عبر السطور، طاوياً لها، من خلال قوة اللحظة التي يتناولها، واللحظة التالية التي بتّ متشوقاً لمعرفتها. من عمّان إلى أريحا إلى رام الله إلى الخليل، وسواها من المدن الفلسطينية، تتشكل حكاية فلسطينية أخرى، بعيون عربية مُحبّة، وقلب نابض بالجمال، يرى الجميل ويتعلق به، ويحميه، وسط غابة البنادق المتربصة به”.
بالفعل كان الكتاب رحلة مليئة بالشغف لعاشق أكد في السطور الأخيرة لكتابه “في فلسطين، تتعلم أن تكون فلسطينياً، وهو ليس حصراً ذاك المولود على أرضها أو المنتسب إليها بالانتماء الوطني، بل هو كل حامل لفكرة الإنسان .. حين تدخل إلى فلسطين (الأرض والشعب والفكرة)، تبدأ من فورك بالتعلم منها، تتعلم منها أشياء جديدة، تدفعك إلى التفكير في حياتك قبل أن تصلها، وفيها وأنت فيها، وأكثر معنى تعلمك إياه هو (التماسك)، وبدونه تصبح قابلاً للتحلل والتلاشي (…)”، وهو القائل في عتبة الكتاب “(…) يستغرقك الوقت، ويسحبك المشهد إلى داخله، والموقف إلى فكرته، فتجد نفسك تتعلم، تتعلم كيف تفكّر، وكيف تفهم بعض المعنى الذي يكون في المعنى كله، حين تفكر في فلسطين وأنتَ فيها”.
المصدر: الايام الفلسطينية