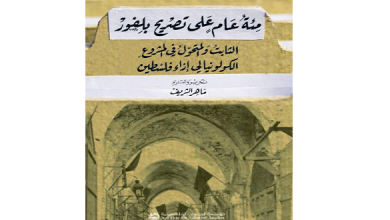وليد علاء الدين يمسرح سؤال التصنيف روائياً

أحمد مجدي همام
يخوض الكاتب المصري وليد علاء الدين (1973)، في روايته الأولى «ابن القب“طية» (الكتب خان، القاهرة) غمار تجربة سردية مختلفة، إذ يسعى إلى إقامة علاقة دين`اميـكيـــة متبادلـــة بين أشكال أدبية عـــدة، ضمَّنها في نصّه، اعتماداً ربما على ما قــاله باختين عندما وصف الرواية بأنها «الجنس الأدبي الذي يرفض الاكتمال».
تدور أحداث «ابن القبطية» حول شخصية يوسف حسين؛ الشاب الذي يعيش ضحية لفعلة لم يرتكبها، إذ تزوج أبوه المسلم من أمه المسيحية، فحمل ابنهما وصمة «ابن القبطية» داخل مجتمع متعصّب. يقع يوسف بسبب هذه المفارقة، ضحية لمواقف عدة، منها أن تُحرَّم عليه حبيبته أمل، لمجرد أن دماً مسيحياً يسري في عروقه. ثمّ يصبح الشخص نفسه، مستهدفاً من راحيل، اليهودية ذات الجذور المصرية، التي ضاقت بتاريخ الهروب اليهودي، واختارت أن تنجب للعالم طفلةً (رسولة)، من رحمها الموسوي، تختلط بدماء مسلم تحمل مسّاً مريمياً. وبالتالي تختار راحيل أن يكون يوسف المهجّن هو الرجل الذي سيخصّب أرضها ببذور السلالة الجديدة متعددة الهويّات، والتي ستحل مشكلة اليهود، بل ومشكلات العالم، وتجد الشيفرة النهائية لسؤال التصنيف الديني.
من خلفية شعرية، مسرحية، جاء وليد علاء الدين إلى عالم الرواية، ولذلك ربما يأخذ السرد في «ابن القبطية» ملمحاً مسرحياً، بحيث تكثر الحوارات تارةً والمنولوغات الداخلية طوراً، إضافة إلى التوصيف البصري، خصوصاً أنّ أغلب الأحداث تنبثق من مكان ثابت لا يتغير؛ غرفة يقيم فيها يوسف، أو جُحر للدقة، يرصد منه الحياة، وترتسم على جدرانه ظلال الماضي فتنبثق الخيالات حيَّة أمام عينيه. ومن ثم يحدث الفلاش باك أو الاسترجاع، فتتغير الأماكن والديكورات، ونطير إلى جغرافيات مختلفة احتضنت الأحداث.
هذا التداخل، والذي يتجلى أيضاً في لغة شعرية مزخرفة، وفي أسلوب التداعي الذي يعيشه يوسف، يسبغ على السرد نوعاً من المرونة في التعاقب، إذ تبدو التقنية المختارة هي الأنسب لمناقشة الطرح الذي يشغل الكاتب وينسج خلفية حياة بطله. ولا يقف التداخل عند هذا الحد، بل يمتدّ ليصل إلى حالة من البوليفونية، أو تعدد أصوات الرواة، إذ تتناوب الحكي أحياناً، شخصيات أخرى غير يوسف، والراوي الضمني، ومنهم أمل، حبيبة البطل.
تتواشج الروابط وتتعقد، تتداخل المصائر. يوسف، ضحية لتاريخه، و»أمل» ضحية أيضاً للتاريخ نفسه، وضحية لمنصور، تاجر الذهب الذي اشتراها بأمواله التي لا تنتهي، وراحيل، اليهودية الشرقية، ضحية تاريخها أيضاً، وتحاول أن تجعل من يوسف ضحية، تتسلل إليه مستعينة بجمالها الطاغي، وبحوارات فلسفية ممتدة، تناسب السمت المسرحي الطافي على سطح السرد.
يبـــدو يوسف، مثل أغلب أبطال روايات كتّاب التسعيـــنات، مـــأزوماً، مشوشــاً، حتى أن الـــرواية تبدأ بتقرير طبّي يصّف حالة يوسف وما يعانيه من ضلالات وتهويمات الفصـــام، ليضيف بذلك التقرير نمطاً كتابياً فريـــداً إلى باقة الأنماط التي يحتشد بها النــص.
وتُختتم الرواية بقصاصات من كراسة يوسف الزرقاء، وتضم بعض الأقاصيص التي كتبها بنفسه، تحفر في نفسيته، وتعكس حالته، لا في مرآة الحكاية الكُلّية، بل في شظية من شظايا الحكي، أقاصيص مفتتة وعاكسة.
أجواء ضبابية كابوسية تغلّف الحكاية، هناك الكثير من الأحلام والكوابيس والسُّكْر والتخريف. الأمر مفهوم في سياق الحديث عن مريض بالفصام، لكنّ الأمر المميز هنا، هو توظيف تلك الحالة في شكل فنّي، فالانتقال بين الواقع والتهويمات يحدث بنعومة وانسيابية، الأمر الذي يساهم في تدفّق السرد وليونته.
يختصر الروائي أكبر قدر من المعلومات في أقل عدد من الكلمات، الأسماء نفسها تحمل دلالات. فثمة يوسف بكل ميراثه عن الظلم والصبر، وهناك أمل، التي يحمل اسمها معنى صريحاً، ونجد منذر، الشيخ السلفي المتزمت. يتضافر مع ذلك، رافد معرفي نخبوي رفيع المستوى، إشارات تاريخية، ونبش متواصل في أثر جلال الدين الرومي، أو حتى التعمّق في الجانب المتعلّق بالأمراض النفسية.
وعلى رغم ذلك، لم تفلت الرواية من بعض هنّات العمل الأول. على سبيل المثل؛ كان التباين بين أصوات الرواة بسيطاً، لا يكاد يُلمح، وإن حصل، فإنّ ذلك يكون بعد مجهود، ولولا أنّ عناوين الفصول تشير إلى أسماء الرواة، لاختلط الأمر على القارئ.
بالمثل، جاء اختيار اللغة العربية الفصيحة للحــــوار بين الشخصــيات، لينتقص من واقعيتها بعـــض الشيء، ويقرّبها خطوةً إلى المسرح بديكوراتـــه وكل متعلّقاته، لأنه لم تكـــن هناك ضرورة لحضور الفصحى ونحن نتــحدث عــــن مجتمـــع مصري، ما بين الصعيد والقاهرة، ولم يكن لحضور الفصحى أي ضرورة فنية، إلا فـــي حالة «راحيل» اليهودية ذات اللكـــنة، والتي تتحدث الفصحى نظراً إلى عدم إتقانها أي لهجة عامية عربية. عدم مرونة اللغة بين الشخصيات وفي لغة الحوار، خفّض من مستوى الإقناع ومستوى الواقع أو المنطق الداخلي للنص إن صح التعبير.
كما جاء اختيار الكاتب لحذف بعض المفردات التي يراها خادشة، وإحلال نقاط بدلاً منها، ليمثّل نوعاً من الرقابة الذاتية غير القائمة على معايير فنية، وإنما على معيار أخلاقي.
إجمالاً، يمكن القول بأن التجريب في (ابن القبطية)، وتداخل الأجناس، وجرأة الكاتب في اختيار زاوية التناول، طغت على المآخذ السابقة، وبالتالي فنحن هنا أمام محاولة روائية أولى واعدة ومائزة.
(الحياة)