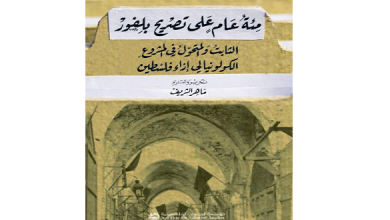روبرتو بولانيو.. حلبة الجليد

تصدر قريبا عن «منشورات الجمل» الترجمة العربية لرواية الكاتب التشيلي روبرتو بولانيو «حلبة الجليد» (نقلها إلى العربية من الاسبانية رفعت عطفة)، لتشكل الكتاب الثالث الذي ينقل لهذا الكاتب المتميز إلى لغة الضاد بعد «ليل تشيلي» (ترجمة عبد السلام باشا) و «تعويذة» (ترجمة أحمد حسان)، عن «دار التنوير».
ولد بولانيو في «سانتياغو» العام 1953 وتوفي في «برشلونة» (اسبانيا) العام 2003. وهو شاعر وروائي، من والد عمل سائقا (بعد أن كان ملاكما) ومن أم عملت في مهنة التدريس.
كان أحد أبرز المساندين للرئيس الليندي، وقد تم اعتقاله بعد الانقلاب الذي قام به الجنرال بينوشيه، إلا أنه استطاع الهرب من سجنه بفضل حارسين، إذ كانا من أصدقائه في المدرسة.
في «حلبة الجليد» ـ التي يكتبها على شكل مقاطع، هي عبارة عن أصوات ثلاثة أشخاص ـ يتحدث الكاتب عن مدينة تدعى (Z )، وهي مدينة سياحية على شاطئ كاتالونيا، حيث نستمع إلى أقاصيصهم المتفرقة التي تدور حول السياسة والحب والشعر والكتابة.
رواية تنبع من ذلك الشريان الكتابي الكبير الذي عرفناه في أدب أميركا اللاتينية، والتي تخبرنا أن تلك القارة تملك العديد من الكتّاب المميزين، بعيدا عن الأسماء الشهيرة التي توقفنا عندها.
هنا الفصلان الأولان من الكتاب..
رِمو موران:
رأيته لأوّل مرّةِ في شارع بوكارٍلي
رأيته لأوّل مرّةٍ في شارع بوكارِلي، في مِكسيكو، أي في المراهقة، في المنطقة المغبَّشة والمقلقلة التي تنتمي إلى شعراء الحديد، في ليلة مشحونة بالضباب الذي كان يُجبر السيارات على أن تسير ببطء وتجعل المارّةَ مستعدين لأن يُعلّقوا بسرور غريب، على الظاهرة الضبابيّة، غير المعهودة في تلك الليالي المكسيكية، على الأقل إلى الحدّ الذي أتذكّره. قبل أن يُقدّموه لي أمام باب مقهى هافانا، سمعتُ صوته، عميقاً، كما لو أنّه من قطيفة، الشيء الوحيد الذي لم يتغيّر مع مرور السنين. قال: هي ليلة على قدّ جاك. كان يُشيرُ إلى جاك نازع الأحشاء، لكن صوته جاء مُذكِّراً بأراضٍ خارج القانون ، حيث كلّ شيءٍ مُمكن.
كنّا جميعاً مراهقين، مراهقين أشراراً، هذا صحيح، وشعراء، وكنّا نضحكُ. كان المجهول يُدعى غاسبّار هِرِديا، غاسبّارين بالنسبة للأصدقاء والأعداء الجائرين. ما زلتُ أتذكّر الضبابَ تحت الأبواب الدوّارة والكلام الملغز يروح ويغدو. لا تكاد تُلمح الوجوه والأنوار، والناس الملفوفون بذلك الشال يبدون أقوياء وجهلة، مُجزَّئين وأبرياء، كما كنّا حقيقةً. نحن الآن على بعد آلاف الكيلومترات عن مقهى هافانا والضبابُ مصنوع على قدِّ جاك نازع الأحشاء، وهو أكثر كثافة مما كان وقت ذاك. من شارع بوكارِلي، في مكسيكو إلى القاتل!، سيفكّرون… الغاية من هذه الحكاية هي إقناعهم بعكس ذلك…
غاسبّار هِرِديا:
وصلتُ إلى ثٍتا أواسط الربيع
وصلت إلى ثِتا أواسط الربيع، في ليلة من شهر أيّار، قادماً من برشلونة. بالكاد كان معي شيء من نقود، لكنّني لم أكن قلقاً ذلك أن عملاً كان ينتظرني في ثِتا. رِمو موران، الذي لم أره منذ سنوات طويلة، لكّني دائماً كنت أملك أخباراً عنه، باستثناء ذلك الزمن الذي لم يُعرف فيه عنه شيء، عرض عليّ من خلال صديقة مشترَكة عملاً موسميّاً من أيّار وحتى أيلول. عليَّ أن أُوَضِّحَ أنّني لم أطلب العمل، وأنّني لم أحاول إذ ذاك ولا قبله أن أتواصل معه. ولم أنوِ قط أن آتي لأعيشَ في ثِتا. صحيح أنّنا كنّا أصدقاء، لكنَّ هذا كان منذ زمن بعيد وأنا لستُ مِمَّن يطلبون إحساناً. عشتُ حتى ذلك الوقت في طابق مشترك مع ثلاثة أشخاص، في الحيّ الصيني، ولم تكن أموري تسير بشكل سيّئ تماماً كما يمكن أن يُتَصوّر. وضعي القانوني في إسبانيا، باستثناء الأشهر الأولى، كان، كي أقوله بطريقة ناعمة، محبطاً: ليس عندي إقامة، ليس عندي ترخيص بالعمل، أعيشُ في نوع من المطهر الغامض بانتظار الحصول على المال الكافي لأفرد جناحيّ أو أدفع لِمُحامٍ، كي يُسوّي أوراقي. طبعاً كان ذلك اليوم يوماً طوباوياً، على الأقل بالنسبة للأجانب، من أمثالي، الذين يملكون قليلاً أو لا يملكون شيئاً. على كلّ الأحوال لم يكن وضعي سيّئاً. بقيتُ زمناً طويلاً أمارس أعمالاً موقّتة، بدءاً من القيام على محلّ في لا رامبلا وحتى خياطة حقائب جلدية بآلة سينجر مُفكّكة لمعمل قرصان، وهكذا كنتُ آكل، أذهبُ إلى السينما وأدفع أجرة غرفتي.
تعرّفت ذات يومٍ على مونيكا، وهي تشيلية كان عندها بسطة في لا رامبلا، وبالحديث تبين أن كلينا، في مراحل مختلفة من حياتنا، أنا قبلها بعام وهي في أوروبا بطريقة أكثر نظامية، كنّا صديقين لرِمو موران. منها عرفت أنّه كان يعيش في ثِتا (كنتُ أعرفُ أنّه كان يعيش في إسبانيا، لكن لم أكن أعرف أين) وأنّه لم يكن ليغفر لي وأنا في وضعي ألاّ أذهب لزيارته أو ألاّ أهتف له. كي أطلب مساعدته! طبعاً، لم أفعل شيئاً: فالهوّة بيني وبين رِمو كانت تبدو لي غير قابلة للردم، كما أنّها لم تكن مسألة إزعاج. وهكذا بقيت أعيشُ أو أعاني شظفَ العيش، بحسب الحالة، إلى أن حكت لي مونيكا أنّها رأت ذاتَ يومٍ رِمو في أحدِ بارات برشلونة وأنّه قال، بعد أن شرحت له وضعي، إنّ عليّ أن أذهب فوراً إلى ثِتا فهناك أستطيع أن أعيشَ وأعمل على الأقل خلال موسم الصيف. موران يتذكّرني! الحقيقة، عليّ أن أعترف، لم يكن عندي شيء أفضل، والأفق كان أسود حتى تلك اللحظة، كان أسود مثل برميل نفط. ثمّ إنّ الاقتراح أثّر بي. لا شيء كان يربطني ببرشلونة، فقد خرجت توّاً من أسوأ زكام في حياتي (وصلت إلى ثِتا وأنا ما أزالُ محموماً) مجرّد فكرة أن أعيش خمسة أشهر متتابعة بجانب البحر كانت تجعلني أبتسم مثل أبله، لم يكن عليّ غير أن آخذ قطارَ الساحل وأرحل. من القول إلى الفعل: وضعتُ كتبي وثيابي في حقيبة الظهر وانطلقتُ بأسرع ما استطعت. كل ما لم تتسع له الحقيبة أهديته. عندما تركت محطّة فرنسا ورائي فكّرت أنّني لن أعود لأعيش في برشلونة أبداً. تركتها خلفي بعيداً عنّي!. بلا ألم ولا مرارة! بالقرب من ماتارو بدأتُ أنسى كلَّ الوجوه… لكن هذا طبعاً مجرّد كلام، فلا شيء يُنسى…
(السفير)