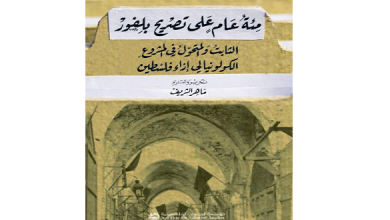«أعتاب» محمد قراطاس مناضل يفر من الثورة إلى التصوّف

محمد العباس
في مستهل روايته «الأعتاب» الصادرة حديثاً عن دار الساقي يثبّت محمد قراطاس (عتبة/جُملة) نصّية محقونة بالدلالات القابلة للتأويل «عاد مساءً خلع ثيابه وأفرغ من جيبه ثورة»، فهذه العبارة المنحوتة بوعي تختزن استراتيجية ومغازي النص، فهي بمثابة الجملة الرحمية التي سيتناسل منها النص، بل هي الرواية ذاتها مضغوطة في جُملة، لأنها تختصر سيرة الشاب الاشتراكي الثائر مستهيل العفّار من الثورة إلى التوبة عنها، حيث تخلى عن نضاله وعضويته في الجبهة الشعبية لتحرير عُمان والخليج، وسلّم نفسه إلى الحكومة التي قاتلها لأربع سنوات، ليستقر في الجامع لأيام، إلى أن أقنعته أُمّه بالرجوع إلى البيت ليعود «مواطناً بسيطاً يسكن مع والدته وأخيه الصغير في بيتهم الطيني على الساحل».
لا أحد يعلم لماذا قرر مستهيل العفّار التوبة عن الثورة بهذه البساطة وهو القيادي الذي أراد تحرير الإنسان والبلاد من قيد الأديان والحكومات الاستعمارية والرجعية، وهو السؤال الذي ظل منزرعاً في سياق الرواية إلى ما قبل خاتمتها، أو هكذا أراده محمد قراطاس ليُبقي على التشويق، إلى أن تفصح النهاية عن حادثة مروّعة على المستوى الإنساني، جعلته يعيد التفكير في التجاوزات التي نفذها الرفاق في أفراد الشعب بتهمة العمالة، وبالتحديد عندما أعدم الرفاق العم محمد صديق والده في وادي «دربات» بالتهمة ذاتها، حيث وقف «على مسرح شهد انقلاباً إنسانياً بكل اقتدار، وجدت كل فكرة آمنت بها وكل إنسانية حاولت الإنتصار لها تسيل على تلك الصخرة»، ويقصد بها الصخرة التي يبس عليها دم العم محمد.
تلك هي اللحظة الدرامية التي دفعته للتخلي عن الرفاق والتوبة عن الثورات التي يشبهها بـ»الشمعة التي تتجاهل فيها العين كل شيء حولها»، حيث يدخل في مناجاة مونولوجية تؤكد خياره الشخصي بمقتضى مشاهداته وقناعاته «وضعت يدي على الصخرة وعلى دم العم محمد، جلست وبكيت طويلاً، ولم أعلم كم لبثت، ثم وضعت بندقيتي على الصخرة، تخليت عنها وهي التي طالما قاتلت بها لأجل العم محمد ولأجل أمثاله من البسطاء واتجهت إلى المدينة ولم أنظر خلفي»، ولئلا يُفهم أن تلك الحادثة مجرد عارض يمكن تجاوزه، وأن روحه ما زالت ممهورة بسحرية الثورة، أجهز محمد قراطاس على ما تبقى من مساحة للتخفيف من وطأة الإدانة للثورة والثوار ليعلن موقفه الصريح منها «كان ما زال لديّ يقين بأن الثورات أعظم من أن نفهم الحكمة من ورائها، وإنني أقل من أن أعارض فكراً عظيماً كالثورة، كما أنها كانت تضم بعض الرفاق الشرفاء الذين أثق بهم».
إذن، لم تكن عبارة «عاد مساءً خلع ثيابه وأفرغ من جيبه ثورة» مجرد عبارة تشويقية، بل هي الخلية المفسّرة لمرادات النص، على مستوى المضمون تحديداً، بمعنى أن محمد قراطاس يحاول في «أعتابه» تقديم رواية مضادة أو مجاورة على الأقل لرومانسية مروية ثورة ظفار، من منظور تفكيكي لخواء الثورة من داخلها مقابل بريقها الشكلاني، وذلك من خلال عرض الصورة البطولية المظهرية لمستهيل العفّار، باعتباره أداة المساءلة والمدخل لوعيها «كان شاباً وسيماً معتدل القامة أسمر يتدلى شعره المموج على كتفه مضيفاً إليه منظراً ثورياً خالصاً»، حتى انضمامه إلى الثورة كان بسبب سخرية أطفال الحارة منه بأن والده «جديحة بحر» أي الذي لا أصل له «ولذلك كان هذا أحد أهم الدوافع الرئيسية لينضم إلى صفوف الثورة، فهناك تسقط الأنساب ويضمحل التفاخر إلا بالرفاق والمعارك».
الاستهلال البارع للرواية والخاتمة الصادمة لا تقابلهما معالجة منطقية لسيرورة التحول في سيرة مستهيل العفّار، فالبداية فيها تطواف شاعري أخاذ في الفضاءات الحاضنة لشخصيات الرواية «كل شيء في ظفار يمثل مناضلاً يقاتل مع الثوار»، لدرجة أن مستهيل عندما يمر ببحيرة دربات يحييها «سلام ثوري أيتها الأبية»، كذلك النهاية جاءت جارحة، خصوصاً لحظة استدعاء إعدام الشيخ المُسن العم محمد، حيث ردّد الشباب «تحيا الثورة» فيما كان مستهيل يستعيد المشهد بجمالية جارحة «كان الشاب يبتسم ابتسامة لم أر أكثر سذاجة منها في حياتي، فهذا الطفل لا يدرك حجم الكارثة التي اقترفها، وكان ينظر إلى الفتاة التي كانت ترمقه بنظرات إعجاب غبية إلى حد القرف»، وما بين المدخل القابل للتأويل والنهاية المفتوحة على احتمالات إنسانية واسعة، لا شيء سوى التجوال في العالم بمقتضى حوادث مدّبرة خالية من أي توتر درامي.
هذا إذا قوربت «الأعتاب» كحكاية، أما إذا قُرئت الطبقات الدلالالية الراسبة في عمق النص، فستظهر النزعة الصوفية، وإن لم تبلغ مرحلة الشطح، وربما يفسر هذا كثرة «العتبات/الأعتاب» في النص، التي تشكل مداخل ما وراء «النص/الباب»، كما يفسر ذلك منحاها الشعري، إذ من المعروف أن النزعة الصوفية تجد محلها في الشعر أكثر من السرد، وعلى هذا الأساس يدبر محمد قراطاس رحلة معراجية تطهرية لبطله تشغل الحيز الأكبر من الرواية يلتقي فيها بمختلف صنوف البشر والمذاهب والأديان والاعتقادات، من منطلق اختلاق سيناريوهات استيهامية صوفية النزعة، حيث يحاول التواصل مع والده الميت علي أبو بكر التويجاني، عبر تقنية المنامات، إلى أن يسمع صوته وهو يرشده إلى سر التقوى «أربعين يوماً وليلة من الذكر والاستغفار والتعبد كفيلة بتطهير الإنسان من الذنوب الظاهرة، والصدقة يعبر بها إلى دائرة الرحمة».
وبالفعل ينفذ تلك الوصفة ويرفع من جرعة الورد وقراءة القرآن والصلاة «وكلما مر يوم تزداد روحه خفة ورشاقة بشكل لم يشعر به من قبل، فقد كان كل شيء واضحاً أمام عينيه بشكل عجيب، كان اسم الله يترك تأثيراً عجيباً على قلبه حتى لو سمعه عرضاً في حديث يومي»، وهكذا تحول الشخص الذي كان يعادي الدين باعتباره الأفيون عابداً، بل صاحب كرامات، تنطبع كرامته على كل من يصادفه، كما صار بمقدوره اختراق الزمن والتواصل مع أسلافه، وهكذا تمكن مستهيل من «زيارة الأحباب»، وكأنه يعود إلى أرضه وناسه، حيث يلتقي بجده المتشح «بعمامة خضراء كلون العشب في الخريف»، وبمجرد أن يقبّله يشم «رائحة كسهول المراعي بعد المطر»، فيوصيه بالسفر بدون دليل «كن الهائم في أرض الله وتحت سمائه».
كل ذلك التهوام اللامنطقي كان يتراكم بشكل حشوي من المصادفات المدبرة، أي بافتعال خطابي وليس بمقتضى أدبية الاختلاق، حيث يعبر محطات متباعدة «مقديشو، ميناء فوس الفرنسي، بواتييه، السويس، طنجة، دارفور، الخرطوم، الفاشر»، كما يلتقي بشخصيات متخالفة تمثل طبقات الوعي الديني للوجود: البدوي حمدان الذي لا يعرف أن السلطان قابوس تقلد الحكم في البلاد، الحاج باقر وابنه حسين، العم إسحق اليهودي، القبطان بيتر، رضوان الفرنسي من أصل تونسي، سي ميلود الكردي، القسيس، مسيو ميشيل، كريشنا الهندي، الراعي عبدالرزاق، الشيخ عثمان الذي يصفه بالمصحف الذي يمشي وهكذا، بمعنى أن عذابات الفقد والنفي والانفصام الروحي والوجع الجسدي إنما أرادها تجربة شخصية للاستنارة، عبر سردية صوفية حاول فيها المزج بين الترحال الواقعي والارتداد العمودي داخل ذاته إلا أنه بقدر ما راكم من المصادفات الواقعية بقدر ما كان يفرّغ شخصية مستهيل العفّار من خزينها الروحي ومقوماتها الروائية.
رواية «الأعتاب» كُتبت على ما يبدو بمنطق الهزيمة، لا بموجب المساءلة العقلانية للثورة والغوصات التأملية الواعية في الذات، وهذا هو الفاصل الذي تتولد فيه الاشتغالات والانهمامات بالرواية الصوفية، حيث الخلاص الفردي تحت وطأة الهزائم السياسية واضطراب بوصلة الحركة الاجتماعية التاريخية، هذا من الناحية الموضوعية، أما من الوجهة الفنية فيشكل النبع الصوفي مغترفاً للشعرية، ومصدراً لتوليد الشعر والالتصاق به، وهو منحى يبدو على درجة من الوضوح كمقصد، سواء في لغة الرواية أو في استهلالات الفصول المزدحمة بخطفات شعرية منحوتة بعناية بالغة مثل «الحكايات التي لا ترى الشمس تتعثر في الفم»، و»عليك السلام أيها المسجى في الطين»، وكذلك، بحر العرب ذلك الحكيم الذي سقط من السماء» وهكذا، حيث يتأكد ذلك المنزع في بُنى الرواية اللسانية ومعجمها، وكذلك في فائض الترميز والتكثيف والتناص، ولو في حدودها الانبساطية، حيث يتلبّس مستهيل العفّار أحياناً المعراجية الجغرافية للسيد الخضر، وتارة يدخل في طقس المنامات اليوسفية بعبارات قرآنية محوّرة لتبرير ما يؤديه من افتعالات لتخليق الزمن الصوفي لروايته والتحرّر من اشتراطات الزمن التاريخي، أي الفضاء الذي يسمح له بقول أي شيء، على طريقة التوحيدي في إجازة آثار النفس في المنام وإجازتها في حالة اليقظة، كما يتيح لنفسه اللهج بالحكمة الصوفية.
النص الروائي رؤية أدبية وموضوعية وهذا ما يُفترض أن تُقارب بموجبه «الأعتاب»، حيث يمكن مساءلة السارد المتصوّف مستهيل العفّار بمقتضى معراجيته الأفقية الأرضية، وبموجب موقفه من الثورة المستدعاة كمحطة انطلاق لذلك الترحال المضاد، إذ يتضح أن الهاجس الصوفي، أو متعة الحكي الصوفي التي تم توظيفها بشكل ارتدادي ما هي إلا محاولة لدحض فكرة الثورة وخلخلة بُناها، فالرفيق عامر البدّار أعدمه الرفاق بسبب خيانته، وهذا أحد المشاهد التي أصابته بالانفصام والارتباك، والمفارقة أن إشراقات اللغة الصوفية لا تتجلى عندما يتحدث عن رحلته المعراجية، أو عن التوق لتعداد مآثر وكرامات بطله، بل حين يستدعي الثورة والثوار، حين يصف موت المناضل سيف الزاكي وهو يتمتم في لحظاته الأخيرة بعد أن قرأ فاصلاً من القرآن «كم أشتاق إلى شرب ماء الفلج صباحاً، أشتاق كثيراً إلى رائحة الحناء على كفّ أمي يا مستهيل، ثم دخل في نوبة أنين وبكاء، بعدها انهدم جسده إلى الأم»، وكأنه بذلك السرد الملحمي اللاواعي لسيرة الثوار يؤكد على قصديته الموضوعية المعاندة لجاذبية الثورة، وهو منحى يتأكد في عبارته الدالّة «مستهيل رغم رحيله عن الثورة فإنها لم ترحل عن روحه»، أو عندما يتأمل سيرورة الثورة بمعزل عن تلك القصدية بعبارات استدراكية قليلة جداً مقارنة بالاستطراد في مدارات التصوف «الثورة يا حسين نظرية سحرية تستهوي كل شاب يسعى للعدالة، لكنها حين تطول تتضخم وتتوسع وتتداخل مع الطموحات فتنتشر حمى تجعل الموت مبهجاً والسلام كآبة مخيفة».(القدس العربي)