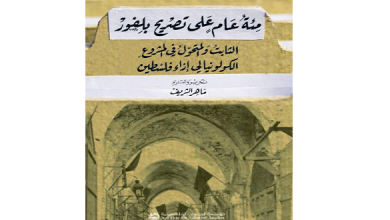التشظي والوعي بالكتابة في «قبل أن تستيقظ طنجة» لنسيمة الراوي

محمد الديهاجي
ثمة في الكتابة الشعرية النسوية الراهنة في المغرب، رهانات جمالية تجاوزت شعريات المعيار وسلطتها، مبتكرة بذلك العديد من الأعراف الجمالية الجديدة. وهي بذلك، وضعت مفهوم الكتابة في المهب، وفي مفترق انشقاقاته، أو بتعبير صلاح بوسريف، اختارت «المتاهة، بدل الطرق التي تنتهي بحاجز، أو بسواتر تمنع الاستمرار في المشي، وقطع المسافات الطويلة». (صلاح بوسريف ـ «القدس العربي» 2 يونيو/حزيران 2015).
والحق أننا أصبحنا نلاحظ، وسط هذا التدافع الشعري، بين الفينة والأخرى، تجارب شعرية نسوية بامتياز. تجارب مائزة بتطلعاتها، إذ لا تني تثق البتة في المعطى والناجز، بقدر ما تسعى جاهدة لجعل الكتابة تنزاح عن موقعها، وتقترح علينا، بالمقابل، «تجريب الحركة في مساحات أخرى» (زهور كرام «القدس العربي» 30 يونيو2015).
تفريع الطريق يبدأ من التمرد على عمارة النص، خطية كانت أم رأسية. وهو اختيار جمالي ازدانت به الإضمامة الرائقة والشائقة للشاعرة المغربية الواعدة نسيمة الراوي، والموسومة بـ «قبل أن تستيقظ طنجة». لم يكن، في طموح هذه الشاعرة سوى كتابة نص يشبهها. أقصد نصا متشظيا بسمت ثيماته البسيطة التي لم تكن، إلى حدود الأمس القريب، تندرج ضمن المدونة الثيماتية للقصيدة، وليس الشعر؛ لأن الشعر، وأجدني هنا مقيدا بأطروحة صلاح بوسريف،» كثرة وليس جمعا». ولعل من ضمن ملامح شعرية التشظي هاته، هو احتفاء الشاعرة بالقصيدة الشذرة، مع شعرنتها للأشياء البسيطة، وأنسنتها، ثم إيمانها المطلق بجمالية البورتريه، سواء تعلق الأمر بالإنسان أو المكان؛ وهذه ميزة جديدة انمازت بها هذه الأضمومة، حيث إن الشاعرة ما فتئت تصمم بورتريهات لبعض الأشخاص والأمكنة التي أدهشتها وأثرت فيها، فقامت بأنسنتها على نحو يسهل معه توصيفها: طنجة، ريو دي جانيرو، أصيلة.. منير بولعيش، لوركا، الغجرية، شكري…
والواقع أن الشاعرة نسيمة الراوي، في اختيارها لقصيدة النثر، ليست من أولئك الذين يستنجدون أو بالأحرى يستجدون «بركات الهبات» الجمالية لهذا المقترح الشعري، تيمنا بحداثة مزعومة، بل إنها اختارت بوعي كبير قصيدة النثر، انطلاقا من إيمانها الراسخ بالإمكانات الإيقاعية التي يمنحها هذا الشكل الشعري الجديد، على اعتبار أن الإيقاع، كدال، هو أكبر من الوزن وباقي الدوال الإيقاعية الأخرى (ميشونيك)، من جهة، ومن جهة أخرى انطلاقا من قناعتها الراسخة بمدى مناسبة هذا المقترح الشعري لبوحها الهامس، ولرغبتها الملحة في كينونة محتملة. كينونة تعفيها من رهق الزمن المعدم، ومن ربقة ذاكرة عصية. تقول الشاعرة:
يلفظ البحر
كلمته الأخيرة
ويرحل…
خلف نافذتي
فراغات كثيرة
وهذا الأزرق المتبدد في
لا يرحل..
وتقول أيضا:
على أرصفة القلب تكبر
في ذاكرة ترشح ملحا وشعرا
وجراحا تمتد على طول المحيط.
والمتأمل لنصوص هذه الإضمامة الماتعة، سيكتشف بسرعة، أن الكتابة عند صاحبتها، تحدثُ بوعي وهمس نسوي جريح، ما يبرّر التشققات والفجوات الحاصلة في لغة الديوان، وفي الوميض الذي تُحدثه – الكتابة – في دجى المعنى إذا يغشى، فتجعله يتجلى ويتبدى بسرعة فائقة. وهذه سمة من السمات البارزة لتجربة ما يمكن تسميته بـ(ما بعد القصيدة). يقول صلاح بوسريف عن هذا الأمر «المعنى في هذا السياق الشعري لا ينتفي، أو يتم محوه، بل يستجيب إلى دلالة بما تعنيه الدلالة، في التصور النظري الحديث، من تعدد وانشراح» (الكتابي والشفاهي).
الشعر، بهذا المعنى، أقصد معنى الشاعرة نسيمة الراوي، هو تجاوز ذاتي ومستمر للغة، تجاوز ذاتي «للمعنى المدرك، كأنه المعنى نفسه» (جان لوك نانسي). من هذا المنعطف تحديدا، جاء التشظي والتشتت في المعنى بسبب التوتر الحاصل في العلاقة بين الدال والمدلول، بين المعنى ومعنى المعنى (المعنى المضاعف بتعبير ريكور)، في تضاعيف هذه المجموعة الشعرية. سيقابل هذا الاختيار الجمالي، اختيار آخر على المستوى الطباعي للنصوص، حجما وتوزيعا. فالشاعرة تنتصر بشكل كبير للإيجاز والاقتصاد في القول، بوعي مكين بهذا الشرط، مع تجنبها ما أمكن، للنفس الطويل في الكتابة باعتباره سمة كتابية ذكورية بامتياز. ولعل المتأمل لهذه النصوص، في مكنته أن يلحظ ذلك؛ ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يكون مرد ذلك للضعف أو الفقر الإبداعيين عند الشاعرة، وإنما مرده بالأساس إلى إيمانها بأن التعبير عن اللحظات الهاربة في الحياة، التي كثيرا ما نغفلها، لا يمكن أن يتحقق إلا بالبوح الهامس:
1- كلما أوجعتني الحياة،
أذبت قرص الشمس
في كوب البحر..
2- الغيمات حمامات مصلوبة
على سقف السماء
المطر نزغها
والبحر لا يتوقف
عن الغناء..
إن جل نصوص الديوان، حتى إن طال حجم بعضها، تنهض على ما يمكن نعته بشعرية التشذير والوميض، مما يعطي للنص توهجه ولمعانه، حتى إن كان المعنى في ليله. فالشاعرة، وهي تراهن على اللغة في مستواها الهامس، تضع نفسها في مواجهة لغتها، فتتحول النصوص، جراء ذلك، إلى ضرب من اللعب المرآوي للتشظي كمدونة ممزقة ومشتتة، فتصبح الأشياء، وفق هذه الترسيمة، في مواجهة نفسها:
الغياب…………….الحضور
المدينة…………………البحر
الذاكرة………………..الواقع
الألم………………….الفرح
ومن الأشياء المحركة لماء الكتابة، عند نسيمة الراوي، بين دفتي هذا الديوان، نلفي شعرية البحر، بحضورها اللافت. فليس من شك أن للبحر ذاكرة، هي أقوى من ذاكرة الإنسان نفسه؛ لذلك فهو لا ينسى أبدا:
على أرصفة القلب تكبر
في ذاكرة ترشح ملحا وشعرا
وجراحا تمتد على طول المحيط.
إن البحر بالنسبة للشاعرة عالم غامض. فهو تارة حلم شاعل، وتارة ثانية موت، وتارة ثالثة عاشق. مفارقة يصعب فهمها أو حتى القبول بها. ومع ذلك للبحر متسع في قلوب العشاق:
1- تحت البحر مقابر جماعية
لمدن اغتالها البحر…
فوق البحر مقابر جماعية
لغجرية واحدة
يغتالها البحر..
2- البحر قصر
يشرع أبوابه
للعشاق..
ولأنهم كثر
خلعها..
ذاكرة البحر، ها هنا، متيمة بالشاعرة، أو بالأحرى بحضورها العيني، مثلما أن حضور الماضي/ الذكرى، بالنسبة لنسيمة لا تتحقق إلا في حضرة البحر، وفي غفلة من السيدة المدينة/ طنجة:
ماء يتسلق الماء
هو الموج ينحدر دفعة واحدة
لأنه يعلم أني على الشاطئ
أنتظر الكابوتشينو.
هي إذن لعبة الحضور والغياب، التذكر والنسيان. حضور المعنى المُفتقد في طنجة أقصد، وغيابه في الوقت نفسه. والحضور هذا لا يتحقق إلا بالتذكر المرتهن بالبحر، وبزمن ما قبل الاستيقاظ تحديدا. أما النسيان فهو منذور للوقت كله، أي لما بعد الاستيقاظ:
بقدمين بيضاوين يتزلج البحر على الرمل
بلا قدمين يسبح الرمل في البحر
وأنا عند الشرفة، أعبئ ذاكرتي.
نقرأ كذلك:
فراشات صغيرة تعبر،
نهر من الشعر ينحدر من ذاكرة تتثاءب
عند الشرفة في قميص نوم أزرق
الهدير موسيقى داخلية، المد حضور،
الجزر غياب، الزبد بياض بين السطر والسطر.
إن الشاعرة وهي تتأرجح بين أرجوحة الحضور والغياب، بين المد والجزر، تستنجد بالذاكرة لترميم ماض تحول إلى مجرد ذكرى متشظية، من خلال استيلادها، من اللاشيء، كينونة مفترضة، وذلك بمساءلتها لأمكنة أليفة، بتعبير غاستون باشلار، دون أي طمع في أجوبة قد تعصف بحلمها؛ فالجواب قبر السؤال، ومن ثم فإن المساءلة ها هنا، ما هي إلا خطوة نحو ترميم ذاكرة/ حلم مصابة بالوخز الإبري. تقول:
من أي بحر تصب
أيها المتموج
في أغنيات الرمل للريح؟
من أي أرض منبسطة
تتدفق إلى حلمي؟
من أي ضوء تأتيني
محترق الفراشات؟
ليس من شك، أن المساءلة في هذا المقام، ما هي إلا مكاشفة إشكالية لأشياء وتفاصيل بسيطة. ولعمري هذا تجل من تجليات فكر ما بعد الحداثة، وإن بشكل مبطن: الحضور والغياب – التذكر والنسيان – المكان الأليف. إن ثنائية الحضور والغياب هي بشكل ما «سيمولاكر» عند فوكو، من حيث « إنه – السيمولاكر- يتجلى ويتوارى في آن». وعالم السيمولاكر هذا، يحكمه « العود الأبدي» النتشوي مما يقوي الخلفية ما بعد حداثية في الديوان: دريدا، فوكو، نيتشه، هايدغر، باشلار.
قد تكون الشاعرة واعية بهذا المكر المعرفي الخفي، وقد لا تكون؛ إلا أنني أجدها، وهذا هو الأهم، مشبعة جدا بهذه الروح الفلسفية، ما جعل فعل الكتابة، عندها، يرقي إلى ما يسميه بعضهم بـ «الكتابة بالمعرفة». ولئن كان فعل الكتابة، من بين ما يضطلع به، هو أن يجعلنا نغير النظر إلى الأشياء والعالم، وأن نعيد ترتيب الأمور فيتغير «معنى وجودنا، ونتغير تبعا لتغير المعـــنى» (زهور كرام- المقال السابق)، فإن الشاعرة نسيمة الراوي، من خلال اختياراتها الجمالية، في هذه المجموعة، ما فتئت تشعرن الأشياء والتفاصيل والأمكنة المُفتقدة لمعانيها في العلاقة مع الإنسان، بسبب وحشيته التي جعلت هذه العلاقة تبرد وتتلاشى، حتى أصبحنا نعيش ما سماه بول ريكور ذات مرة بـ»غياب المعنى».
وجماع القول إن الإمكانات الجمالية (البنائية والثيماتية) الكـــثيرة، التي فجــــرتها الشاعرة مـــن خلال هذه التجربة، وازدانت بها نصــــوص الديوان، قد منحت القائــــلة والقارئ معا، فرصــة الانتباه إلى ما فات أو ضاع منا داخــــل عالم تستحكم فيه الأفكار الثابتة وأفقية المنظور.
(القدس العربي)