فاطمة قنديل تصطاد اللحظات الهاربة
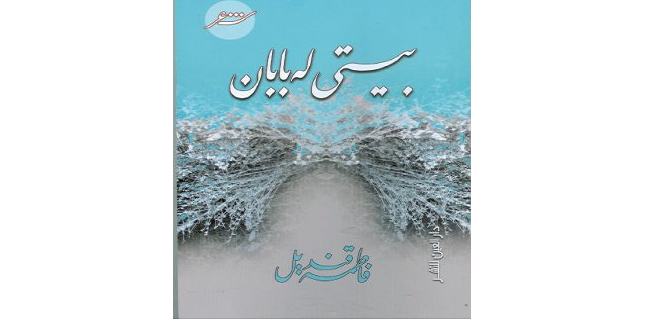
محمد السيد اسماعيل
فاطمة قنديل– الباحثة والشاعرة– صاحبة صوت متميز في حركة قصيدة النثر المصرية بخصائصها الدالة عليها من قبيل اعتيادية اللغة – وهو وصف لا يناقض الشعرية بالضرورة – والبعد عن المجازات القديمة بعلاقتها الموروثة ومقاربة التفاصيل الصغيرة واصطياد اللحظات الهاربة. وتعد «الذات» محوراً رئيساً في ديوانها «بيتي له بابان» (دار العين) ليس على سبيل الإفضاء بمشاعرها بل بغرض تأمل هذه المشاعر والحالات المتباينة.
وبطبيعة الحال فإن هذه الذات لا تعيش في معزل عن العالم وعن الآخرين وإن كانت دالة الوحدة من الدوال المتكررة في الديوان. والمكان، البيت، يعد مجازاً مرسلاً دالاً على صاحبه، لهذا يأتي عنواناً للديوان ويتم توظيفه في القصيدة الأولى من خلال الوصف التفصيلي لمدخله فحسب: «بيتي له بابان: باب الحديقة الخارجي/ الذي لا ينغلق ويحتاج إلى أن أصلحه/ وباب البيت الداخلي/ الهش الجميل/ الذي يمكن أن تكسره بضربة قدم». هذا وصف محايد، مجرد توصيف جغرافي للمكان أشبه باللقطة السينمائية المكبرة مِن بعيد. فليس هناك انعكاس لمشاعر الذات باستثناء صفتي «الهش الجميل» اللتين تخلعهما على «باب البيت الداخلي»، وهما صفتان سيكون لهما– مع غيرهما– تأثير في تطور الحدث في القصيدة التي تتخذ– شأن الكثير من القصائد– شكل البنية السردية، سواء تبدت في ما يحدث حقيقة أو في ما تتوهمه الذات حين تقول: «شيء ما يقول لي/ أن شخصاً ما سيعبر الباب الخارجي متلفتاً حوله/ وقبل أن يدفع الباب الداخلي بقدميه/ ستقع عيناه– رغماً عنه – على النباتات البرية التي اشتد عودها/ خمسة أمتار تكفي كي يفكر/ خمسة أمتار ستجعله يغلق باب الحديقة الخارجي بإحكام بعد أن يخرج/ وربما يفاجئوني بإصلاحه يوماً ما» (ص10). ما بين الباب الخارجي المطل على العالم والباب الداخلي الأقرب إلى الذات خمسة أمتار فقط بنباتاتها البرية.
هذه الأمتار الخمسة سوف تلعب دوراً كبيرا فى تحويل طبيعة هذا الشخص الغريب – الذي جاء غالباً لغرض السرقة – تتحول إلى النقيض حين يتراجع عن اقتحام البيت ويقوم بإغلاق الباب الخارجي بإحكام. إن الشاعرة تراهن على الجمال حتى ولو بدا بسيطاً – مجرد نباتات برية – تبدو شبيهة بقصائد النثر البسيطة العفوية المتخففة من القيود والتي تصطاد الجمال في تفاصيله العابرة. فعلُ الكتابة – إذاً– ليس مجانياً، فهو تآلف مع العالم ومع من نحب تحديداً. هكذا يبدو إحساس الشاعرة أثناء ممارستها هذا الفعل، كما يبدو من قولها: «ويكون ثمة من يتأبط ذراعي/ حين أبدأ في الكتابة/ وأشعر أحياناً أنني/ أود أن أكتب/ لا لشيء/ إلا لأحرر ذراعي من ذراعه وأحتضنه/ أو لأدفعه بعيداً عني/ هي محض لحظة أستغرق فيها/ في الكلمات/ وأفيق فلا أجد أحداً» (ص48). الكتابة تستهدف التحرر والتآلف الطوعي أو وضع مسافة بين الذات والآخر بغرض تأمله.
ربما الكتابة حلم بكل هذا وبمجرد انتهائها تحدث اليقظة/ الإفاقة، فلا تجد الذات أحداً. وفي المقطع التالي ترتبط الكتابة بالقسوة، فهي فعلُ مجاهدة وصبر على الإخلاص لها. ويبدو ذلك حين تصفها الشاعرة بأنها زوجة أبيها: «الكتابة زوجة أبي/ ماتت أمي ومات أبي/ وبقيت الكتابة/ وأنا أخدمها وأمسح ما يساقط من فمها» (ص49). ولا يهمنا في هذه الصورة آلية التشخيص، بمقدار ما يهمنا المعنى الكامن في تصوير الكتابة بامرأة عجوز. فالكتابة– أيضاً- تشيخ وتنتظر من يخلص في خدمتها، على رغم قسوتها.
تتوازى موضوعة «الحب» مع موضوعة «الكتابة»، إذ يرتبط– أيضاً- بالألم والقسوة، تقول: «الحب عسيرٌ يا صديقي/ الحب مؤلم وعسير/ لا يشبه أبداً خفة عينيك المغمضتين/ ورأسك يغوص في كتفي» (ص80). هذا الألم في الكتابة والحب يستدعي دالة الموت، سواء أكان موتاً حقيقياً أم موتاً للخيال؛ تقول: «لن يكتب الشاعر سوى ما كتب/ تمهلوا قليلاً بعد أن تدفنوه/ وضعوا آذانكم على قبره/ ستسمعون صوت معوله في الأعماق/ وهو يحفر بكل ما أوتي من قوة/ حفرة أعمق ليدفن فيها خياله» صـ 41. وكأن موت الشاعر لا يكتمل إلا بموت خياله، أو لنقل إن موت الخيال هو الموت الحقيقي للشاعر. وفي قصيدة «بعيداً عن أعين الناس»، تتماهى الشاعرة مع نصها الإبداعي حين تقول: «أنا آخر نص سأكتبه/ لا تنشغلوا بتفاهات النعوش والقبور والجنائز/ سيتساقط مني ما يكفي من الرمل/ لأدفن نفسي بنفسي» (ص33).
الموت كامنٌ في الإنسان الذي سوف يصبح جسده نفسه قبراً له بعد أن يتحول إلى رمال يدفن نفسه فيها. من هنا جاءت محبة الظلام في مقابل الضوء الذي يكشفها حين تقول: «كان جميلاً أن يكون الظلام دامساً/ كان جميلاً أن نتلامس كعميان/ دون أن يشطرنا الضوء ظلالاً/ على الجدران» (ص71). وامتداداً لهذا، يتحول الصباح في رؤيتها إلى محض ضوء يمكن أن تمسك به ليضيء لها الردهة: «ككشاف نور لا أكثر»، والمسألة ليست ضرباً للإيهام بمقدار ما هي رؤية جديدة للعالم لم تعد تحتفي بالمعاني الكبرى، بل تحتفي بالتفاصيل الصغيرة الحميمة والتآلف مع حالات الفقد والوحدة، تقول: «أنا وأنت رضعنا حليب الوحدة الدافئ/ لذا نتشاجر كل صباح/ أي منا ينام على صدر الآخر» (ص73).
تحولات المعاني هذه تجعل من الحياة أشبه بالمسرحية التي تتقاطع فيها مصائر الشخصيات في علاقات معقدة: «أن تحب امرأةٌ رجلاً يحب امرأة أخرى/ أن يحـــب رجلٌ امرأة تحب رجلاً آخر/ أن أكون أنا نفسي/ من ممثلي هذه المسرحية/ فلا يعني ذلك أبداً/ أنني لم استمتع بالممثلين/ وهم يرتجفون في الكواليس/ خلف الســــتارة/ قبل بدء العرض» (ص63). واللافت أن الشاعرة تتـــعامل مع حياتها كما لو كانت شيئاً منفصلاً عنها: «ومنذ سنوات وأنا أحيا على هامش حياتي/ آه/ حياتي أنا/ تلك البناية التي/ لم تر فيَّ أكثر من حارس لها» (ص51). وفي حياة كهذه تشيع دوال الخواء والألم الذي تسعى لاصطياده وتأمله بعد أن تقيده وتجلسه أمامها: «وعلى فمه شريط لاصق» (ص95).
لم تعد الشاعرة فريسة الألم بل أصبح هو إحدى فرائسها، وامتداداً لهذا التمرد على الألم والتغلب عليه نجدها في قصيدة أخرى تنظر إلى الماضي الذي ترمز إليه بالتماثيل بإهمال على نحو يذكرنا بفتاة ابسن في «بيت الدمية»: «غرفة مملوءة بالتماثيل/ أغلق الباب القديم بعنف/ ولا تكنس ما استقر فيها من غبار» (ص75). فاطمة قنديل، صوتٌ شعري متميز لم تغيبه أبحاثها الأكاديمية اللافتة، لأنه أكثر أصالة وأكثر تصويراً لذاتها وأحوالها المتعددة.
(الحياة)




