من الفلسفة والأدب إلى الميديا!
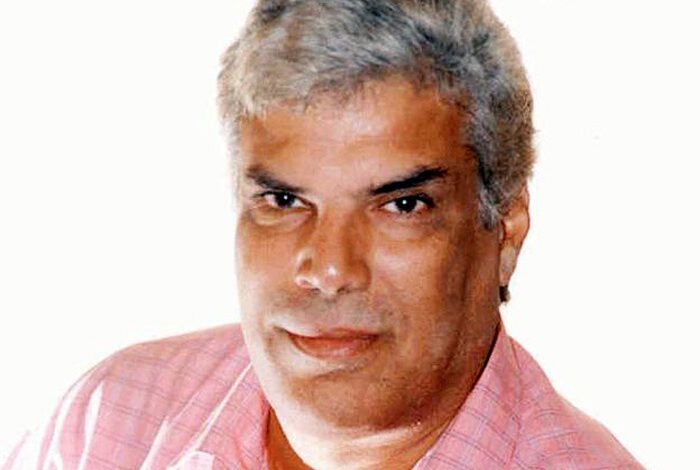
- اعتذار للمتنبي - 2024-04-11
- أوديب في الطائرة - 2024-03-14
- حوارات صحفية ولكن.. - 2024-02-24
تتحول الحياة في الفضاء الافتراضي إلى مقولات وحكم وأمثال. يحدث خلط عند بعض من ينشرون ذلك فيجعلونه على لسان كاتب الرواية أو المسرحية، بينما هو من مقولات الشخصيات المختلفة في ظروفها الخاصة في العمل الأدبي. حتى الشعراء لم ينجوا من ذلك، فلقد صار شائعًا أن تجد على لسان شاعر ما لم يقله. كثيرًا ما تعثرت بذلك فأرى كلمات لا تتسق لا مع لغة محمود درويش ولا صوره الشعرية لكنها تُنسب إليه، والأمر نفسه مع صلاح جاهين على سبيل المثال. أما نجيب محفوظ فهو أكثر روائي وجدت على لسانه مقتطفات أعرف أنها كانت لشخصيات رواياته وقليل جدًا من سرده هو. أما الفلاسفة والسياسيون القدامى فحدث ولا حرج عما يُنقل عنهم وهو ليس منهم. حين أنظر إلى هذا الفيض من المقولات، وخاصة على موقع مثل تويتر يخايلني سؤال، هل يتحقق مردودها مثلا؟ أعرف أنه يوجد معجبون بها، لكن لا أظن أنهم يعيشونها أو يحققونها. أجد حديثًا مذهلًا من أعداد غفيرة عن الحب وصفات الحبيب والزوج الحسن وكيف تكون، وغير ذلك من أحاديث عن الغدر وغيره في قصص الحب وفي الحياة الزوجية. أندهش من هذه الأفكار النهائية التي قد تكون بنت تجارب خاصة لكنها لا تحكم حياة البشر كلها. ما أكثر قصص الحب التي فشلت، وتمر الأيام وكل حبيب يجد ملاذًا في آخر. حتى الطلاق وهو أمر بشع، قد يكون حلا جيدا لحياة سيئة، ولا يشعر أي من الزوجين بأي حزن بعده. حالات نادرة جدًا لا تصل إلى واحد بالألف من الذين انكسرت نفوسهم في قصص الحب فلم يعودوا إليها وزهدوا العالم. وربما هي عند النساء واحد في المليون لأن المرأة في النهاية في بلادنا مرغمة أن تعيش في مجتمع لايراها مكتملة إلا بالزواج والخلفة. أما إذا انتقلت إلى الفيسبوك فأرى كل الناس عليه أبرياء يعرفون كل الحقائق ولا يفعلون إلا الصواب، ويتردد سؤالي الذي سألته إحدى شخصيات روايتي “في كل أسبوع يوم جمعة” كل الناس أبرياء على الميديا فمن الذي يصنع الشر في هذا العالم؟ لكن هذا ليس ابن عصرنا والميديا فقط. كل ما جرى هو أن الميديا جعلته متاحًا في ثوان، ولا تحتاج لبحث عنه فهو أمامك وبأرخص الأسعار. هذا هو دأب البشرية منذ نشأتها ومنذ عرفت طريق الكتابة. كل المدارس الفلسفية كانت محاولات لفهم العالم وتقديم رؤية نهائية له. تركها أصحابها خلفهم زادا لنا أو معينا إذا أحببت. أنا مثلا حين تدلهم الأمور السياسية والاجتماعية حولي أجد نفسي عائدًا إلى زينون الإيلي، وهو أحد الفلاسفة السبعة ما قبل سقراط، وأتوقف عند برهانه عن عدم وجود الحركة الذي هو شكليًا منطقي جدًا، لكنه عمليًا طبعًا لا يحدث فالحركة موجودة. يقول إنك إذا أطلقت السهم فلكي يصل إلى هدفه فعليه أن يقطع نصف المسافة، ولكي يقطع نصف المسافة عليه أن يقطع نصف نصف المسافة، ولكي يفعل ذلك عليه أن يقطع نصف نصف نصف المسافة، وهكذا فلكل نصف نصفا ومن ثم لا يتحرك من مكانه. ألوذ بزينون لأرتاح من مظاهر الفشل أو اليأس أمامي. كما ألوذ بالوجودية التي ترى الحياة شيئا نحن مجبرون عليه، فلا أحد استشارنا في الميلاد، ولا أحد يستشيرنا في الموت، وبين الميلاد والموت فالآخرون هو الجحيم. أجل. أنت في الحياة يجب أن تكون أو تعمل كما يريد الآخرون وأولهم حبيبتك فلا تقابلها مثلا إلا نظيفا معطرا، ولا تذهب إلى عملك إلا بما يليق، ولا تحضر سهرة إلا بالزي المناسب، ولا أحد يعطيك فرصة المشي عاريًا في الطرقات. أجمل حرية هي أن تخلع كل ما وضعته فوقك الحياة، وحبذا لو أُصبت بالخرس فلا تتكلم مع أحد، أو بالطرش فلا تسمع.
كثير من الفلاسفة جعلوا سوء الفهم قاعدة للحياة التي تمتلئ بالضجيج. الوجودية جعلت سوء الفهم علامة على الحياة وصاغها ألبير كامي في مسرحية بعنوان “سوء تفاهم” مثلا. وعندما كتب عن الديكتاتور كاليجولا جعله يريد أن يأتي بالقمر في يده. بحث فاشل مقدما عن المستحيل. طبعا يمكن أن تضم إلى زينون الإيلي الكلبيين أو الشكاكين وغيرهم، بينما على الناحية الأخرى تجد المثاليين الذي يرون للعالم معنى، ولصراع الأفكار أساسا في التقدم مثل هيجل، وتستطيع أن تمشي لتجد الماديين الذين جعلوا صراع الأضداد ليس في الأفكار بل في المصالح، وطبعا كارل ماركس علامة، وتستطيع أن تضيف علماء النفس باتجاهاتهم المختلفة وهكذا. إذا ابتعدت عن الفلسفة ونظرت في أعمال الأدباء الكبار فستجدها مَعبَرا للفلسفة أيضًا ومحاولة للخروج من شكل الحياة حول الكاتب.هذه المحاولة لم تكن منذ البداية، ففي البداية كان الأدب صورة أخرى للفكر السائد، لكنها صارت بعد ذلك تمردًا وتقدمًا وصناعة لعالم آخر. حتى في مرحلة واحدة مثل الأدب اليوناني القديم ترى يوريبيدس تمرد على كلاسيكية سوفوكليس وخرج عن الملامح الثابتة للمكان والزمان والحدث. وفي بدايات العصر الحديث هناك من عاد لسوفوكليس مثل راسين، ومن تمرد أكثر مثل فيكتور هوجو والرومانتيكيين ومَن بعدهم. الخلاصة وجد الأدباء في الأدب ملاذا للحرية.. الحرية في الكتابة هي أجمل ممارسة للحرية المفتقدة في الحياة حتى وصلت مراحل كبرى فيما نسميه بالعجائبية التي طلت علينا من أمريكا الجنوبية منبع الديكتاتوريات!. سبقتها طبعا ألف ليلة وليلة فلم تكن مُنتجا لبلاد ديموقراطية من فضلك. هذه الحرية لن تكلف صاحبها الانضمام لحزب سري ولا عمل سياسي، وربما كان هذا مصدر غِيرة بعض الحكام في التاريخ من هؤلاء الأحرار –رغم أنها حرية على الورق- ورغم أنهم لايتكلمون في السياسة، فسجنوهم وقتلوهم. كل هؤلاء الأدباء والفلاسفة عبر التاريخ حاولوا إقامة بيوت أخرى غير ما نراها. الأدباء جسدوها لك ترى فيها سكانها من شخصيات العمل الأدبي. بيوت واسعة أكبر من الفضاء حولك. لكن ما إن تنتهي حتى تجد البيت الذي تعيش فيه ضيقا. لا أقصد مساحته أو عدد الغرف. لكن أقصد المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي لا يبدو أن هناك حلًا دائمًا لها، وهنا تجد نفسك مادمت مثقفًا عائدًا إلى الفلسفة كي تفهم، والكارثة تتضاعف حين تفهم، وتتضاعف أكثر حين تدرك أنه لن يستمع إليك أحد. الآن صار الملاذ بالفضاء الافتراضي مريحًا إلى حد كبير، وحين تجد عليه المقولات الكلية المعنى، صحيحة أو غير صحيحة في الإسناد، ترتاح إليها كما يرتاح غيرك، ويظل كل شيء على حاله. المدهش أن أجمل الأصوات في الفلسفة والأدب هي التي لا ترى لهذا العالم معنى. وكما قلت كان زينون والشكاكون وغيرهم قبل الوجودية، وكان في عالمنا العربي وفي العصر الجاهلي طرفة بن العبد في معلقته حين قال:”لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوتَ مَا أَخْطَأَ الفَتَـى… لَكَالطِّـوَلِ المُرْخَى وثِنْيَاهُ بِاليَـد”. فالموت قادم لا محالة والحياة خدعة مهما طالت وهناك من يمسك بأطرافها لا تراه.
جاء أبو العلاء المعري بعد الإسلام قبل الوجوديين، ولا أظن أنه قرأ زينون الإيلي أو كانت تمت ترجمة أفكاره لأنه لم يترك كتبًا، كما تمت ترجمة أرسطو مثلًا إلى العربية. لقد سبق المتنبي المعري لمثل هذه الرؤى الوجودية لكنها عند المتنبي متفرقة لا تمثل منهجًا “يموت راعي الضأن في جهله.. ميتة جالينوس في طبه” هي عند المعري منهجا ورؤية في كثير من قصائده:
“نزول كما زال آباؤنا… ويبقى الزمان على ما ترى” “نهار يضيء وليل يجيء.. ونجم يغور ونجم يُرى” أو قصيدته الأشهر “تعب كلها الحياة” غيرُ مجدٍ في ملّتي واعتقادي نوح باكٍ ولا ترنم شادِ * وشبيهٌ صوت النعيّ إذا قِيـس بصوت البشير في كلّ ناد * أبَكَت تلكم الحمامة أم غـنّت على فرْعِ غُصنها الميّاد إلى آخر القصيدة.
قرأت عن ذلك مبكرًا جدًا لبعض المفكرين وكنت في الخامسة عشرة من عمري ومشى معي المعنى والإحساس. ورغم الإعجاب الرهيب بالمعري لم تتوقف الحياة. ورغم ما فعله حكام في أدباء وفلاسفة وصوفيين مسلمين من سجن وقتل وذبح لم تتوقف الحياة. في الفيلم العظيم 451 فهرنهايت الذي أخرجه فرانسوا تروفو عام 1966 عن رواية الأمريكي راد براد بري، فالدولة التي أحرقت الكتب استطاع سكانها الهروب إلى الغابات ويحفظون الكتب يقرأونها على بعضهم. الكتب من أجمل مظاهر الحياة لأنها إما تحاول تفسيرها، أو تبني لك قصورًا أفضل منها، ترتاح فيها قليلًا كأنها صلاة! لقد أحرق هتلر ملايين الكتب قبل أن يحرق ملايين اليهود، وتعلم منه الصهاينة ماهو أبشع. أي حرق الناس والبيوت. الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين هو سياسة الأرض المحروقة التي تمشي عليها الصهيونية فتفوقوا على هتلر. مافعله هتلر لم يُنس بينما الصهاينة يتصورون أن ما يفعلونه سيشمله النسيان.
سؤال استمرار الحياة رغم بشاعتها هو سؤال البشرية الغائب. يعلنه الشعراء تشاؤمًا أحيانًا، فرعب أكثر من هذا سوف يجيء، كما قال صلاح عبد الصبور أو وتفاؤلًا أحيانًا فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة كما قال محمود درويش، ويبدو لك بالفعل أن الحياة لا تتوقف حتى إن لم تستطع أن تمشي باسمك إلى أجدادك القدماء. حتى لو توقفت عندالجد الثالث أو الرابع أو حتى الخامس. جوار الفلسفة والأدب طبعًا تأتي بقية الفنون، فكلها تحتفي بالحياة وهي التي جعلت للجميل من الماضي وجودًا أكثر مما جعلت الكتب، التي تتسع أو يمكن أن تتسع فيها مساحة الحديث عن الشر والأشرار أيضًا. وقبل أن يعرف الشاب الطريق إلى المتاحف ليرى الآثار أو معارض الفنون يسمع الموسيقى والغناء. راضيا أو مرغما فهي حوله في كل مكان، وكلها أيضًا تبني قصورًا في الهواء. حتى أغنيات الحب الضائع تدفع إلى الحب ولا تجعله مكروهًا، فالشفقة لا تتجاوز المُغنِّي، وهذايؤكد لك أن قدرة الإنسان على صناعة الحياة لا تتوقف، وهذا هو اللغز. أتذكر تجربتي مع القراءة وكيف أحببت في سن مبكر جدا، الخامسة عشرة قصائد وأبيات شعر للمعري كلها لا ترى للحياة معنى، بل ودونتها في مفكرة كما يحدث التدوين الآن على الميديا. ورغم ذلك كافحت وتعلمت وانتميت لجماعات سياسية وتفرغت أكثر للأدب وواصلت الكتابة وأجد ما أكتب عنه، وأشعر أن الحياة أقل من الفرصة التي تعطيها، أو ستعطيها لي للكتابة عما أريد ولا أبتئس، ولديّ مثل غيري آلامي الخاصة، لكني أتجاوزها بمجرد دخولي إلى الفضاء العام. لا يفارقني المعنى أن الآخرين هم الجحيم لكني لا أبتعد عنهم. إذا كانت عادة فلقد سلبتني، وإذا كانت حب استطلاع فلا يضايقني غير الكذابين. كيف عرفت أنهم كذابون؟ لقد أوقعتني أو أوقعتهم الظروف في طريقي. لم يعودوا في طريقي مرة أخرى لكن أعادتهم الميديا، وإن صار من السهل أن أغمض عيني أو «أطنش» كما يُقال، فقط أتكلف “كليك” لأنتقل إلى صفحة أخرى. أشعر أني تكلّفت الكثير. ثم أضحك. لا أتهم أحدا بالمنفعة أو الشللية أو حتى الجهل وما إلى ذلك مما أسمعه حولي، فهو أمر لم أقف عنده كثيرًا، فحين صنفونا بين الستينيات والسبعينيات كنا في كل ما سُمى بجيل واحد، ستة أو سبعة في المقدمة، ومن ثم كان يمكن تجاوز أيّ مكيدة. لذت دائما بتعريف سعيد الكفراوي أن هذا تصنيف لمرضى البلهارسيا. يرحمك الله ياسعيد مازلت حين أبحث عن رقم أحد في الموبايل أجد رقمك ولن أحذفه حتى نلتقي. الأمر نفسه مع شاكر عبدالحميد ومع الفنان مصطفى عبد الوهاب وكثيرين يغادروننا كل يوم. أجد هذا الفراق المتكرر تتغلب عليه مقولة البقاء لله وحده، وهذا هو حال الدنيا، فهي تمضي إلى الأمام، وأجد أنه لا سبيل لمفارقة الحزن على موت الأحباء غير أن يموتوا في غيابي! أجد نفسي أعود إلى السؤال الأول كيف وكل هذه الفلسفات عن الألم يظل العالم يمضي إلى الأمام. كيف وكل هذه البيوت الجميلة التي أقامها الأدباء وشوهها الواقع والنظم السياسية يظل العالم يمضي إلى الأمام. كيف وعبر خمسين سنة وكل مانسمعه من رجال الدين يجعل الآخرة أولى من الدنيا حتى صارت الدنيا حولنا عشوائيات في البناء والمظهر والسلوك، يظل العالم يمضي إلى الأمام. باختصار الحياة تمضي رغم كل الآلام، أضيف إليها الميديا التي تقذف بالمقولات الصحيحية المصدر أو الكاذبة على صفحاتها، وتظل المقولات التي تبدو إنسانية جدًا رغم أنك لا تعرف إلى الأخيار أو الأشرار ينتمي من ينشرها، لكن في نشرها راحة للمحارب، أو أيضًا وهذا هو الأهم، راحة للكسلان، والأهم راحة للشرير الذي أراه يكذب على صفحات الميديا وسوء حظي أني عرفته يومًا. لكني أنظر إلى عمري وألوذ بالراحة التي تعطيها لي الكتابة. حتى حبسة الكورونا والمرض جعلتها فسحة جميلة في رواية جديدة وفي مثل هذه المقالات، ولست إلا مثالًا على إرادة الإنسان الذي يرى كل شيء إلى زوال!.
المصدر: مجلة أخبار الأدب




