عندما يكون الجسر هوية وهاوية وسوار فضَّة!
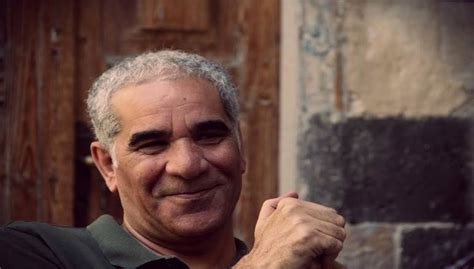
- أحوال الكائن الخائف - 2023-12-07
- عندما يكون الجسر هوية وهاوية وسوار فضَّة! - 2022-11-17
- أنا ونادية لطفي في مقهى الآشوري - 2022-04-18
كان على الحسين بن منصور الحلّاج (858- 922) أن ينتهي مصلوبًا على جسر بغداد، بعد أن قُطعت يداه ورجلاه وضُربت عنقه وحُرقت جثته، الرأس فقط ذلك المحشو بالأفكار المضادة للنصّ الرسمي، سيُعلّق على الجسر كي يكون درسًا بليغًا ومنهجيًّا للآخرين، أولئك الذين سيعبرون الجسر كل يوم، ولا أحد يعلم ماذا يدور في رؤوسهم الشيطانية! لا نعلم رقم الجسر الذي احتضن رأس الحلّاج، فقد كان العراقيون يؤمنون بأن بناء الجسر السابع على نهر دجلة سيشهد ظهور المهدي المنتظر! مشهد سيتكرّر فوق جسورٍ أخرى، منذ ألف ومئة عام، كلما أرادت سلطة استبدادية تظهير صورة جديدة للطغيان، وإثارة الفزع في رؤوس الرعية.
كان أول ما قام به لورانس العرب، لحظة اشتعال الثورة العربية الكبرى، تحطيم الجسور التي تربط خط الحديد الحجازي ما بين دمشق ويافا والمدينة المنورة
الحلّاج نفسه سيحيلنا إلى جسرٍ آخر بإحالات لا نهائية بقوله “النقطة أصل كل خط، والخط كلّه نقط مجتمعة، فلا غنى للخط عن النقطة، ولا للنقطة عن الخط، وكل خط مستقيم أو منحرف هو متحرك عن النقطة بعينها، وكلّ ما يقع عليه بصر أحد فهو نقطة بين نقطتين”.

بين نقطتين تنهض جسور/ خطوط، من الاحتمالات، كان أول ما قام به لورانس العرب، لحظة اشتعال الثورة العربية الكبرى، تحطيم الجسور التي تربط خط الحديد الحجازي ما بين دمشق ويافا والمدينة المنورة، تنفيذًا لبنود اتفاقية سايكس بيكو في تقسيم وتمزيق خرائط بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية، وسوف يحطّم البرابرة جسر دير الزور المعلّق على الفرات، التحفة المعمارية التي صمّمها المهندس الفرنسي مسيو فيفو في العام 1931، بقصد ربط ضفتي الفرات للمساعدة في عبور قوات الانتداب الفرنسية نحو قرى الريف لمواجهة أحداث الشغب ضد الاحتلال. نُحر الجسر المعلق علنًا، بقذائف المدفعية والصواريخ والعبوات الناسفة، وبهمجية القصف، والقصف المضاد، في أيار 2013، طاويًا ذاكرة مثقلة بالحنين والحسرة والألم، الجسر الذي اختزن جثث عشرات العمال داخل أعمدته الخرسانية أثناء تشييده، لفظ الأجساد ثانيةً في مشهد جنائزي أخير للمدينة، ربما كي يتطهّر الموتى بماء الفرات ثانيةً، على نحوٍ يليق بأنبياء مجهولين، وكان آخر مشهد أليف لجسر الرقة على الفرات قبل تفجيره، منظر عبد السلام العجيلي في نزهاته اليومية نحو الجسر العتيق، يتأمل حركة ماء الفرات التي لطالما ألهمته في كتابة رواياته وقصصه “حين أكون في الرقّة، هناك مكانان إنْ لم أزرهما يوميًّا، لا أعتبر أنّني عشت يومًا طبيعيًّا: هما مكتبة بورسعيد وجسر الرقّة القديم” يقول. غاب أيقونة الرقة، وهُدم الجسر، وأُغلقت المكتبة بأمر من تنظيم الدولة الإسلامية بعد استيلائه على المدينة. من شرفةٍ أخرى يطل ابن رشد كجسر متين بين لغتين، الجسر الذي عبره منفيًّا نحو مراكش، ثم هجرته المعاكسة نحو قرطبة ليتحوّل اسمه إلى “أفيروس” بوصفه فيلسوفًا لاتينيًّا لا عربيًّا، فقد حاربه فقهاء قرطبة بتهمة الإلحاد، لكن هبوب ريح أخرى أعاده إلى جذوره الأندلسية، ولكن بعد موته محمولًا على دابة رفقة ما تبقى من مخطوطاته، وكأن عبور جثمانه من مضيق جبل طارق إلى الأندلس لدفنه في قرطبة، هو تعبير صريح عن “فضاء العبور والانفصال”، ألم يحذّره ابن طفيل في لقائهما الأول في قرطبة “خذ حذرك يا ابن رشد، إنك تميل أحيانًا إلى بسط براهين قد أصفها بالمثيرة للشبهة، الفلسفة تؤدي إلى الإلحاد”. وقبل أن يودّعه، سيضيف “لا يجب أن يكون الجسر أوسع من النهر، لو أردت أن يظل رأسك مقيمًا على عنقك، تعلّم ضبط نفسك”. وبعد موت ابن رشد بمئة عام سيقذف به دانتي في كتابه “الكوميديا الإلهية” نحو البرزخ الذي يفصل بين الجنّة والنار.

كان اكتشاف رواية “جسر على نهر درينا” للروائي اليوغسلافي إيفو أندريتش بمحض مصادفة لا تتكرّر مرتين بالشغف نفسه، وكان الجسر نحو هذه الرواية العظيمة مكتبة عسكرية مهملة بالكاد تجد من يقلّب فهارس رفوفها. كنت حينها ملازمًا مجنّدًا باختصاص ميكانيك دبابات، الاختصاص الذي لا أفقه شيئًا من مفرداته، وحين اكتشف مدير الكلية العسكرية بأنني درست التاريخ لا الهندسة الميكانيكية في الجامعة، كلّفني بتدريس مادة التاريخ العسكري في الكليّة، فكان عليّ أن أبحث عن مراجع تخصّ المعارك الكبرى مثل اليرموك وحطين وذي قار والحرب العالمية الأولى، في مكتبة الكليّة وجدت هذه الرواية التي كانت علاجًا ناجعًا في مقاومة الضجر في المناوبات الليلية.
في روايته “حين تركنا الجسر” يجسد عبد الرحمن منيف معنى هزيمة حرب 67، ذلك أن عدم عبور الجسر يؤكد الخسارة والفقدان وعدم الأمل
ما إن بدأت قراءة السطور الأولى من الرواية حتى نسيت خرائط معركة حطين وبطولات صلاح الدين الأيوبي، والسيوف المسلولة في مواجهة الأعداء، فههنا حيوات ومصائر وأحاسيس بشر، كان الجسر الذي أمر ببنائه الصدر الأعظم محمد باشا سوكولوفيتش، قبل نحو أربعة قرون، وصمم أعمدته المهندس المعماري سنان الدين يوسف، يمور بالحركة ودراما العيش، ليصبح بفضل هذه الرواية أشهر معالم بلاد البلقان، الجسر الذي شهد حروبًا وصراعات وفيضانات وخلافات، هنا بوسنيون وصرب وأتراك ويهود، وخلافات عرقية ودينية، وعذابات عمّال أجبروا على العمل الشاق في بناء الجسر فحاولوا تدميره، وعقوبات للمتمردين بوضعهم على الخازوق، لكنه من ضفةٍ أخرى كان نقطة وصل بين الشرق والغرب، وممرًا لجيوش الغزاة. شخصيات بالجملة تظهر وتتوارى تدريجيًّا، فيما يبقى الجسر شاهدًا أبديًّا على الخرائط المتحوّلة، ووثيقة تاريخية عن الجغرافيا المضطربة، وحكايات بشر في ظلّ جسر حجري يكاد أن ينطق بدواخل شخصياته، ثم سيختزل إيفو أندريتش هذا المناخ الملحمي بقوله “إن الحياة معجزة لا تُفهم، فهي ما تنفك في تبدد وذوبان، ولكنها تبقى وتستمر قويةً كالجسر على نهر درينا”. من جهته يروي إسماعيل كادريه في روايته “الجسر” وقائع بناء جسر على نهر أويان في ألبانيا القرن الرابع عشر بسرد متوتر يمزج التاريخ بالأسطورة، والصراع بين السلطة والمال، والانتقال من زمن العبّارات والأطواف إلى زمن الجسور على خلفية حكايات أسطورية عن مراحل بناء هذا الجسر الذي روي بالدم مرتين، إذ تُدفن امرأة ثم رجل في جسم الجسر قربانًا لاستكمال تشييده من دون أن ينهار، وعلى المقلب الآخر يفضح إسماعيل كادريه بعنف رأسمالية الشركات والصراع بينها على الربح.

وفي روايته “حين تركنا الجسر” يجسد عبد الرحمن منيف معنى هزيمة حرب 67، ذلك أن عدم عبور الجسر يؤكد الخسارة والفقدان وعدم الأمل، فقرار الانسحاب من المعركة بالنسبة لبطل الرواية زكي النداوي هو عبء لا يحتمل سيثقل على الجميع، وهو أثناء ذهابه إلى الصيد رفقة كلبه وردان سيسترجع سيرة مثقلة باليأس عن العبور والانسحاب، مانحًا الجسر قيمة كبرى بوصفه هوية وهاوية بآنٍ معًا “إن للجسور أرواحًا، والجسور التي لا يعبرها البشر لا يمكن أن تكون أمينة أبدًا، يمكن أن تنهار، يمكن أن تجرفها السيول، وقد تصاب كما تصاب الحيوانات بالأمراض”، و”كان من الواجب أن نموت جميعًا برصاصات في ظهورنا؛ لأننا لم نعطهم سوى الظهور، تركنا الجسر وحيدًا، وكان بصدره يواجه كل شيء”. في هذا المقام ستحضر قصيدة خليل حاوي من موقعٍ مضاد “يعبرون الجسر في الصبح خفافا/ أضلعي امتدت لهم جسرًا وطيد/ من كهوف الشرق، من مستنقع الشرق إلى الشرق الجديد/ أضلعي امتدت لهم جسرًا وطيد”. لكن الجسر في مرآة أخرى، هو “جسر التنهدات”، وهيجان العاطفة، وجماليات المكان، كما يراه سعدي يوسف “لجسرُ يشهقُ لامِعًا مثلَ سِــوارٍ فضّـةٍ اســتقامَ في يدِ السـاحرةِ، الجسرُ ألقى شِباكَه على الجبل”، وسوف يشرّح الطاهر وطار في روايته “الزلزال” فضاء مدينة قسنطينة من خلال جسورها السبعة، بوصفها حاملًا متينًا للحكاية وتناوب فصول الزلزال وارتداداته، وصولًا إلى انطفاء الحلم.
مجلة «الجسرة الثقافية» – العدد (61)




